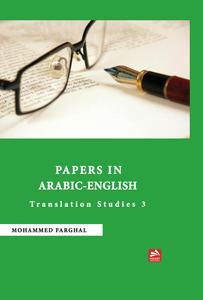
Papers in Arabic/English Translation Studies 3
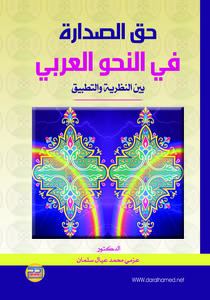
حق الصدارة في النحو العربي
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ألفاظ الصَّدارة في اللغة العربية، ومعرفة مدى التوافق في صدارتها بين التنظير النحوي والأداء الاستعمالي، وقد استخدمت المنهج الوصفي أداة للبحث والتحليل، وجاءت في أربعة فصول، تناول الفصل الأول: بناء الجملة العربية من حيث ترتيب أجزائها. وتناول الفصل الثاني: الأسماء التي لها الصَّدارة. وتناول الفصل الثالث: الأفعال التي لها الصَّدارة. وتناول الفصل الرابع: الحروف التي لها الصَّدارة.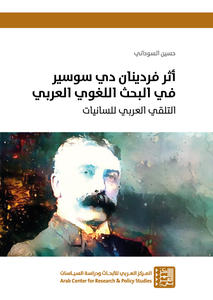
أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي
صدر عن سلسلة "دراسات معجمية ولسانية" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب حسين السوداني أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي - التلقي العربي للسانيات، ويدرس فيه مؤلفه أثر دي سوسير في البحث اللغوي العربي من منطلق أنّ دروسه في اللسانيات بمنزلة كتاب سيبويه في النحو العربي. وأتاح هذا الخيار المنهجي دراسة التلقّي في كليته انطلاقًا من فحص مجهريّ لكيفيات تمثل دقائقه، فزاوج البحث بين مستويين من الاستقراء؛ جعل الأوّل للإلمام بالملابسات التي هيّأت لاطّلاع الدارسين العرب على النظريات والأفكار، وجعل الثاني للتَّفحّص الداخلي لأوْجُه تمثُّل الدارسين للنظريات وسياقات توظيفهم لها وكيفيات عرْضهم لأسسها. يتألف الكتاب (344 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من تقديم بقلم عبد السلام المسدّي، ومقدمة وسبعة فصول وخاتمة عامة. دي سوسير بعد مئة عام أراد المؤلف أن يكون الفصل الأول، "دروس فردينان دي سوسير بعد مئة عام"، تأطيريًا، فجعله لرسم خريطة زمنية لما بعد ظهور سوسير، وفق تصور تأليفي لحصيلة قرن من الدراسات اللسانية بعد ظهور دروس سوسير، متناولًا فردينان دي سوسير متعلّمًا في قرن الدراسات التطوّرية، ومدرّسًا وباحثًا، ومنتقلًا من الجامعة إلى العالم، وأثره في البحث اللغوي. ويرى السوداني أن سوسير "وإن لم يكن اللغوي الوحيد الأوحد الذي اهتدى في زمانه إلى ما ورد في دروسه من مفاهيم، فإنه استطاع أن يجعل قبل غيره، من هذه المعاني والأفكار، نظامًا فخمًا دقيقًا منسجم الأطراف بعيد الغور، فأبدى سوسير في كل ذلك قدرة على توضيح المفاهيم الغامضة وتركيب المعاني المنفصلة المتباعدة والتوفيق بين النظريات المتنافية". نشوئية المعرفة اللغوية واكتشاف سوسير في الفصل الثاني، "من نشوئية المعرفة اللغوية العربية المعاصرة إلى اكتشاف فردينان دي سوسير"، ينظر السوداني في الملابسات التي مهدت لاندراج آراء سوسير في البحوث اللغوية العربية، باحثًا من خلال اللحظات السابقة لاكتشاف سوسير عن سبب تأخر الاهتمام بآرائه. يجد المؤلف أن معطيات عديدة تضافرت لتؤخر اطّلاع العرب على آراء سوسير؛ تتمثل في المشرق في التبعية إلى ما ساد في البحث اللغوي في الجامعة الألمانية، "أما في المغرب العربي فإن واقع الاستعمار أرجأ اكتشاف سوسير إلى حين تأسيس الجامعة بعد الاستقلال. ولم تُعلن البحوث اللغوية العربية مرجعية سوسيرية صريحة إلّا خلال العقد الخامس من القرن العشرين، رغم أنّ الاطّلاع على الاتجاهات اللسانية الحديثة تمّ مبكرًا في الشرق خاصة. وجرى هذا الاندراج في البحث اللغوي لمّا انفتحت الجامعة المصرية على وسط جامعي آخر غير القطب الألماني، وكان ذلك لما عادت البعثة الأولى ممّن درسوا علوم اللغة في جامعة لندن". وصفية البحوث اللغوية العربية المعاصرة خصص السوداني الفصل الثالث، "الوصفية في البحوث اللغوية العربية المعاصرة"، لاستقراء ملابسات تبلور مقاربات وصفية عربية ناشئة بخلفية لسانية حديثة أو ناجمة عن تخلقات منهجية ذاتية. يقول المؤلف إن تأسيس موقع صريح لسوسير ضمن البحوث اللغوية العربية إنما تحقق فعليًّا لمّا عاد من تتلمذوا في مدارس أوروبية، ولم يكن هؤلاء متفرغين في كل الحالات للبحث اللغوي، وإنما راوحت اهتمامات بعضهم بين علم الاجتماع والنقد الأدبي. ويرى المؤلف أنّ حضور سوسير تنامى لمّا ترجمت كتب ومقالات لسانية تدين له بمرجعيتها، "لكن هذه الوساطة التي تجسدت في الترجمة أو التتلمذ كانت لها تبعتان: الأولى أنه احْتُفِيَ من آراء سوسير بسياقات مخصوصة هي ما تَقْتَضِيه وجهة نظر الباحث، ونموذج ذلك هو علي عبد الواحد وافي. وأما التبعة الثانية فتمس الجانب الزماني من انفتاح اللغويين العرب على اللسانيات المعاصرة، والوساطة، وإن يسّرت عملية الاطّلاع على المعرفة، تكشف عن تأخّر الاتصال بها، كما أن هذه الوساطة تقيم من التبعية المعرفية سياجًا لا يمرّر من العلم إلا ما يسمح به الوسيط أو ما اطّلع عليه". من سوسير إلى المبحث الأسلوبي في الفصل الرابع، "من اكتشاف فردينان دي سوسير إلى نشأة المبحث الأسلوبي"، يبحث المؤلف في المعطيات التي هيأت لتحقيق وعي عميق بالمقومات النظرية للسانيات السوسيرية خلال أواخر ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. ففي خلال هذين العقدين، تضافرت معطيات عدة لخلق نقلة نوعية في وعي اللغويين العرب باللسانيات السوسيرية. أبرز هذه المعطيات انخراط المغرب العربي في البحث اللساني، واطّلاع اللغويين في المشرق على اللسانيات الأنكلوسكسونية؛ إذ "اجتمعت ملابسات عدة جعلت اللغويين في المغرب أوفر اطّلاعًا على آراء سوسير، وأعمق تبصّرًا بها، كما أن اطّلاع اللغويين في المشرق على اللغويات الأنكلوسكسونية أحالهم بكيفيات مختلفة على السيرورة التي تنتظم بحوث اللغة؛ فانبرى بعضهم يعقد المقارنات بين المقومات النظرية للسانيات سوسير والمنطلقات التأسيسية للتيارات اللسانية اللاحقة". ويقول السوداني: "نستجلي أثر المحاورة في التأسيس للوعي المعرفي العميق باللسانيات السوسيرية كما نسجل أثر المعطيات الاجتماعية الثقافية في توفير قنوات هجرة المعرفة. لكن يظل للنظرية السوسيرية، فوق أثر المحاورة والمعطى الاجتماعي الثقافي، ثراء معرفي هو ما أدى إلى زواجها بحقول معرفية مجاورة؛ فكان من نسل ذلك نشأة مباحث كالأسلوبية التي، وإن تشربت آراء سوسير واستثمرتها، فقد كانت ذات دور مهمّ في تقديم اللسانيات السوسيرية على نحو متسق هو ما لا يستنتجه المتابع الحصيف في البحوث اللغوية نفسها". الوعي باللسانيات السوسيرية في الفصل الخامس، "تبلور الوعي باللسانيات السوسيرية والسعي إلى تقديمها تقديمًا متّسقًا"، يتبحّر السوداني في دراسة الفترة الممتدة من نشأة المبحث الأسلوبي إلى ظهور الترجمات العربية الخمس لدروس سوسير، وتُعتبر هذه الفترة تتويجًا للمراحل السابقة؛ إذ تعددت خلالها أوجه تعامل اللغويين العرب مع آراء سوسير تقديمًا وتوظيفًا ومُحاوَرة. ويرى السوداني أنّ اطّلاع الباحثين العرب على سوسير تمّ على نحو تصاعدي ملحوظ، فنجد أن العقدين التاسع والعاشر من القرن العشرين شهدا أوج الاهتمام باللسانيات السوسيرية. وهو أمر يمكن تفسيره بالتحاق المغرب العربي بالبحث اللساني بعد استقلال دوله وتأسيس الجامعات وبعض مراكز البحث فيها، وقد أتاحت الخلفية الثقافية الفرنكوفونية للباحثين أن يكون انفتاحهم في المغرب العربي على اللسانيات السوسيرية مباشرة بلغتها الفرنسية؛ وبالتطور الذي شهدته الدراسات اللسانية في المشرق العربي، لا سيما لدى الجيل اللاحق للرواد. وفي أواخر القرن العشرين، ما عاد الاهتمام باللسانيات السوسيرية منحصرًا في التقديم والعرض، بل أصبحت آراء سوسير ومفاهيمه خلفية لقراءة التراث وأداة نظرية لمعالجة الظواهر اللغوية، وما عادت البحوث مكتفية بالعرض، إذ أُنجز منها ما يناقش الدرس السوسيري من حيث الخلفيات والأصول ودرجة الجدّة. دروس سوسير وإشكاليات الترجمة في الفصل السادس، "ترجمة دروس فردينان دي سوسير وإشكالية المصطلح اللساني"، يقول المؤلف إن أهم ما يخلص إليه من رصد تداول الجهاز المصطلحي السوسيري في البحوث اللغوية العربية هو التنامي الحاصل في وعي اللغويين العرب المعاصرين بالمصطلح السوسيري. وهو تنامٍ حاصل في مستوى الوعي بالمفهوم من جهة، وفي مستوى الأداة التوليدية من جهة أخرى. ويعدّ السوداني هذا التنامي حصيلة تطور الأداة التوليدية التي يباشر بها اللغويون المصطلح اللساني في لفظه الدخيل؛ "فقد شاع عند اللغويين في أواسط القرن العشرين أن يتوسّل بالتعريب أداة توليدية، وهو توسّل خلفيته الحذرُ من مجانبة مدلول الدالّ الأجنبي، لذلك نجد من اللغويين، نحو حسّان والسعران وبشر، من يحرص على إيراد اللفظ الفرنسي إلى جانب اللفظ العربي. على أن هذه الفترة لم تخلُ من محاولات لتركيز مقابلات عربية للدوالّ اللسانية الوافدة، ولكنها محاولات ربما أبطأها الحرص على الأمانة المعرفية أو الخشية من التباسها بالتراث القومي". ويرى السوداني أن الاتجاه الواضح نحو المقابل العربي بدأ لما انبثقت بواكير السعي إلى ترجمة دروس سوسير؛ إذ إن الخلفية المباشرة لبدء هذا السعي هي تركّز وعي لساني على درجة من التماسك. وإن جمعنا قضية المصطلح اللساني إلى إشكالية الترجمة، "أمكن صهر ذلك في مشروع ترجمة لدروس سوسير تحقق شروط الدقة المعرفية. وهو مشروع لا يكتمل ما لم تحقق ضوابط التدقيق المعرفي القاطع في علم الترجمة". نيو-سوسيريات في الفصل السابع والأخير، "السوسيريات الجديدة"، يدرس السوداني التلقي العربي لسوسير في مطلع القرن الحادي والعشرين، أي في الفترة التي اتسمت باحتفال الأوساط العلمية العالمية بمئوية وفاة سوسير ثم مئوية ظهور كتابه، وتزامن ذلك مع ظهور مجموعة أخرى من بحوث سوسير. ويقول المؤلف إن مراجعة التلقّي العربي لسوسير، في العقدين الأوّلين من القرن الحالي، تحيلنا إلى معطيات لا تجعلنا نرى في البحوث اللغوية العربية المتعلقة بسوسير في هذه الفترة سوى أربع سمات: الأولى، الباحث العربي لا يزال يتعامل مع الدرس اللساني بنظرة عجلى، فيها من التسرع ما يصرف عن الاستثمار والنقد؛ والثانية، غياب التنسيق في الأوساط البحثية العربية رغم ما أصبح متاحًا من إمكانيات التشبيك والتواصل؛ والثالثة، غلبة التقديم المدرسي لآراء سوسير من دون تطوير حقيقي، واللافت في هذا الجانب أن كثيرًا من الكتابات تبلغ درجة من التسطيح تجعلها تجانب ما يراه سوسير فعليًا؛ والرابعة، البحوث يكرّر بعضها بعضًا، فحتى اتهام اللاحق للسابق بالتقصير والقصور في فهم سوسير هو أيضًا من المتكرر، على أنّ نواحيَ مهمة لو تحققت لتوافرت نواة صلبة للتجديد في البحث اللغوي العربي.
عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟
يتناول عبد الفتاح ماضي في كتابه عثرات في الميدان: كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟ الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المسار المتعثّر لثورة 25 يناير 2011 في مصر؛ باعتبارها جزءًا من نضالٍ ممتد في التاريخ الحديث للشعب المصري من أجل التغيير، وحدثًا أداره فاعلون داخليون وخارجيون بقناعات ومصالح مختلفة، وفي سياقات إقليمية ودولية غير مواتية. يروم الكتاب فهم التحوّلات الكبرى التي طرأت على مسار الثورة، والبحث في عددٍ من القضايا المحورية، مثل دور النخب ومجموعة من جنرالات الجيش في الثورة، والعامل الخارجي والديمقراطية في مصر، وقضايا الهوية والتغيير في مصر. مقدمات الثورة يتألف الكتاب (300 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من سبعة فصول. في الفصل الأول، "مقدمات ثورة 25 يناير"، يعرض المؤلف مقدمات ثورة يناير، مع التركيز على إرث مرحلة مبارك في المجالَين السياسي والاقتصادي، موضحًا كيف أغلق نظام مبارك سبل الإصلاح السياسي التدرجي، وأفسد الحياة السياسية عقودًا طويلة، ما أدّى إلى إسقاطه وحزبه الحاكم عبر التظاهرات الشعبية. كما يعرض كيف ثارت قطاعات واسعة من المصريين ضد النظام، ودور الجماعات الاحتجاجية الشبابية والحركات الاجتماعية والعمالية في تعبئة الشارع ضد مبارك، ودور أدوات التواصل الاجتماعي والإعلام والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل. أما في الفصل الثاني، "اندلاع الثورة وردّ النظام"، فيرصد المؤلف اندلاع الثورة، وردّة فعل سلطة مبارك التنفيذية عليها، بدءًا من عناده وتهوينه شأن الحراك الشعبي ضده، مرورًا بخطابات التهديد والوعيد واستخدام القمع الوحشي ضد المتظاهرين، وانتهاءً بمحاولات التشبث بالسلطة وبدء تحرك الجيش. تحولات الثورة يُعنى المؤلف في الفصل الثالث، "تحولات الثورة المصرية"، بمسار ثورة يناير وتحوّلاتها، فيتناول تحول الثورة من "ديمقراطية" إلى "انتخابية"، من خلال البحث في الطريقة التي أدار بها الفاعلون السياسيون الرئيسون المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مبارك (12 شباط/ فبراير 2011 - 30 حزيران/ يونيو 2013)، مركزًا على انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة الدولة، واعتماد خريطة طريق تقوم على التنافس الحزبي الانتخابي قبل التوافق، وسلوك القوى السياسية التقليدية التي تصدّرت المشهد السياسي، إضافةً إلى غياب الحوار والتوافقات الكبرى. كما يتناول المؤلف تحوّل ثورة يناير من كونها "انتخابية" إلى "مضادة"؛ من خلال عرض الطريقة التي أوقف بها جنرالات المجلس العسكري المسار الديمقراطي، وقادوا ثورةً مضادة أطاحت المكتسبات القليلة التي حققتها ثورة يناير، وأقامت نظامًا يقوم على الصراع الصفري مع القوى التي لا تصطف مع النظام. ويوضح هذا الفصل كيف كانت اختيارات النخب تُعبّر، في واقع الأمر، إمّا عن قناعات وأفهام مغلوطة، وإمّا عن مقدمات أيديولوجية متحجرة، أو مصالح ضيقة، أو نصائح غير مدروسة قُدّمت من أطراف مختلفة، أو عن خليط من هذا وذاك. تجارب دستورية ينصب اهتمام المؤلف في الفصل الرابع، "محاولات الحوار الوطني"، على محاولات الحوار التي جرت في مراحل مختلفة؛ حيث يبدأ بعملية الحوار التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين قبل اندلاع الثورة بشهور، واستمرت في الشهور الأولى للثورة، وتُوّجت بما سُمّي وثيقة التحالف الديمقراطي. كما يعرض المؤلف حوارات المجلس العسكري الحاكم حتى لقاء "فيرمونت" وانتخاب الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى الحوارات التي أجراها هذا الأخير، ثم بعض المبادرات التي قُدمت بعد 30 حزيران/ يونيو 2013. أما في الفصل الخامس، "التجربة الدستورية بعد الثورة"، فيقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة المجلس العسكري حين شهدت البلاد إعلانًا دستوريًا في 13 شباط/ فبراير 2011، ثم تعديلات دستورية متعلقة بـ 9 مواد من دستور 1971، ثم إعلانًا دستوريًا آخر في 30 آذار/ مارس 2011، ثم إعلانَين دستوريّين (في 25 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) يعدّلان إعلان 30 آذار/ مارس، ثم إعلانًا دستوريًا مكملًا في 17 حزيران/ يونيو 2012. كما يقدم المؤلف الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة مرسي؛ وذلك حين عرفت مصر في 12 آب/ أغسطس 2012 إعلانًا دستوريًا جديدًا (ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران/ يونيو 2012)، والإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ودستور 2012. ويقدم المؤلف، أيضًا، الوثائق الدستورية التي ظهرت في مرحلة ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، وشهدت فيها البلاد بيان القوات المسلحة في 3 تموز/ يوليو 2013، وإعلانَين دستوريين (في5 و7 تموز/ يوليو 2013)، ودستور 2014. جنرالات الداخل وعوامل الخارج يتناول المؤلف في الفصل السادس، "جنرلات الجيش وثورات الشعب"، بعض الجوانب ذات الصلة بعلاقة مجموعة من جنرالات الجيش المسيطرين على المؤسسة العسكرية بثورة يناير، فيعرض حالات مقارنة من خارج العالم العربي لإيضاح ما يأتي: سبب استيلاء العسكريين على السلطة، وطبيعة الحكم العسكري، وطريقة خروج العسكريين من السلطة. ثم يعرض باقتضاب الحالة المصرية، بدءًا من جذور تدخّل الجنرالات العسكريين في السلطة، وتطور أدوارهم السياسية والاقتصادية، مرورًا بالمغالطات التي ردّدها إعلام ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013 بشأن دور الجيش، وانتهاءً بالمخاطر المترتبة على طبيعة النظام الإقصائية والبوليسية؛ لا على الحياة السياسية والثورة فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ذاتها والأمن القومي العربي أيضًا. في الفصل السابع، "العوامل الخارجية والثورة المصرية" (الفصل الأخير)، يعالج المؤلف بعض الأدوار الدولية والإقليمية في مسار الثورة المصرية، فيتناول موقف القوى الغربية من مسألة الديمقراطية في البلدان العربية قبل ثورات 2011، ثم موقف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وروسيا من الثورة المصرية، ودعم القوى الإقليمية نظامَ ما بعد 30 حزيران/ يونيو 2013، إضافةً إلى أثر استخدام خطاب الحرب على الإرهاب واستراتيجياته في مسار الثورة.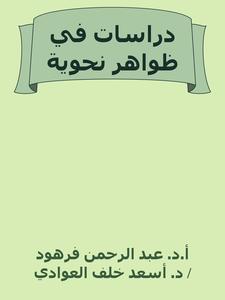
دراسات في ظواهر نحوية
يعد النحو من أبرز أقسام اللغة التي كثر فيها الجدل والاختلاف والتفسيرات المختلفة للظواهر النحوية التي تبارى فيها النحويون في أثناء تقعيدهم النحو ، إلى الحد الذي أثرى هذا العلم ، فلم يترك النحويون مسألة إلا ودققوا النظر فيها ووضعوا لها عللاً ، وربما تجادلوا واختلفوا أو تناظروا وتحاكموا ، خدمة لتلك اللغة فأثريت المكتبة النحوية بالمؤلفات والبحوث
الأمثال العامية
يضم هذا الكتاب طائفةً من الأمثال الشعبية العامية التي تجسد إرثًا مهمًّا في ميدان الأدب الشعبي، وقد جمع أحمد تيمور هذه الأمثال وَرَتَّبَها وفقًا للأبجدية العربية، وكتابه هذا أشبه بقاموس يُعينُ على فهم مفردات الحياة الاجتماعية عند البسطاء الذين كانوا سببًا في نشأة هذا النوع من الأمثال، ويُحْمَدُ للكاتب في هذا المُؤَلَّف ذِكْرُه للمناسبة التي كانت أشبه بلحظة التنوير في خَلْقِ المثل؛ وذلك نظرًا لأهميتها في الكشف عن البواعث الاجتماعية التي انتقلت بالمثل من خصوصية الحال عند صاحبه إلى عمومية التداول بين كافة أطياف المجتمع على اختلاف طبقاتهم وأعراقهم. وإنه لمن الإنصاف لهذا الكتاب أن نَصِفَه بأنه سجل المثل السائر عَبْرَ الزمان المُنْصَرِمِ العابر.
الخليل و العروض
كان الشعراء ولم يكن الخليل وكان الشعر ولم تكن العروض وكان ميزانهم أذن تتقبل النغم وتستسيغه وجرى على الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام وعقوداً من العصر الأموي ضابطهم فيها ما تقبله الأذن العربية مما يُقالُ من الشعر فيرونه مقبولاً أو مردودا.ولم تكن كلمة(العروض) الاّ بمعناها اللغوي فلم تكن علماً من العلوم تؤلف فيه الكتب والمصنفات.وكانت الزحافات والعلل مستساغة إستساغة الشوارد من النحو قبل تدوينه.فقد كانت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول دون معرفة هذه المصطلحات النحوية قبل وضع علم النحو ,وإن كانت لكل قاعدة نحوية بمعناها شواذ فإن الزحافات والعلل في العروض تشبهها ويتقبلها الناس وتتقبلها الأذن العربية دون معرفة الزحاف ولا أسمه.في كتابي هذا الذي هو حلقة في سلسلة كتب عن العروض صدر منها كتابان هما(أوزان الشعر) الذي جمعت فيه أوزان الشعر قديمها وحديثها,والكتاب الثاني(رباعيات الدرة) الذي طبقت فيه الأوزان في رباعيات شعرية تمهيداً لدراستها واستبيان مايمكن أن يكون مستساغا أو غير مستساغ. في هذا الكتاب(التجديد في العروض) هو دراسة مقارنة بين الأوزان قبل الخليل والمستساغ منها وما فيها من زحافات وعلل, وعندما جاء الخليل ماذا فعل بالأوزان وماذا أحدث فيها والدوائر وما فعلته الدوائر بالبحور. وتناولت التجديد في العروض من حيث تجديد الشكل في الشعر العربي ومحاولات التجديد الأخرى في الدوائر وإضافة الدوائر والأوزان الى البحور المعروفة باستخدام العلل والزحافات المعروفة في علم العروض.وإن كنت أميل الى اسلوب ومنهج الشيخ جلال الحنفي رحمه الله في الإعراض عن الزحافات وأسمائها الى إستخدام كلمة(البدائل) مكانها تسهيلا وتيسيرا للدارس والشاعر على حد سواء.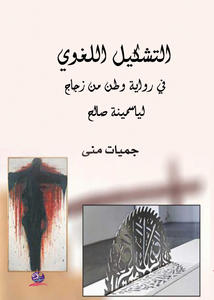
التشكيل اللغوي في رواية وطن من زجاج لياسمينة صالح
إن الهدف من وراء طرح هذا العنوان كموضوع للبحث، هو الكشف عن قدرة الرواية العربية عموما والجزائرية خصوصا على استثمار القضايا اللغوية من خلال التوغل في خبايا النص الروائي، وإبراز ما للغة من سمات جمالية وفنية تصويرية، فكل ناقد أو دارس للجنس الروائي يعلم تماما أن الخطاب الروائي الجديد قد اكتسب فرادته من خلال تميزه في شكله وأدائه اللغوي، لكن كيف حقق هذا التميز بدراسة تطبيقية للغة، هو ما نسعى للكشف عنه في بحثنا.إن أي قراءة لغوية لرواية ما تعتمد على الكشف عن الجوانب التركيبية للغة بسماتها التشكيلية الجمالية، والأسلوبية اعتمادا على منهج منفرد بذاته، ومحاولة إسقاطه بكامل أدواته الإجرائية والتقنية، لهو تعسف وإجحاف في حق النص الروائي، لأنه قد يفقده خصوصيته، فالنص الروائي عالم أرحب، وبقدر ما يملك القدرة على استيعاب تناقضات الحياة، والواقع وتشعباته، فإنه في المقابل يستطيع أن يستوعب نظام اللغة الذي يتنافى مع كل قانون أو إجراء تقني بحت، لذلك قد عمدنا إلى استثمار مجموعة من التقنيات التحليلية التي تراوحت بين الأدوات الأسلوبية والسميائية التي تعمل على مقاربة الخطاب الأدبي من وجهة نظر دلالية تحليلية تبقى دوما احتمالية المعنى.
الصّوت اللّغوي دراسة وظيفيّة تشريحيّة
لقد بدأ الاهتمام بعلم الأصوات عند العرب في القرن الثاني للهجرة، وأضحى هذا العلم أساساً ومرجعاً هاماً لسائر علوم اللغة العربية. فنمت النشاطات اللغوية لعلماء اللغة العربية في كلّ العصور، ولكن لم تخرج آراؤهم في مجال الصوتيات على مجرد الملاحظات وإخضاعها للتجربة والأحاسيس المتدفقة، دونما استعمالٍ للأجهزة العلمية المتطورة والتقنيات الحديثة التي تعج بها المخابر الصوتية في وقتنا الحاضر.
اللغة في المعرفة أبحاث في الأساس اللغوي للأدب
اللغة في المعرفة المعرفة بخصائصها الأساسية لا تحقق وظيفتها في الفن إلاَّ عبر المفاهيم، بما هي بنى عقلية في لبوس لغوي، وهي في العلوم الإنسانية كما في الأدب والميادين التي تتخذ اللغة جسداً لها معطى عقلي، حيث تفرض اللغة على الأدب وعلى الفكر المتجسد بها بشكل عام، خصائصها ومفاهيمها ومعانيها الاجتماعية، التي تكونت بفضل عقول أخرى سابقة على تجربة الكاتب الذاتية، وكانت لها في التجربة الماضية رؤية خاصة إلى العالم. والأساس في الأدب أداته الأولى، وهي اللغة، كما أن أساس التعبير في كل فن أداته، يعبر بها عن مضمونه. أن يكون النص الأدبي لغة، ينبغي أن يتضمن عمليات معرفية، معرفة ذات بعد جمالي، أي تشكيل المفاهيم الخاصة بالعالم موضوعة في صورة فنية، لذا هي معرفة ذات خصوصية جمالية، تتركز في مجمل جوانب النص الأدبي، وترتبط بالعدسة التي يضعها القارىء في عينه الجمالية. وبكون النص لغة، وإن كانت في وظيفتها الجمالية، تلفت الانتباه إلى ذاتها، وليس إلى مرجعها، إلاَّ أنها، في جميع الأحوال، تحمل في داخلها معنى يشكل مع اللفظ وحدة دلالية تخص الكاتب، وتختلف عن المتعارف عليه. الدكتور نسيم عون من مواليد العيشية قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي. • متقاعد من الجامعة اللبنانية، أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. • حاز على ليساس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة اللبنانية، وماستر في اللغة الروسية وآدابها من جامعة موسكو الحكومية، ودكتوراه PHD في الأدب العربي من معهد الاستشراق ـ أكاديمية العلوم السوفياتية. • أستاذ مشرف لغاية الآن على رسائل الماجستير في الجامعة اللبنانية، وفي الجامعة الإسلامية في لبنان. • له عدة أبحاث منشورة حول دور اللغة في المعرفة، والمشكلات التي تطال الدماغ وتبرز في عمل اللغة. • من مؤلفاته: "الألسنية ـ محاضرات في علم الدلالة"، "العنف ونمو الدماغ البشري"، "مداخل نظرية لمقاربة النص الادبي"، "الديسلكسيا ـ الاضطرابات اللغوية والدماغ".
النحو العربي في ضوء اللسانيات الحديثة
بين طيّات هذا الكتاب يناقش هذا الكتاب مشكلات النحو ودعوات تجديده. ويجيب عن تساؤلين مهمين: هل أزمة النحو العربي من النحو ذاته أو من طبيعة اللغة العربية؟ وما الأسباب التي جعلت من النحو العربي معقداً مستعصياً على الفهم؟ ثم يستعرض أثر اللسانیات الحدیثة في تجدید النحو من منظور النحو الوظیفي، والنحو التعلیمي، والنحو الحاسوبي. في محاولة للإجابة عن تساؤلين مهمين آخرين: هل اللسانيات الحديثة قادرة على أن تغنينا عن النحو التقليدي؟ ثم هل من الضرورة تجديد النحو العربي بالاستفادة من معطيات اللسانيات الحديثة لتيسير النحو التعليمي ولحوسبة اللغة العربية؟ د. جنان التميميّ، المملكة العربية السعودية. صدر لها: مفهوم المرأة بين نص التنزيل وتأويل المفسرين، دار الفارابي، 2012.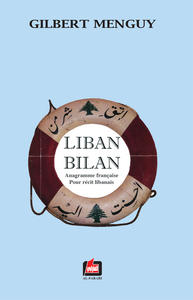
Liban Bilan
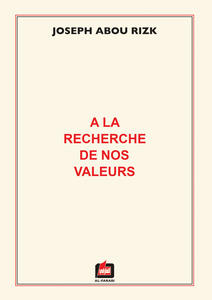
A LA RECHERCHE DE NOS VALEURS
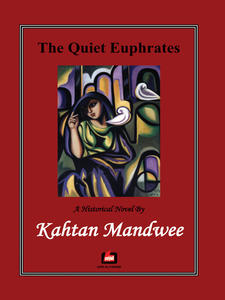
The Quiet Euphrates
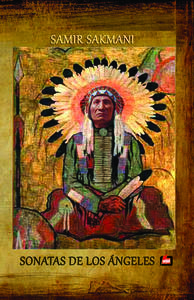
SONATAS DE LOS ÁNGELES
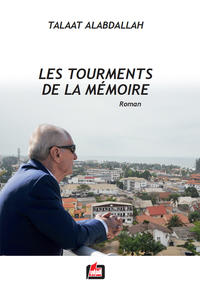
LES TOURMENTS DE LA MÉMOIRE

أشياء تشبه الكلمات

قراءة نحوية ثانية
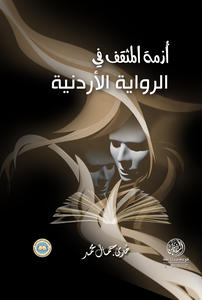
أزمة المثقف في الرواية الأردنية

علم العروض والقوافي
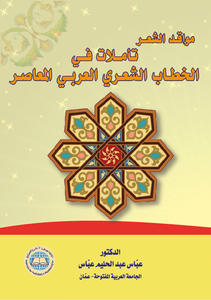
تأملات في الخطاب الشعري العربي المعاصر
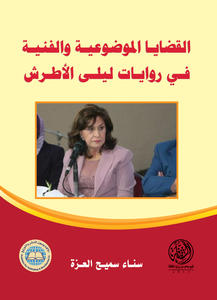
القضايا الموضوعية والفنية في روايات الكاتبة ليلى الأطرش
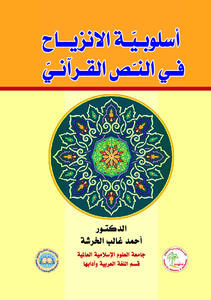
أسلوبية الانزياح في النص القرآني

البنية الإيقاعية في الشعر العربي المعاصر

الذاكرة...والكلمات..كتابات في أدب السيرة

أنساق التماثل في الشعر المعاصر
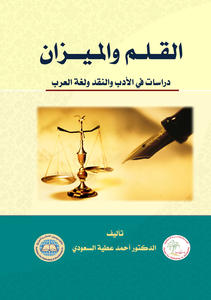
القلم والميزان (دراسات في الأدب والنقد ولغة العرب)
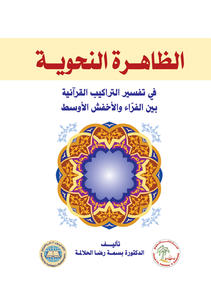
الظاهرة النحوية في تفسير التراكيب القرآنية بين الفراء والأخفش الأوسط

العولمة الثقافية واللغة العربية
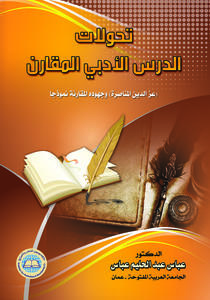
تحولات الدرس الأدبي المقارن
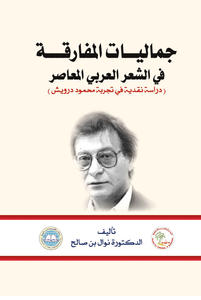
جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر

ثقافة النص.. قراءة في السرد اليمني المعاصر

الرواية الخليجية قراءة في الأنساق الثقافية

خطاب المثاقفة وحوار الحضارات

الذاتية في "الوساطة"
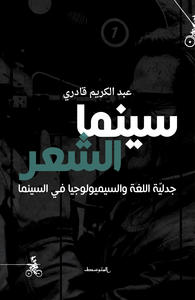
سينما الشعر - جدليّة اللغة والسيميولوجيا في السينما
جاء هذا الكتاب «ليختصر مسافات البحث في مفهوم «سينما الشعر»، وتقريبها للمتلقّي؛ حيث سيكون بمثابة المرجع الذي يمكن العودة له، كلما دعت الحاجة لذلك، ومن جهة أخرى،» سيكون «جامعاً شاملاً لجوانب «اللغة في السينما»، وشرحاً مستفيضاً لنظرية بير باولو بازوليني، وبوصلة، تهدي التائهين، في صحراء السؤال، وتفتح شهية الباحثين والنقّاد لتقديم كتب وبحوث أخرى، خدمة للبحث ذاته، وإغناء للمكتبة العربية الفقيرة جداً، في مجال الفن السابع، كما سيسمح للمُتلقّي/القارئ العربي، بأنّ يطّلع، على جوانب عدة في موضوعة «سينما الشعر»، وما يتصل بها، من فروع اللغة السينمائية، من سيميولوجيا ومذاهب أدبية ونقدية أخرى، ناهيك عن الدراسات التحليلية والمُقارنة التي قام بها الكاتب كجانب تطبيقي، لتسهيل عملية فهم الجانب النظري المُعقّد، وكل هذا يمكن العثور عليه في هذا البحث، بدل جمعها، من عشرات الكتب، والمجلات، والصحف، والمواقع الإلكترونية؛ حيث سيستريح القارئ من هذه المشقّات، بمجرد حصوله على كتاب «سينما الشعر ... جدلية اللغة والسيميولوجيا». المؤلف: عبد الكريم قادري: مواليد عام 1982. ناقد وباحث سينمائي جزائري، أصدر العديد من المؤلفات، ونشر عشرات الدراسات المتخصصة في السينما بمختلف المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية، كما ساهم في تأسيس مجلة «السينمائي» الورقية، وألقى محاضرات ومداخلات بمهرجانات سينمائية محلية ودولية.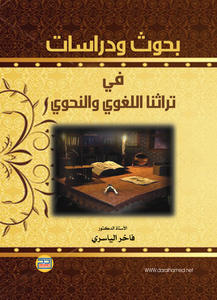
بحوث ودراسات في تراثنا اللغوي
يتضمن هذا الكتاب عدداً من البحوث والدراسات في محيط التراث اللغوي والنحوي كانت في الغالب قد افترشت مجلات علمية متخصّصة ومحكّمة في أوقات وأزمان مختلفة، وقد ماجت في نفسي أفكار، إذ الأحوال تمورُ، وهاجت بواعثها، وللزمان أوقات تثورُ، بأن يضمها كتاب واحدٌ، فلعلها تكون بذلك أقرب إلى سدنة اللغة العربية الكريمة، وعشاق نظامها ونظْمها، فيقربُ تأمّلها، وتزول كلفة ملتمس الفائدة منها، وغرضي الرئيس من جمعها هو شدة كلفي بها، وبخاصة أنها تلامس أغراضا للعربية كثيرة، ثم إن هذه البحوث والدراسات التي جمعتها في هذا الكتاب تسهم اسهاماً جليلاً في توضيح بعض ملامح تراثنا النحوي واللغوي واستجلاء بعض أسراره وإبراز الحيثيات التي وجهت مساره والأسس التي قام عليها صرحه؛ وأمرُ تراثنا اللغوي والنحويّ، لا يخلو من الغرابة، فهو ثري غزير المادة، وضعت فيه آلاف التصانيف منذ أن أصبحت العربية موضوع درس وتقنين إلى عصرنا هذا؛ وهذا من شأنه أن يبعث على الإعجاب والاعتزاز لا لما ينمّ عنه من عناية بالعربية فحسب بل كذلك وخاصة لما يدلّ عليه من مجهود ويترجم عنه من عمل فكريّ بالغ الأهمية..
المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية
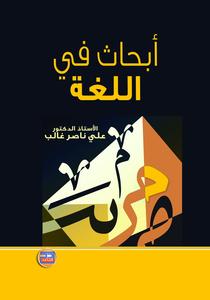
أبحاث في اللغة
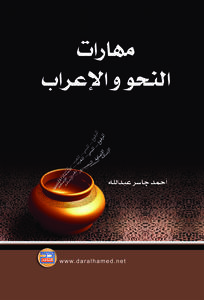
مهارات النحو والاعراب
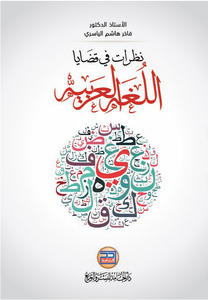
نظرات في قضايا اللغة العربية

المنحى الدلالي

أسس المنهاج واللغة

القواعد والتطبيق النحوي
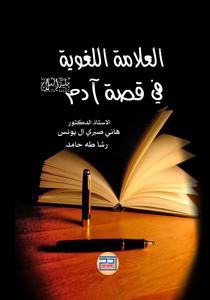
العلامة اللغوية في قصة ادم

بلاغة الحذف في التراكيب
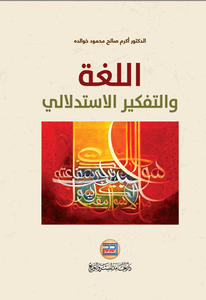
اللغة والتفكير الاستدلالي
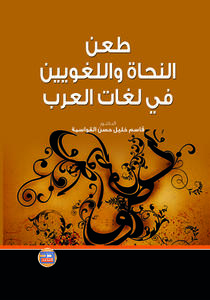
طعن النحاة واللغويين في لغات العرب

إعراب المعلقات السبع
هو كتاب للمؤلف عبد العظيم أحمد علي صبرة كتاب في الإعرب- اللغة والنحو، يضم إعراباً وافياً لأبيات المعلقات السبع على رواية الزوزني، حيث يبدأ المؤلف بإعراب معلقة امرئ القيس وانتهى بمعلقة الحارث بن حلزة اليشكري، وهذا الكتاب قيمة علمية وأدبية ولغوية، فهو بالإضفة لما يحتويه من إعراب لجميع كلمات المعلقات وضع الكاتب في أسفل الصفحة تفسيراً للمعاني الصعبة في الأبيات بالإضافة إلى المعنى الإجمالي لبيت الشعر، وفوق هذا كله وضع الكاتب نبذه عن حياة كل شاعر من شعراء المعلقات في بداية الفصل الذي يضم إعراب المعلقة. اتسم الكتاب بالسهولة في التوضيح وتوصيل المعلومة بأبسط الطرق وعرض المعلومة بشكل واضح. ويستفيد من كتابه هذا طلبة اللغة العربية كافة والمهتمون بالشعر العربي والذواقة والأدباء والنقاد، كما يمثل مرجعا لأبحاث طلبة الدراسات العليا.
سير الشعراء: من بحث المعنى إلى ابتكار الهوية
إنّ السير الذاتية التي كتبها بعض الشعراء وجنَّسوا محكيّاتهم تحتها، وهي قليلة بالقياس إلى عشرات السير الأخرى التي ألّفها مؤلفون من زوايا ومشارب وأفهام أخرى مختلفة، تُعبّر عن روح جديدة في كتابتها، وعن كيفيّاتٍ مخصوصة في بنائها وتخييلها، ويتجلى فيها الشِّعر بأناه الغنائي والمجازي حاضِرًا فيها بكثافته ليس على مستوى الكون الاستعاري والتخييلي لهذه السير، بل كذلك على مستوى تشييدها فنّيًا. لقد أثارت مثل هذه السير، مُجدَّدًا، مسألة الشعر المقيم في قلب الظاهرة السردية، والعكس صحيح؛ عندما يتعلق الأمر بالسيرذاتي وشكل استضافته داخل الفضاء الشعري.
جدلية الخفاء والتجليدراسات بنيوية في الشعر
ليست البنيوية فلسفة؛ لكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود. ولأنها كذلك فهي تثوير جذري للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه. في اللغة، لا تغير البنيوية اللغة؛ وفي المجتمع، لا تغير البنيوية المجتمع؛ وفي الشعر، لا تغير البنيوية الشعر.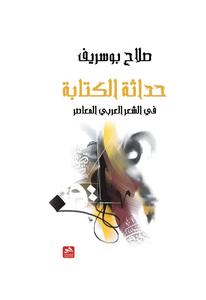
حداثة الكتابة في العشر العربي المعاصر
حاول هذا الكتاب أن يقترب من موضوعه، وهو يُدرك، منذ اللحظات الأولى، أنَّ موضوعا من هذا النوع ليس سهلا، وأن مَضَايِقَهُ أكثر من مَسَالِكِهِ. فالذَّهاب صَوْبَ "الكتابة" باعتبارها مُقْتَرَحاً شِعرياً، كان محكوما بلقائنا اليومي، بالممارسة النصية لهذا المقترح
تكوّن العربيّة الإسرائيلية
يبحث هذا الكتاب في تاريخ دراسات اللغة العربية وسياساتها في المدارس اليهودية الإسرائيلية، وتأثير معطيات السياسة والأمن في دراسات اللغة العربية في إسرائيل، مستندًا بصورة رئيسة إلى وثائق أرشيفية تغطي الحقبة بين عامي 1935 و1985. كما يشمل تحليلًا لدراسة العربية في المدارس اليهودية الإسرائيلية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، منطلقًا من التحقيق في الحوادث التاريخية ومؤسسات صُنع القرار، علمًا أن الاعتبارات الأمنية - السياسية كانت أساسًا في تحفيز الأفراد والمؤسسات، ممن أطلقوا الدراسات العربية في المجتمع اليهودي - الإسرائيلي وأشرفوا عليها وموّلوها.
اللغة العربية في النظام الصهيوني
يتناول هذا الكتاب قضية مواقع اللغة العربية ومنتجاتها بصفتها حلبة بنيوية جرت من خلالها إعادة تصميم العلاقات بين الفلسطينيين في إسرائيل من جهة، والدولة والنظام الصهيوني من جهة أخرى، منذ عام 1948 حتى اليوم. ويركز على الأحداث في حقل العربية الفصحى كونها علامة الجماعة الوطنية الفلسطينية في إسرائيل، فالفصحى استعملت بصفتها موقعًا لبناء الهُوية الجماعية للقومية العربية العلمانية في الحداثة، وصارت ترمز إلى أنواع جماعيات مختلفة في فترات شتّى من تاريخ العرب. ومحاولة وصف التاريخ الاجتماعي للغة العربية الفصحى ومنتجاتها مبنية على الفهم الأساس الذي يفيد بأن أجهزة الدولة والفلسطينيين اعتبروا العربية الفصحى رمزًا للجماعية الوطنية والقومية لدى الفلسطينيين في إسرائيل. وبناء عليه، فإن من يسيطر عليها يعيد صوغ هذه الجماعية. واللافت هو أن أجهزة الدولة في إسرائيل قبلت وظيفة العربية الفصحى هذه، وأفردت لها حلبة عمل، وعملت بلا كلل لإعادة صوغ الفصحى بما يتلاءم والعلاقات الاستعمارية بينها وبين مواطنيها الفلسطينيين.
التراث المعجمي العربي من القرن الثاني حتى القرن الثاني عشر للهجرة
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب رمزي منير بعلبكي التراث المعجمي العربي من القرن الثاني حتى القرن الثاني عشر للهجرة، مؤرخًا للتراث المعجميّ العربيّ منذ نشأته في القرن الثاني للهجرة وحتى القرن الثاني عشر، ومظهرًا التنوّع الكبير في أنماط التصنيف المعجميّ العربيّ من حيث الموضوعات، وترتيب الموادّ، والاستيثاق من صحّتها وشواهدها، والمكانة الرفيعة والمحوريّة التي حظيت بها المصنَّفات المعجميّة في التراث العربيّ والإسلاميّ، ومبيِّنًا أن نشأة المعجم العربيّ إنّما ترجع إلى جهود اللغويّين الأوائل في دراسة أصوات العربيّة وصرفها ونحوها ودراسة القرآن الكريم على وجه الخصوص، من دون تأثير أجنبيّ. يتألف الكتاب (672 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة أبواب. في الباب الأول الذي جاء بعنوان "بدايات النشاط المعجميّ"، يبحث بعلبكي في النشاط اللغويّ المبكر والعوامل التي أفضت إلى ظهور المعاجم الأولى، متناولًا الدراسة اللغويّة المبكرة، وكلام الأعراب، وجمع اللغة، وعصور الاحتجاج، ودور الغريب، وبدايات التصنيف المعجميّ، مبديًا الملاحظات حول الدراسات الحديثة للمعجم العربيّ وأصالة التراث المعجميّ العربيّ. وخلص بعلبكي إلى أن اللغويّين عدّوا كلام فصحاء الأعراب النموذجَ الأعلى للعربيّة، وأنهم عُنوا عناية كبيرة بما وقع في كلام هؤلاء من الغريب والنادر والشاذ. المعاجم المبوّبة أما الباب الثاني والذي عنوانه "المعاجم المبوّبة"، فيتناول فيه بعلبكي المعاجم المبوّبة، وهي التي ينطلق فيها مستخدمُها من المعنى إلى اللفظ، أي "يتحرّى اللفظ أو الألفاظ الواقعة تحت معنى ما، في حين أن الباحث في المعجم المجنَّس يبدأ باللفظ فيبحث عنه في موقعه في الترتيب فيجد معناه. والضرب المبوَّب يشتمل على الرسائل والكتب التي أُفردت لموضوع واحد - كالمعرَّب، واللحن، والأبنية ... إلخ - كما يشتمل على المؤلَّفات الموسوعيّة التي تضمّ بين دفّتَيها موضوعات مختلفة". وقد جعل المؤلف في هذا الباب عدة أقسام. في القسم الأول منها "الغريب والنادر"، يتناول بعلبكي غريب القرآن وغريب الحديث وغريب اللغة والنوادر. وفي القسم الثاني والذي حمل عنوان "الأمثال"، يتناول الكتب غير المرتَّبة ألفبائيًّا، والكتب المرتَّبة ألفبائيًّا، وكتب الأمثال المختصّة. أما في القسم الثالث والذي وسمه "النبات والحيوان وخلق الإنسان"، فيتناول النبات والحيوان وخَلْق الإنسان. ثم يتناول بعلبكّي على التوالي "المعرّب"، و"لحن العامّة"، و"الأضداد"، و"المشترك والمترادف"، و"الحروف والأصوات"، و"الأصوات"، حتى يبلغ القسم العاشر بعنوان "الأبنية"، وفيه يبحث في الاشتقاق والمذكّر والمؤنّث والمقصور والممدود والمثلَّثات وأبنية الأسماء، وفَعَلَ وأَفْعَلَ، وأبنية الأفعال عامّةً، وأبنية الأسماء والأفعال. وينتهي بقسم موسوم "المصنَّفات الموسوعيّة"، مكتفيًا فيه بالنظر في أهمّ المصنَّفات الموسوعيّة ووضعها في سياق التراث المعجميّ عامةً. المعاجم المجنَّسة يخصص بعلبكّي الباب الثالث من كتابه للحديث عن "المعاجم المجنَّسة"، وهي تلك التي يُراد بها المعجم عند إطلاقه في الاستعمال العامّ. يوضح المؤلِّف أن سِمَة هذه المعاجم أن مستخدمها يراجع اللفظ وصولًا إلى المعنى، وهي في الغالب - خلافًا للمعاجم المبوَّبة - تسعى إلى استيعاب جذور اللغة جميعًا، على تفاوت في مقدار إيرادها المفرداتِ المشتقّةَ من تلك الجذور. وبحسب المؤلف، إن "الباب الثالث هذا مؤلَّف من ثلاثة أقسام تقابل أنواع الترتيب الثلاثة المعروفة، أي الترتيب على مخارج الحروف مع التقليبات، والترتيب الألفبائيّ، ونظام التقفية أو الترتيب على أواخر الحروف. وسوف نبيّن طبيعة الترتيب في المعاجم المجنَّسة في الأقسام الثلاثة، إلا أن تركيزنا سوف يتعدّى ذلك إلى قضايا جوهريّة أُخرى، من مثل التوسّع في إيراد المفردات أو عكس ذلك، والمواقف المختلفة من إيراد الغريب أو النادر، والترتيب الداخليّ للموادّ ضمن الجذور، ونقد المعجميّين لأعمالِ مَن سَبَقَهم". في القسم الأوّل المشار إليه "المعاجم المرتَّبة على مخارج الحروف والتقاليب"، يتناول بعلبكي معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، ومعجم البارع في اللغة لأبي عليّ القاليّ، ومعجم تهذيب اللغة للأزهريّ، والمحيط في اللغة للصاحب بن عبّاد، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سِيْدَهْ. ويتناول في القسم الثاني "المعاجم المرتَّبة ترتيبًا ألفبائيًّا"، كتاب الجيم لأبي عمرو الشيبانيّ، وجمهرة اللغة لابن دريد، ومقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس، وأساس البلاغة للزمخشريّ. ويختم الباب بالقسم الثالث المعنون "المعاجم المرتَّبة على نظام التقفية"، وفيه يتناول بعلبكي كتاب التقفية في اللغة للبندنيجيّ، وتاج اللغة وصحاح العربيّة للجوهريّ، والعُباب الزاخر واللُّباب الفاخر للصَّغانيّ، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزآباديّ، وتاج العروس من جواهر القاموس للزَّبيديّ.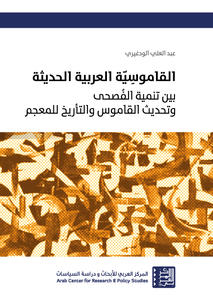
القاموسية العربية الحديثة: بين تنمية الفُصحى وتحديث القاموس والتأريخ للمعجم
صدر عن "سلسلة دراسات معجمية ولسانية" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب القاموسية العربية الحديثة: بين تنمية الفُصحى وتحديث القاموس والتأريخ للمعجم، ويبيّن فيه مؤلفه عبد العلي الودغيري أن القواميس العربية الحديثة والمعاصِرة استطاعت متابعةَ تطوُّر الفصحى من بداية عصر النهضة الحديثة إلى اليوم، كما يبيّن تفاعلَها مع المستجدّات من ألفاظٍ ودلالاتٍ وتراكيبَ واستعمالاتٍ، ومساهمتها في خدمة هذه اللغة وتطويرها وتحديثها وتيسير تعلُّمها واستعمالها وانتشارها، ونجاحها في تجاوز المشكلات التقنية والمنهجية في القاموسية القديمة. يتألف الكتاب (615 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من تمهيد وثلاثة أبواب. وفي التمهيد، "المعجم والقاموس"، يتحدث المؤلف عن المُعجَم في الاستعمال القديم، والمعجم في الاصطلاح الحديث، والقاموس، والمعجمية والوحدة القاموسية، والقاموس وعناصره الأساسية. تنمية المعجم ومواكبة الفصحى في الباب الأول، "تنمية المعجم ومواكبة الفصحى"، عتبتان وثلاثة فصول. في العتبة الأولى، "التوليد المعجمي وآلياته"، والثانية، "القياس وتنمية المعجم"، يتناول المؤلف تنمية المعجم العربي، وطاقات التوليد الخاصة بالفُصحى، وآليات تحديثها وتجديدها وإثرائها وإغنائها. أما في الفصل الأول، "التوليد اللفظي"، فيتحدث المؤلف عن التوليد بالاشتقاق والتوليد غير الاشتقاقي. وتحت التوليد بالاشتقاق، يتناول المؤلف الاشتقاق الصرفي، والإبدال، والقلب، والنحت. أما تحت التوليد غير الاشتقاقي، فيتناول التوليد بالتركيب، والتوليد بالاقتراض. وأما في الفصل الثاني، "التوليد الدَّلالي"، فيبحث المؤلف في المجاز وأهمّيته في تنمية المعجم، متحدثًا عن مسؤولية الأخطاء الناتجة من سوء الفهم لما يُسمَع أو يُنقَل، أو من نقصٍ في اكتساب اللغة اكتسابًا مثاليًا صحيحًا، ولا سيما عند الفرد الذي يستعمل لغةً غيرَ لغته الأم. فهذا الأمر ينتج منه سوءُ استخدام الألفاظ في مواضعها المناسِبة، فضلًا عن استعمالها في معانٍ غير معانيها الحقيقية. ثم يبيّن المؤلف في الفصل الثالث، "حالاتٌ أخرى"، آلياتٍ توليديةً أخرى ذات طبيعة خاصة، و"ذات يَدٍ" في تنمية المعجم بصفة من الصفات؛ إما لصعوبة إدراجها تحت التوليد اللفظي وحده أو الدلالي وحده، وإما لأنها من المباحث التي تحتاج إلى مناقشة قد تُخرجها كُلّيًا، أو جزئيًا، من باب التوليد. وهذه الحالات هي: حالة الترجمة، وحالة الارتجال، وحالة التضمين، وحالة الضرورة الشعرية، والأخطاء اللغوية وتنمية المعجم، وحالة الإدغام. القاموسية العربية قبل العصر الحديث خصص المؤلف الباب الثاني، "القاموسية العربية قبل العصر الحديث"، للحديث عن حصيلة الصناعة القاموسية العربية من بدايتها إلى عتَبة العصر الحديث، وعرض أبرز محطّاتها ومراحلها التي قطَعتها في مسيرتها الطويلة، والحدود التي وصلت إليها، مع إعادة توصيفها وتصنيفها، والتوقُّف عند أهم الإشكاليات التي عرفتها، وموقفها المُتشَدِّد من التطوّر اللغوي، والمولَّد والمُحدَث من ألفاظٍ عامة ومصطلحات خاصة. يشتمل هذا الباب على فصلَين. ففي الفصل الأول، "مرحلةُ التأسيس"، يتناول المؤلف دوافع الجمع والتدوين، ومعايير الفصاحة المعجمية القديمة، والأعمال الأولى والأسس التي قامت عليها، والقاموسية العربية بعد مرحلة التأسيس، كما يجيب المؤلف في هذا الفصل بإسهاب عن السؤال: هل العربية لغةٌ عقيمٌ؟ وفي الفصل الثاني، "شجرةُ القاموسية العربية حصيلةٌ وإعادةُ تَصنيف"، يقول المؤلف: "حصيلةُ ما أنتَجته القاموسية العربية عبر الحِقَب الماضية منذ بداياتها في القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) إلى بداية النهضة الحديثة (القرن الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر الميلادي)، كانت غنيّةً ومتنوِّعةً شكلًا ومضمونًا، حجمًا ومنهَجًا. شاركَ فيها علماء من أقطار البلاد الإسلامية كلها مشرقًا ومغربًا". القاموسية العربية الحديثة والمعاصرة في الباب الثالث، "القاموسية العربية الحديثة والمعاصرة"، توسَّع المؤلف في دراسة نماذج مختارة من القواميس الحديثة والمعاصرة، والعامة منها على وجه الخصوص، فتناولها من جوانبها المختلفة شكلًا ومضمونًا، مادةً معجمية، وأدواتٍ تقنيةً. وفي هذا الباب فصلان. ففي الفصل الأول، "نحو قاموس للغة العربية حديثٍ ومُتجدِّد"، يتناول المؤلف المادة المعجمية ومَدى مُواكبتها للعصر وتلبية حاجات المُستعمِل، والتقنيات القاموسية ومدى تطويرها وتحديثها. وفي الفصل الثاني، "القاموسية العربية المعاصرة ومدى مواكبتها لتطور الفصحى والتقنيات الحديثة: معجم اللغة العربية المعاصرة نموذجًا"، يتناول خصائص وسِمات، ومناقشات واحترازات (المادة المعجمية: مصادرها، وطبيعتها، ومعالجتها، إضافة إلى التقنيات المستعملة). وبحسب المؤلف، فإن العربية الحديثة "مرَّت بأطوار من التأقلُم والتكيُّف مع الظروف والأوضاع الجديدة تحت تأثير اللغات الأوروبية وثقافاتها وعلومها وفنونها، من جهة، ومُسايَرةً للتطوُّر الداخلي الذي حدَثَ لدى مُستعمِلي الفصحى الذين ارتفَع مستواهم وتحسَّنَ شيئًا فشيئًا بفضل ارتفاع مستوى التعليم وانتشار الوعي الثقافي واللغوي على نطاق واسع، من جهة ثانية. وبعد مراحل من التحوُّل والتغيير، وصلت إلى وضعها الحالي القابلِ بدوره لتحوُّلات وتغيُّرات قادمة بلا شك". ويضيف المؤلف أنه اختصر هذه المراحل التطوّرية في مرحلتين كبيرتين متمايِزتين: "أُولى حديثة، وكان من أهم خصائصها الاعتمادُ على الاقتراض أكثر من غيره، وثانية معاصِرة، وكان من أهم خصائصها الاعتمادُ على الترجمة والتوليد أكثر من الاقتراض". في القاموسية العربية التاريخية خصَّص المؤلفُ البابَ الرابع، "في القاموسية العربية التاريخية"، للحديث المستفيض عن المشروع الكبير المُدرَج ضمن الآفاق الواسعة للقاموسية العربية، وهو مشروعُ كتابة تاريخ المعجم العربي بكل مَساراته واتجاهاته الممكِنة، وفي هذا الباب ثلاثة فصول. ففي الفصل الأول، "التأريخُ لمُعجَم اللغة العربية: أسئلةٌ وإشكالاتُ"، يرى المؤلف أن "الغاية التي يسعى إليها التأريخ لمُعجَم لُغةٍ من اللُّغاتِ البَشَرية هي الوُصولُ في نهاية الأمر إلى وضعِ كتابٍ نُسمّيه قاموسًا تاريخيًا. وهذا القاموسُ يمكن أن نصوغَ له، بناءً على تصوُّرنا الخاص، وما وقفَنا عليه من نماذجَ في اللُّغات الأجنبية ذاتِ السَّبق في الميدان، تعريفًا مختصَرًا ومركَّزًا فنقول: هو كلُّ قاموس يَصفُ ألفاظَ اللغة ويُؤرِّخُ لها". وفي الفصل الثاني، "نحو خطة لإنجاز القاموس العربي التاريخي في ضوء التجربة الفرنسية"، يقدم المؤلف لمحةً عن تجربة التأريخ للمعجم الفرنسي، ويدرج ما ينبغي حسمُه قبل خُطّة الإنجاز: تحديد أهداف القاموس التاريخي، وتحديد مفهوم القاموس التاريخي أو تأريخ المعجم اللغوي، وتحديد المادة المعجمية، وتحديد المعلومات التي ينبغي أن تُقدَّم على هذه المادة المعجمية، وصياغة المادة المعجمية وما تشتمل عليه من معلومات. أما في الفصل الثالث، "نحو قاموس تاريخي للألفاظ العربية المهاجِرة (الألفاظ الفرنسية ذات الأصل العربي أو المعرَّب نموذَجًا)"، فيورد المؤلف مسارات التأريخ المعجمي، ويبحث في الألفاظ العربية المُهاجِرة إلى الفرنسية، ويرسم رحلة البحث عن العربيات "المُغتَرِبات".