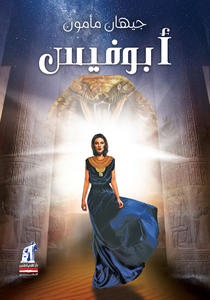
أبوفيس
هل ينتصر الشر في أرض كميت السوداء...؟! جولة بين أروقة الزمن لغسترجاع الحلم الضائع والحب المفقود. جولة في قلب الحاضر، ودهاليز المعابد الفرعونية حيث تدور الدوائر فتدب الحياة في التعاويذ السحرية القديمة.. وتفتح أبواب الشر والظلام لتخلف وراءها رمزًا دمويًا غامضًا يُرسم على جباه الضحايا!! سر غامض حار المحققون والنيابة في فك رموزه الغامضة،،، احترس،، تمثال القط الفرعوني يراقبك.
تاريخ الصين (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
ينقسم "التاريخ الصيني" إلى ثلاثة عصور: قديم وحديث ومعاصر، ويقوم الكتاب بتقديم وصف واضح لعملية تغييرات التنمية في التاريخ الصيني الذي امتد لآلاف السنين. ولا يتناول الكتاب الأحداث التاريخية فقط، بل يقوم أيضا بتقديم ملخص موجز لخصائص المراحل المختلفة للتاريخ الصيني، مما يسهل على القارئ فهم التاريخ الصيني بشكل عام.
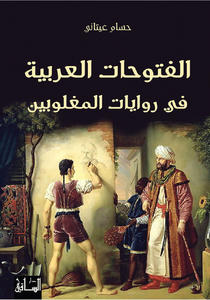
الفتوحات العربية في روايات المغلوبين
الفتوحات العربية حدث تأسيسي للتاريخ العربي - الإسلامي. لكن أصوات الشعوب المغلوبة غابت عن المدوّنة العربية غياباً كانت له تبعات سلبية على تشكيل صورة العرب والمسلمين عن أنفسهم. للمرّة الأولى، يقدّم كتابٌ باللغة العربية الروايات التي سجّلتها الشعوب المغلوبة عن الفتوحات، بالاستناد إلى المصادر الأصلية. ومن الإخباريين البيزنطيين إلى القساوسة الأقباط ورجال الدين الزرادشتيين والمؤرّخين الصينيين، إلى المدوّنين اليهود والرهبان الأسبان، ترتسم صورة مختلفة وجديدة للفتوحات العربية بصفتها حدثاً عالمياً. إن الفتوحات، بخروجها من أراضي الجزيرة العربية، تحوّلت إلى حدث متعدّد الأطراف، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من سكان البلاد التي قصدتها الفتوحات ظلّت على دياناتها واعتقاداتها الاجتماعية، كما احتفظت ببناها السياسية والاقتصادية في العديد من الأماكن التي وصلت جيوش الفتح إليها. وظهر بعد انحسار موجة الفتوحات من قدّم روايته للأحداث. يدعو هذا الكتاب إلى إعادة تقييم الرواية التقليدية العربية للفتوحات، وللتاريخ العربي -الإسلامي برمّته، وعرضها على النقد والبحث العلمي، كمقدّمة لازمة لإنتاج فهم حديث يساهم في التقدّم الحضاري وكسر القوالب الجامدة التي سجن العرب أنفسهم فيها، من جهة، وتلك التي دفعتهم إليها بعض مدارس الاسشتراق العنصرية، من جهة أخرى.
الرحلات العلمية بين مصر والمشرق الاسلامي في العصر المملوكي الاول

تاريخ الإسماعيليين الحديث
شهد الإسماعيليون تاريخاً طويلاً معقداً وحافلاً بالأحداث نشأ في التقليد الشيعي الإمامي من الإسلام وتعود بداياته إلى القرن الثامن الميلادي. وفي العصور الوسطى انقسم الإسماعيليون إلى جماعتين رئيسيتين اتبعت كلٌ منهما خطّاً مختلفاً من الأئمّة أو القادة الروحيين. وأصبح للقسم الأكبر من الإسماعيليين، وهم النزاريون، خطاً من الأئمّة يتمثّل في الأزمنة الحديثة بالآغاخانات، بينما خضع الإسماعيليون الطيبيون، المعروفين بالبهرة في جنوب آسيا، لقيادة دعاة (كانوا نواباً لأئمّتهم المستترين). تمثّل هذه المجموعة من الدراسات أول محاولة بحثية علمية لإجراء مسح شاملٍ للتاريخ الحديث لفرعي الإسماعيليين منذ منتصف القرن التاسع عشر. وهي تُغطّي، بالنسبة إلى الإسماعيليين النزاريين، قضايا موضوعية وموضوعات متنوّعة، كما تمّ تخصيص قسم مستقلّ للتاريخ الحديث للبهرة الطيبيين والتطوّرات التي حصلت ضمن هذه الجماعة. فرهاد دفتري مدير مشارك لـ"معهد الدراسات الإسماعيلية" في لندن. يمثّل مرجعاً في الدراسات الإسماعيلية. من إصداراته عن دار الساقي: "الإسماعيليون: تاريخهم وعقائدهم"، "تاريخ الإسماعيليين الحديث"، معجم التاريخ الإسماعيلي".
التركيب الاجتماعي الأردني: الاثني والديني
لا يختلف البناء الاجتماعي للمسلمين العرب في الأردن عن شركائهم المسيحيون في التاريخ والجغرافيا والعادات الأردنية، فالمسيحيون والمسلمون ينتمون إلى عشائر عربية تعود في أصولها إلى ما قبل الإسلام، ولم تكن الطائفة أو الدين النظام الوحيد الذي يحدّد العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، بل هي الأعراف القبلية والعشائرية، حيث إنَّ هذا الفئات المسيحية من السكان يرتبطون بالأحلاف والتقاليد الموجودة في كل بلدة من بلدات الأردن التي يوجد فيها مسيحيّون. أمّا المجموعات الاثنية من الشيشان، والشركس، والأكراد والأرمن وغيرها، فقد اندمجت في المجتمع الأردني وثقافته العامة المتمثلة بالحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف والمعايير الثقافية العامة، كما أنّها اندمجت على كافة الصعد بعد تحول نمط الإنتاج في الدولة عمومًا.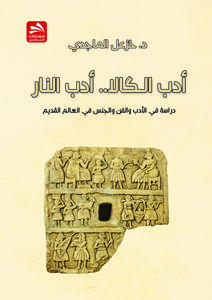
أدب الگالا.. أدب النار
هذا الكتابُ يضعُ، لأول مرة، أجناسية جديدة محكمة للأدب القديم كلّه من خلال دراسته لأدب وادي الرافدين الديني (گالا) والدنيوي (نار)، فهو يذكر أنواع ذلك الأدب بأسمائه القديمة ومدوناته ونصوصه البِكر، ولذلك يصحّ أن يكون منهجاً عاماً لتصنيف آداب التاريخ القديم عند كلّ الشعوب التي ظهرت فيه. وهو رحيلٌ إلى الماضي، وبحثٌ عن سعاداته المختزنة في الأدب والفنّ والجسد، وهي سعادات خصيبة ما زالت حيّةً تنبضُ بالشهوات التي تدفّقت في عروق الأنهار والجبال والإنسان والحيوان والأعشاب والحجر. كان الخصبُ يعني حقناً متّصلاً للكون بمصل الإيروس والجمال، وكان هذا المصلُ يفجّر الحياة في كلّ مسرًى يمرّ به . وتكاد فصول الكتاب الخمسة تتجانس في موضوعها الأساس الذي ينشغلُ بالأدب والفنّ، والذي ينهل من قاعٍ سريّ وخفيّ هو الجنس، وترفرفُ عليه من الأعلى طيور الأساطير. يقدّم لنا هذا الثالوث (أدب، جنس، أسطورة) قوة هائلةً قادرة على اختراق التاريخ الكرونولوجيّ والمرور من خلال تبدّلات الأحداث ونهضة الأمم والحضارات وسقوطها.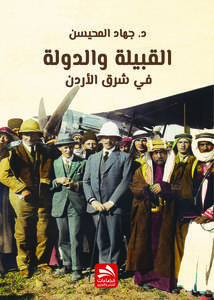
القبيلة والدولة في شرق الأردن
سعت الدراسة للإجابة عن عدد من الأسئلة، مثل: كيف تمكنت السلطة من استيعاب القبيلة؟ وهل كان هذا الاستيعاب أو الاحتواء تصادمياً أم اندماجياً؟ وكيف استطاع الأمير عبدالله المدعوم من بريطانيا أن يبلور مشروعه في تأسيس سلطة مركزية وتوظيف التناقضات التي يمليها قيام دولة في مجتمع قبلي؟ فمن سمات النظم السلطوية التقليدية أنها تحول عدداً من الزعامات التقليدية العشائرية من الحكم عن طريق القبول العرفي، إلى الحكم عن طريق جهاز دولة منفصل، وذلك دون التخلي عن الشرعية التقليدية لهذه الزعامات.
العرب: من مرج دابق إلى سايكس – بيكو (1916-1516)
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العرب: من مرج دابق إلى سايكس – بيكو (1916-1516) - تحولات بُنى السلطة والمجتمع: من الكيانات والإمارات السلطانية إلى الكيانات الوطنية، ويضم بين دفتيه بحوثًا منتقاة من التي قدمت في مؤتمر عقده المركز بالعنوان نفسه في بيروت، في 21 و22 نيسان/ أبريل 2017، ضمن مؤتمره السنوي للدراسات التاريخية. يتألف الكتاب (1280 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة بعنوان "من الدعوة للبحث إلى الاستجابات الممكنة" لوجيه كوثراني، ومحاضرة افتتاحية بعنوان "الدولة العثمانية وأوروبا" ألقاها خالد زيادة، مدير المركز - فرع بيروت، إضافة إلى 36 فصلًا، وُزّعت على سبعة أقسام. في مسألة الخلافة العثمانية جاء القسم الأول بعنوان "في مسألة الخلافة العثمانية: متى وكيف؟"، ويتضمن أربعة فصول. في الفصل الأول، "في إشكالية نسبة الخلافة إلى السلطنة العثمانية: بين التاريخ والأسطورة"، أسهم وجيه كوثراني في تفكيك قصة الخلافة ونسبتها إلى الأسرة العثمانية، مشددًا على خلو المصادر المعاصرة للسلطانَين سليم وسليمان من ذكر خبر تنازل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم؛ الأمر الذي يعني أن القصة وُضعت لاحقًا وفي سياق تاريخي اتّسم بظروف انهزام السلطنة في حرب القرم وانعقاد معاهدة كوتشوك كاينارسا وملابساتها ووطأة صوغ بنودها، حتى أسطرتها في سياسات عبد الحميد ونُخَب إسلامية على امتداد العالم الإسلامي. أما أحمد إبراهيم أبو شوك في الفصل الثاني، "الخلافة العثمانية في نصف قرنها الأخير (1874-1924): صراع السلطة وجدل المصطلح"، فيتعقب مصطلح الخلافة واستخداماته في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، ويتوقف عند استخدامات رشيد رضا ومواقفه من تطورات المسألة وتحولاتها. ثم يركز نور الدين ثنيو في الفصل الثالث، "سقوط الخلافة .. وبداية إشكالية ’القومي‘ و’الإسلامي‘"، على الدلالات السياسية والتداعيات المصيرية الكبرى لعملية سقوط الخلافة بوصفها إمبراطورية، وإلغائها في عام 1924، التي تجلت في ظهور وتكوّن تيارين سياسيين: الإسلامي والقومي. ويختم هذا القسم صاحب عالم الأعظمي الندوي في الفصل الرابع، "موقف مسلمي الهند من حركة الجامعة الإسلامية وتأثيرها في حركة الخلافة في الهند: دراسة تاريخية في ضوء المصادر الهندية والوثائق البريطانية"، بحديثه عن أن مسألة الخلافة أثارت حراكًا لافتًا، وربما أوسع، بين مسلمي الهند، فكان لها تأثيرها الحراكي في نشوء حركة الخلافة، كما يرى أن هذا الحراك ترك نمطًا معينًا من العمل السياسي حاول مسلمو الهند السير عليه قبل استقلال الهند وبعده. التاريخ العثماني والتواريخ العربية: المشرق والجزيرة في حين يضم القسم الثاني، "التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية في المشرق العربي والجزيرة"، ستة فصول. يفتتحه سيّار الجميل في الفصل الخامس، "كيف نقرأ تاريخ العرب الحديث 1516-1916؟ إعادة الرؤية في أبعاد التكوين"، ويقدم فيه إعادةً للرؤية في أبعاد تكوُّن هذا التاريخ؛ فتاريخ العرب في العهد العثماني ليس تاريخًا عثمانيًا، بل تاريخ العرب الذين احتفظوا بشخصيتهم الاجتماعية والحضرية والثقافية. ثم يشرح صبري فالح الحمدي في الفصل السادس، "أشراف مكة والعلاقة بالدولة العثمانية عبر التأريخ الحديث"، إشكالية العلاقة المركبة بين الأمير الشريف والسلطان، حيث يخترق مجال هذه العلاقة تجاذبات يقوم حراكها على التنافس بين الأمراء، من جهة، ومداخلات الولاة الوسطاء في جدة ومصر وبلاد الشام، من جهة أخرى. ثم تتخصص الفصول الأربعة التالية في دراسة حالات منتقاة من المنطقة المبحوثة، يبدؤها حسين بن عبد الله العَمري في الفصل السابع، "اليمن: ولاية عثمانية (1289-1337هـ/ 1918-1872م" في حديثه عن اليمن، ويعالج فيه دور الإصلاح والمقاومة بقيادة الإمام المنصور بن يحيى حميد الدين وابنه يحيى، حيث يعتبر اتفاق دعّان في عام 1911 ممهدًا لاستقلال ولاية اليمن في آخر الحرب العالمية الأولى. ثم عُمان، تناولها ناصر بن سيف بن عامر السعدي في الفصل الثامن، "نشأة الدولة في عُمان عام 1034هـ/ 1624م: دراسة في التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني"، مؤرخًا نشأة الدولة في عُمان، ومركّزًا على دراسة التحولات السياسية والاجتماعية في العهد العثماني، ومبرزًا على نحو أساسي طبيعة الأسس والمرجعيات التي قامت عليها شرعية النظام السياسي في عمان، مثل قيم الانتخاب والشورى ودور أهل الحل والعقد والعلاقة بين شيوخ القبائل وأهل العلم. أما العراق فجرت دراسته في الفصل التاسع، "الدولة الوطنية العراقية في عام 1921: جذور التأسيس العثماني"، حيث يقول فيه جميل موسى النجار إن تشكيل البريطانيين للدولة الوطنية العراقية لم يكن مصطنعًا لحدود سيادة وطنية، أي إفرازًا لسايكس - بيكو، بل كان ذلك مخاضًا لولادة دولة تكونت جغرافيتها السياسية في الرحم العثماني واتضحت معالمها في العهد الأخير من عهود الحكم العثماني في ولايات بغداد والبصرة والموصل. وأخيرًا وفي العراق أيضًا، يدرس نهار محمد نوري في الفصل العاشر، "النزعات العراقوية ومدلولاتها في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين: دحض فرضية الدولة المصطنعة"، نزعات البزوغ الهوياتي الجنيني الذي رافق حقبة الإدارة العثمانية لولايات العراق تاريخيًا. التاريخ العثماني والتواريخ العربية: البلدان المغاربية ينتقل القسم الثالث لتناول البلدان المغاربية، "التاريخ العثماني والتواريخ العربية المحلية في البلدان المغاربية"، ويتضمن ستة فصول. جاء أولها عن الجزائر في الفصل الحادي عشر، "الجزائر العثمانية في الذاكرة التاريخية: إشكالية السيادة الجزائرية في العهد العثماني"، ويطرح فيه ناصر الدين سعيدوني نظرة جديدة إلى إشكالية السيادة الجزائرية من خلال تجاوز التعارض المصطنع بين الخصوصية كأساس لتميز الدولة القُطرية والأخذ بالعوامل المشتركة التي تأسست عليها الرابطة العثمانية. أما لطفي بن ميلاد في الفصل الثاني عشر، "الغرب الإسلامي وموقفه إزاء صعود السلطنة العثمانية وحضورها في المتوسط 856-942هـ/ 1453-1535م (قراءة جديدة في جذور الاتصال ومواقف السلطة والنخبة)"، فيعالج إشكاليات السياسة العثمانية المبكرة في المتوسط عمومًا، متسائلًا عن حقيقة التدخل العثماني في غرب المتوسط وهدفه. في حين يتناول عبد الحي الخيلي في الفصل الثالث عشر، "أزمة المركز العثماني وإرهاصات تأسيس الدول المستقلة في البلدان المغاربية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر"، موضحًا أن الحماية العثمانية لشمال أفريقيا في الصراع العثماني – الإسباني لم تكن العامل الممهد للسيادات الوطنية، بل أزمة السلطة المركزية وبداية التراجع الفعلي للعلاقة بين الباب العالي والولايات المغاربية. ثم ينتقل محمد المريمي إلى الحديث عن البلاد التونسية في الفصل الرابع عشر، "البلاد التونسية والمرحلة الانتقالية بين عامي 1574 و1637"، ويعالج فيه إشكالية الانتقال السياسي في تونس من دولة حفصية استقرت أكثر من ثلاثة قرون تحت حُكُم أرستقراطية حفصية، إلى دولة البايات الذين أسسوا حكمًا شبه وطني. أما المغرب فدرسه أنيس عبد الخالق محمود في الفصل الخامس عشر، "العلاقات السياسية بين الدولة العثمانية والمغرب السعدي: دراسة في إشكالية ’التجاور - التبعية - الاستقلال‘ (1550-1603)"، ويفترض فيه أن الدولة العثمانية لم تكن لديها خطة أو نية واضحة لضم المغرب، بل كان كل ما تسعى إليه تحقيق أحد أمريْن: أن يخضع المغرب السعدي لسلطتها طوعًا، أو إقامة نوع من التحالف الذي يضمن احتواء المغرب وولاءه في ظل صراعها مع إسبانيا والبرتغال. ويختم صالح علواني في الفصل السادس عشر، "بلاد المغارب ما بين عامي 1518 و1920: مجال فريد لتقاطعات المحورين ’مشرق – مغرب‘ و’شمال – جنوب‘ وتأثيراتها الاجتماعية والسياسية والثقافية"، ويخلُص إلى أن الدول المغاربية بدأت تتشكّل مع نهاية القرن السادس عشر في رحم الصراعات والمبادلات مع الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وفي ظل الحضور الفاعل للسلطنة العثمانية وتأثيره في تشكيل التاريخ الحديث لكيانات مثل الإيالتين التونسية والجزائرية. عثمنة واستقلال وتغلغل غربي يأتي الحديث عن علاقة الغرب بالدول العربية في القسم الرابع، "جدل العلاقة بين العثمنة والاستقلال والتغلغل الغربي"، وفيه سبعة فصول. بدأه محمد مرقطن في الفصل السابع عشر، "الرحالة الغربيون والاكتشافات الأثرية في فلسطين والتمهيد للمشروع الصهيوني (1800–1914)"، بعرض المادة التاريخية التي تحتويها كتب الرحّالة والدوافع الحقيقية وراء رحلاتهم إلى فلسطين. ثم ينتقل ليث مجيد حسين في الفصل الثامن عشر، "خط سكة حديد برلين - بغداد: المطامع الاقتصادية والعلمية لألمانيا القيصرية في العراق"، للحديث عن التغلغل الألماني عبر مشروع سكة حديد برلين - بغداد – البصرة، ويقدم دراسة مركزة اعتمادًا على الوثائق الألمانية. في حين جاء الفصل التاسع عشر، "التغلغل الألماني في الدولة العثمانية من خلال الاستشراق: دراسة في الوظائف والأدوار في الربع الأخير من القرن التاسع عشر"، عن التغلغل الألماني أيضًا وفيه يحاول أمجد أحمد الزعبيد أن يربط ما بين الاستشراق الألماني والتغلغل السياسي - الاقتصادي مركّزًا على محاور من شأنها الاستدلال على خدمة الاستشراق للمصالح الألمانية من خلال صورٍ ومفاهيم وأنماطٍ من التفكير حول الشرق ودراسات حول المسألة الشرقية. وفي الإطار ذاته جاء الفصل العشرون، "الاستشراق والسياسة: أرمنيوس فامبيري والدولة العثمانية (مقاربة تاريخية)"، لزكريا صادق الرفاعي ويثير فيه إشكالية الدور الذي يقوم به بعض المستشرقين في خدمة السياسات الكولونيالية، فيدرس مثال المستشرق أرمنيوس فامبيري الذي استطاع عبر خبرته وقدراته على بناء شبكة علاقات واسعة مع أطراف العالم الإسلامي من آسيا الوسطى إلى إسطنبول، أن يوطّد علاقته المباشرة بالسلطان عبد الحميد. أما فدوى عبد الرحمن علي طه في الفصل الحادي والعشرين، "السياسة البريطانية في السودان (1821-1914): أساليب محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري وتصفيتهما في السودان"، فدرست كيف استطاعت بريطانيا محاصرة الحضور العثماني والنفوذ المصري في السودان بدءًا من عام 1921 حتى انتهى الأمر بانفرادها في حكمه، مستخدمةً أساليب سياسية وعسكرية ودبلوماسية، لا سيما بعد القضاء على ثورة المهدي. وفي السودان أيضًا، تحدّث قيصر موسى الزين في الفصل الثاني والعشرين، "التحولات بين التعريب الثقافي والتتريك العثماني في سياق سياسي متغير في أطراف العالم العربي: حالة السودان في الفترة 1504–1885"، وحاول البرهنة على أن التأثيرات التركية الثقافية والاجتماعية نتجت في الأساس من الاحتكاك السياسي - العسكري في الفترة التركية الأولى (قبل دخول محمد علي باشا السودان عام 1821)، في حين كانت الفترة الثانية (1821–1885) أكثر تأثيرًا وأوسع نطاقًا وعمقًا، ففيها دخلت مجموعة كبيرة نسبيًا من الأتراك بصيغة عسكريين ووظيفيين وأصحاب مهن. وتختم أمل غزال هذا القسم في الفصل الثالث والعشرين، "شمال أفريقيا من حرب طرابلس إلى الحرب العالمية الأولى: بين الاستقلال والاتحاد العثماني (وادي ميزاب مثالًا)"، بطرحها أبعادًا تتعلق بالتأريخ للحراك السياسي في بلاد المغاربة، كضرورة إيجاد سردية واحدة تربط بين الاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب عام 1911 ومجريات الحرب العالمية الأولى، وإعادة الاحتلال الإيطالي اهتمام الناشطين السياسيين المغاربة، وتحديدًا في الجزائر وتونس، بمسألة الاتحاد العثماني. السلطنة والمجتمع الأهلي العربي في حين يأتي القسم الخامس للحديث عن ما يمكن تسميته المجتمع الأهلي العربي، بعنوان "السلطنة العثمانية ومسائل من المجتمع الأهلي العربي"، في أربعة فصول. يبدأ فاضل بيات في الفصل الرابع والعشرين، "الزعامات المحلية العربية وتعامل الدولة العثمانية معها: رؤية جديدة في ضوء الوثائق العثمانية"، بتقديمه رؤية جديدة في ضوء الوثائق العثمانية عن أنماط الزعامات العربية وأساليب التعامل معها، معددًا زعامات كانت تتمتع باستقلال ذاتي في شكل حكومات، وزعامات ذات طابع ديني - سياسي، وزعامات ذات طابع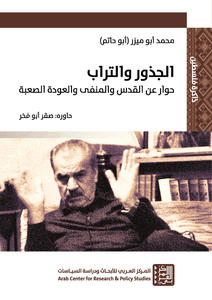
الجذور والتراب: حوار عن القدس والمنفى والعودة الصعبة
يندرج كتاب الجذور والتراب: حوار عن القدس والمنفى والعودة الصعبة، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في سياق الحوارات الفلسطينية التي تستعيد، من خلال رواية الذاكرة، محطات من التاريخ الفلسطيني المعاصر. وفي هذا الحوار، يتحدث محمد أبو ميزر (أبو حاتم) إلى صقر أبو فخر عن وقائع مهمة في حياته النضالية، ويروي تفصيلات أيامه منذ أن أطل على الدنيا في القدس حتى عودته الموقتة إليها بعد غياب قسري طال أربعين سنة. يسرد أبو ميزر بواكير وعيه السياسي، وقصة انتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ثم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتسلمه مهمات الإعلام ثم العلاقات الخارجية فيها. يكشف هذا الحوار كثيرًا من الزوايا الظليلة في تجربة حركة فتح، ويميط اللثام عن بعض الأسرار المتوارية استنادًا إلى التجربة الشخصية الطويلة لأبو حاتم في إطار الحركة، ثم يستعيد وقائع وحوادث وسِيَر أشخاص كان لهم الشأن البارز في الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. وعي سياسي وبعث عربي يتألف هذا الكتاب (236 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 14 فصلًا. في الفصل الأول، "البدايات والمؤثرات الأولى"، يتحدث أبو ميزر عن طفولته في الخليل، وانتقال العائلة إلى القدس بعد موت والده سليمان، ثم العودة إلى الخليل، فالعودة ثانية إلى القدس، وأثر هذا التنقل في نفسه، ثم بداية تفتح وعيه السياسي في القدس. ويسترجع أبو ميزر، في الفصل الثاني، "ذكريات الدراسة وبواكير الوعي القومي"، ذكرياته في حارة النصارى بالقدس، ودراسته في الكلية الرشيدية التي كانت المدرسة الثانية من حيث المستوى العلمي بعد الكلية العربية. أما في الفصل الثالث، "الوعي السياسي الجديد"، فيتذكر أبو ميزر كيف قاده وعيه السياسي في تلك الفترة إلى الانخراط في حزب البعث، حين كان النضال الوطني في ذروة توهجه، كما يقول، وكانت المعارك السياسية محتدمة جدًا على مستوى المواقف وعلى مستوى الأفكار، وحين كان مقتنعًا بعدم وجود مسألة تدعى قضية فلسطين منفردة، بل ثمة قضية العرب في فلسطين، و"كانت ثقافتنا تقول إن الهدف من احتلال فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين ليس فلسطين وحدها، وإنما تأسيس قاعدة للهيمنة على المنطقة العربية كلها". الثقافة واختيار البعث في الفصل الرابع، "مرض القدس"، يتحدث أبو ميزر عن عودته إلى القدس في عام 1997، بعد مرور أربعين عامًا على مغادرتها، وعن التغيير الهائل الذي شهده في المدينة بعد هذه المدة الطويلة، إلا القدس القديمة التي، في نظره، "لم يطرأ عليها أي شيء، ولم أكتشف أي جديد إلا المصلّى المرواني الذي لم أكن أعرفه. وقد أيقظت زيارتي تلك ذكريات قديمة. صدقني أنني شعرت بهراوات الشرطة تنزل على أكتافي وعلى رأسي". ويعود أبو ميزر، في الفصل الخامس، "الثقافة والمكان"، إلى أول الكتب التي قرأها، إلى بداياته الفكرية. يقول: "لم نقرأ لا التوراة ولا الأناجيل، ولم نقرأ أي شيء يتعلق بالعدو الصهيوني، فقد كانت القراءة عن إسرائيل محرمًا من المحرمات. وكان محرمًا حتى الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية. قرأنا عن مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل وعن كتاب دولة اليهود، لكن من شبه المحال أن نعثر على مَن قرأ بالعربية كتابه دولة اليهود قبل عام 1975"؛ فالثقافة العامة والاتجاه الوطني العام حرما قراءته. كما تطرق إلى الشخصيات الفلسطينية التي كانت تمثل قدوة في تلك المرحلة، مثل بهجت أبو غربية وجميل أبو ميزر وتوفيق أبو السعود والأنبا ياكوبس وعبد الله نعواس وعبد الله الريماوي. أما الفصل السادس، "البعث"، فكان مجالًا يتذكر فيه أبو ميزر انضمامه إلى حزب البعث، والمؤثرات التي ساهمت في بلورة وعيه السياسي الذي جعله يختار هذا الحزب. الفتح بعد البعث في الفصل السابع، "القاهرة"، يتذكر أبو ميزر لقاءه بميشيل عفلق في القاهرة في عام 1959، وعلاقاته بالبعثيين، وتعرفه بأكرم الحوراني في باريس، وعلاقته بحركة القوميين العرب. ويسترجع أبو ميزر، في الفصل الثامن، "المرحلة الجديدة"، ذكرياته في أيام العدوان الثلاثي على مصر، وعلاقته ضمن رابطة الطلاب الفلسطينيين حين كان طالبًا بعثيًا ثم حين صار ممثلًا لحزب البعث فيها. ويتحدث عن عدم أهمية مسألة الانتماء الإثني أو الطائفي آنذاك. ويقول أبو ميزر، في الفصل التاسع، "الفتح بعد البعث"، إنه ترك البعث لأنه كان ضد انفصال سورية عن مصر الذي أيده بعض البعثيين أمثال أكرم الحوراني وصلاح البيطار، وبسبب خيبته من موقف قيادة حزب البعث التي تخلت عنه حين اتهمته السلطات الملكية الليبية بالتخطيط لانقلاب ضد الملك، ويتذكر أنه سمع بـحركة فتح أول مرة في الكويت في عام 1962، من فاروق القدومي، ويتحدث عن لقائه بياسر عرفات، ثم انضمامه إلى الحركة. حساب الجُمّل في الفصل العاشر، "حساب الجُمل والأفكار القيامية"، يركز أبو ميزر كلامه على محمود أبو الفخر، الذي كان متدينًا ومحترمًا، ومهتمًا بتحليل الحوادث من خلال الأرقام والآيات القرآنية، أو حساب الجمل الذي من خلاله حدّد تاريخ انهيار إسرائيل، واليوم الذي ستنهار فيه، والساعة التي ستنهار فيها أيضًا، وحددها في عام 1974. كما يتذكر تفصيلات علاقته بحركة فتح، ونشوء هيكلها الثوري في عام 1962، وانطلاقتها المسلحة. ويتحدث أبو ميزر، في الفصل الحادي عشر، "التجربة الجزائرية"، عن علاقته بالثورة الجزائرية وافتتاح مكتبي فتح وفلسطين في الجزائر، والأثر الإيجابي لانقلاب هواري بومدين في علاقة فتح بالسلطة الجزائرية. أما الفصل الثاني عشر، "من الجزائر إلى دمشق: الانغمار في الثورة الفلسطينية"، فيعود فيه أبو ميزر بالذاكرة إلى انتقاله من الجزائر إلى دمشق، وتوليه مسؤولية العلاقة بالجزائر والعراق وسورية، وتأليف اللجنة المركزية الأولى لحركة فتح، واندماج الهيئة العاملة لدعم الثورة الفلسطينية – أو تنظيم عصام السرطاوي – في فتح. بيان الدولة الديمقراطية في الفصل الثالث عشر، "باريس والدولة الديمقراطية العَلمانية"، يتحدث أبو ميزر عن أيامه في باريس في سنة 1968 في خضم ثورة الطلاب التي ساهمت في تأسيس اليسار الأوروبي الجديد ومفاهيمه الثورية، وكان أول ممثل لحركة فتح في أوروبا، وأسس في باريس "اللجنة العربية من أجل فلسطين". كما يتذكر صوغه إعلان "الدولة الديمقراطية الفلسطينية" وتسليمه إلى وكالة الصحافة الفرنسية التي نشرته في 31 كانون الثاني/ ديسمبر 1968، وإشكالية كلمة "العلمانية" التي وردت فيه. ويتذكر أبو ميزر، في الفصل الرابع عشر والأخير، "العودة إلى المشرق"، مغادرته باريس في خريف 1969، ومعارك أيلول/ سبتمبر 1970، وموقفه الرافض للعمليات الخارجية التي نفذها وديع حداد وأيلول الأسود، وتدفق المقاتلين الفلسطينيين من الأردن إلى لبنان، ومسألة الانشقاقات في فتح، ومساهمته في سنة 1972 في تأليف "الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية" التي كان يقودها كمال جنبلاط.
المستوطنات الصهيونية في محافظة أريحا والأغوار
من الكتاب: مدينة أريحا مدينة كنعانية قديمة، يعدها الخبراء الأثريون أقدم مدن فلسطين، ويرجعون تاريخها إلى العصر الحجري، إلى عشرة آلاف عام قبل الميلاد، وأطلالها موجودة في تل السلطان على بعد كيلو متر شمال المدينة الحالية. وتسمية مدينة أريحا يعود إلى أصل كنعاني وهي تعني القمر، (يقول وليام هاولز في كتابه "ما وراء التاريخ": إنَّ أريحا العتيقة كان لها بالفعل كل خصائص المدينة الحقيقة. لذلك اعتبرت أريحا أقدم مدينة في التاريخ)، (ويقول غولاييف في كتابه "المدن الأولى": كانت مساحة أريحا في الألفين الثامن والسابع قبل الميلاد تصل إلى 4 هكتارات، وعدد سكانها يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف نسمة، وكانت ذات مساكن متراصّة من الطين، ومحاطة بسور حجري عالٍ (حتّى 4.5 متر) يصل سمكه إلى (1.7متر). وعُثر على برج حجري، قطره (9 أمتار) وارتفاعه (9 أمتار أيضا). وكانت البلدة محاطة علاوة على السور بخندق عرضه (8 أمتار) وعمقه (2.6 متر).
جزر دياويو (سلسلة المحيط في الصين) (باللغة العربية)
"جزر دياويو" يشمل المحتوى الرئيسي للكتاب تسعة موضوعات: التعرف على جزر دياويو وقيمتها، لماذا تنتمى جزر دياويو إلى الصين، كيف انتزعت اليابان جزر دياويو من الصين، وجوب إعادة جزر دياويو للصين بعد الحرب الثانية، "وصاية" أمريكا تدفن جذور الحادثة، التفاهم المتبادل حول اتفاق "وقف النزاعات"، من يقوم بـ "تغيير الوضع الراهن"، الجهود المبذولة لحماية حق سيادة الصين على جزر دياويو. من خلال عرض هذه القضايا يحاول الكتاب عرض مشكلة جزر دياويو بشكل كامل ومن جميع النواحي ، لتوضيح الحقائق التاريخية والأساس القانوني لانتماء جزر دياويو للصين. ونقد رأى وموقف اليابان الذى لا أساس له من الصحة واستفزازها الغير قانوني، وكشف الحقيقة للجميع، ووضع الأمور في نصابها.
تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثة
هذا الكتاب عبارة عن محاضرتين ألقاهما «عيسى إسكندر المعلوف» بالمعهد الطبي في دمشق سنة ١٩١٩م، تناول فيهما تاريخ الطبِّ منذ نشأته بدءًا من المصريين القدماء الذين ابتدعوا التحنيط، وأظهرت آثارهم صورًا لأقدم الجراحين والأطباء، مرورًا بالعبرانيين، الفُرس، الهنود، الصينيين، الترك، الأحباش، وصولًا إلى اليونانيين الذين اشتهر منهم «أبقراط» أبو الطب، والذي فصل الطب عن الدين، ووضع عددًا كبيرًا من المؤلفات المؤسِّسة لعلم الطب، ثمَّ يعرِّج المؤلف على الطب عند الرومان، ثمَّ في عهد المسيحيين والمسلمين. ويُتبِع المعلوف هذا العرض التاريخيَّ الثريَّ بملحق يوضِّح تعريف الطب وأقسامه وأصوله، وأهمَّ اصطلاحات العلوم الطبية، كما يشرح الأهمية التي تنطوي عليها دراسة الطبِّ والتشريح.
روح الثورات والثورة الفرنسية
يوحي عُنوان الكتاب بأنه ليس مجرد سرد تاريخي للثورة الفرنسية بوصفها عارضًا تاريخيًّا أو انقلابًا سياسيًّا، بل رؤية عميقة لفلسفة الثورة من حيث كونها ظاهرة اجتماعية نابعة من نضج معرفي يتنامى بشكل لا شعوري، فنفذ الكتاب إلى ما يكمن وراء الضجة من أخلاق ومشاعر ورؤية الجماعات والخلايا الثورية؛ ففنَّد أطوار الثورة وما يعتريها من تقلبات داخل ضمير الأمة الثائرة متَّخذًا من الثورة الفرنسية عينة مجهرية؛ فكانت رؤيته التاريخية أكثر صدقًا وأنفذ بصيرة، حيث ناقش الثورة باعتبارها عقيدة في نفوس الثائرين قد تتآلف وتتنافر مع كثير من المبادئ الاجتماعية والعقائد الدينية.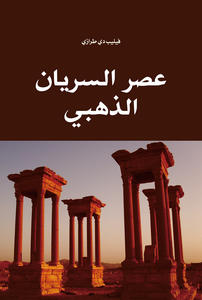
عصر السريان الذهبي
لا يستطيع أيُّ منصِف أن يتحدث عن تاريخ الحضارات دون أن يذكر دور السريان ولغتهم التي لُقِّبَتْ ﺑ «أميرة الثقافة وأم الحضارة»، فكانوا بمثابة القنطرة التي عبرت عليها العلوم والمعارف لتصل إلى العرب وأوروبا؛ فترجموا من اليونانية إلى السريانية، ومنها إلى العربية، ثم إلى اللاتينية، وأخيرًا للغات الأوروبية الحديثة. ولم يكن السريان مجرَّد نَقَلة، بل كانوا مبدعين أيضًا؛ فقد أضافوا خبرتَهم ومعارفهم، فطوَّروا وجدَّدوا. وكتب السريانُ في عدة موضوعات منها: الفلسفة، والمنطق، والموسيقى، والأدب، والهندسة، والزراعة، والتجارة، والطبيعة، والرياضيَّات، والفلك، والفيزياء، والطب. وكان منهم مَن يشار إليه بالبَنَانِ، مثل «حنين بن إسحاق العبادي» الذي ترجم تسعة وثلاثين مخطوطًا من اليونانيَّة إلى العربيَّة، وترجم خمسة وتسعين مخطوطًا من اليونانيَّة إلى السريانيَّة. لقد كان السريان حلقة في مضمار الحضارة العالمية.
الحقائق الأصلية في تاريخ الماسونية العملية
ما إن تذكر الماسونية في أي حديث حتى يتداعى إلى ذهن السامع سيلٌ من المؤامرات الكبرى والخطط السرية التي يحيكها رجال غامضون يسكنون الأقبية المظلمة ويهدفون للسيطرة على البلاد والعباد، وفي أحيان أخرى يثير الحديث عنها السخرية والتهكم باعتبارها إحدى «نظريات المؤامرة» الخيالية التي لا توجد إلا في عقول أصحابها، ولكنها في الحقيقة لم تكتسب سمعتها السيئة إلا بعدما أحاطت أنشطتَها بستار كثيف من الغموض والكتمان، بالإضافة لاستخدامها الكثير من الرموز والممارسات الغريبة، ناهيك عن الاختبارات المعقدة التي يجب أن يجتازها أعضاؤها، بشكل يصعب معه التصديق بأن هدف محافلها الأهم هو نشر السلام العالمي وروح الإخاء بين البشر. على أيِّ حال، سنترك قناعتنا عن الماسونية جانبًا (ولو قليلًا) لنطالع في هذا الكتاب على لسان أحد المتحمسين لها بعضًا من تاريخها وتقاليدها.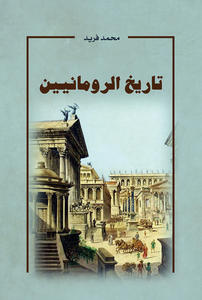
تاريخ الرومانيين
يتناول هذا الكتاب التاريخ الإنسانيَّ للدولةِ الرومانية، وقد أخرجه الكاتب إيمانًا منه بالدور التثقيفيِّ والتهذيبيِّ الذي تلعبه دراسة التاريخ في إثراء حياة الشعوب؛ حيث يقف القارئ من خلال تجوُّله في أروقة التاريخ على أسباب ارتقاء الأمم. وقد نجح الكاتب في استشراف الملامح التاريخيَّة للدولة الرومانيَّة، فتحدَّث عن تاريخ مدينة روما وأشهر الملوك الذين اعتلوا عرشها، كما تناول السجايا والطبائع التي وُسِموا بها، والحروب التي خاضوها، وآراء المؤرِّخين فيهم، ثمَّ تحدَّث عن الأسباب التي أدَّت إلى إلغاء الملكية وإقامة الجمهورية، وما صاحب ذلك التحوُّل من أوهامٍ وخرافاتٍ نسجتها مُخيلة أهل روما، كما تحدَّث عن العادات والتقاليد التي أُثِرَت عن الشعب الروماني، ومدى هيمنة التأثير الإغريقي على معتقداتهم الدينية، وتحدَّث كذلك عن الحروب والمعارك التي شهدتها روما، مُنهيًا وثيقته التاريخية بذِكر زوال مُلْك قرطاجة.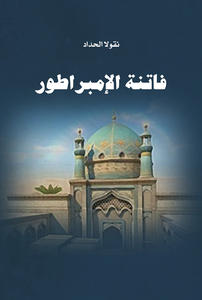
فاتنة الإمبراطور
الإمبراطور «فرانسوا جوزيف» الذي حكم النمسا زهاء ٦٨ عامًا حتى وفاته عام ١٩١٦م، وعرفه الناس ملكًا طيبًا مسالمًا، قضى حياته عاشقًا لـ «كاترين شراط» الممثلة الحسناء التي فتنته عن زوجته وابنه وريث عرشه. يروي لنا «نقولا حدَّاد» كيف أوغلت الفاتنة في القصر، وقد أتته أول مرة بائسةً متوسِّلةً، تحمل بين يديها عريضةَ استرحامٍ ترفعها للإمبراطور ليعفو عن أخيها المتَّهَم بإهانته، واستطاعت بعد تلك الحادثة أن تحصل على ما هو أثمن من رحمة جوزيف؛ قلبه وماله. أحداث الرواية تجسِّد فصول ذلك الصراع الذي احتدم بين الإمبراطور وعشيقته من جهةٍ، وبين الإمبراطورة الشرعية ووصيفتها من جهةٍ أخرى، في حكاية تاريخية ذاعَ شقُّها الغراميُّ في البلاط النمساوي، حتى أطلقوا على إمبراطورهم ذاك اسمَ «شراط» تيمُّنًا بعشيقته.
النسر الأعظم
عديد من المؤلَّفات التاريخية تناولت – وما زالت تتناول – عهد نابوليون بونابارت الأول؛ إمبراطور فرنسا، رجل الدولة الحاذق، والمحارب الداهية الذي تُدرَّس حملاته العسكرية في المدارس الحربية حول العالم، وفي هذا الكتاب يسلِّط «يوسف البستاني» الضوء على جوانب مثيرة من حياة ذلك النسر ذي الجناحين الضافيين، واللذين يخبِّئان في طياتهما شخصيةً فيها من الرِّقة والحزم ما فيها. يصحبنا المؤلِّف في رحلة تبدأ بمولد نابوليون في بيتٍ عانى أوضاعًا مادِّيَّة سيِّئة، ثمَّ نرى كيف أخذ منحنى حياته بالتغير إثر التحاقه بمدرسة باريس الحربية، فسرعان ما تحوَّل الفتى الفقير إلى جنرال مهيب، وقع في غرام جوزفين زوجته الأولى، ولم يكن ثقل الأعباء الملقاة على عاتقه يمنعه من أن يكون زوجًا وأبًا مُحبًّا، وبين الحبِّ والحرب كانت انتصارات النسر وانكساراته صفحة من صفحات التاريخ جديرة بالقراءة والتأمل.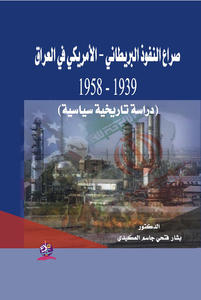
صراع النفوذ البريطاني – الأمريكي في العراق
ارتأينا التطرق إلى هذا الموضوع في هذه الدراسة التي حملت عنوان (صراع النفوذ البريطاني الأمريكي في العراق 1939-1958 دراسة تاريخية سياسية). وهدفنا من خلالها التعرف على ميادين وأسباب الصراع الخفي الذي كان دائراً بين كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية للاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه من مقدرات العراق وخلال حقبة محددة من تاريخه المعاصر.
الحملات الاستعمارية الأوروبية على الشرق العربي الاسلامي في العصور الوسطى
صدر عن دار الجندي للنشر والتوزيع (القدس) كتاب “الحملات الاستعمارية الأوربية على الشرق العربي الإسلامي في العصور الوسطى، للمؤلف د. أشرف صالح محمد، من الحجم المتوسط في (177) صفحة، ويتناول الكتاب عددًا من الدراسات المتخصصة في تاريخ الحملات الاستعمارية الأوربية على الشرق العربي الإسلامي.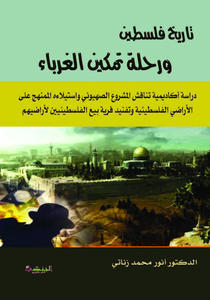
تاريخ فلسطين و رحلة تمكين الغرباء

إتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا
كتاب تأريخى كتبه المؤرخ المصرى تقى الدين المقريزى عن تاريخ الفاطميين. بيعتبر الكتاب ده اكمل مصدر عن التاريخ الفاطمى. إبتدا فيه المقريزى بالتأريخ لأصل الفاطميين و مشكلة نسبهم و قيام دولتهم فى المغرب و خلفائها الاربعه هناك. و بعدين اتكلم عن دخول الفاطميين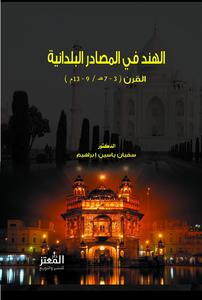
الهند في المصادر البلدانية
تهدف الدراسة الى معرفة مدى دقة المعلومات الواردة في المصادر البلدانية حول الهند ، وتلك التي اغفلتها ولم تشر اليها بينما ذكرت في المصادر التاريخية كما تهدف الى توظيف النصوص الواردة في المصادر البلدانية بصفتها مصدراً للتاريخ الحضاري للهند ووفق منهج تاريخي وصفي وتحليلي .
عصر العرب الذهبي
لقد بلغت الأمة العربية والإسلامية من النهضة العلمية في «عصرها الذهبي» مبلغًا وصلت لأمم العالم جميعًا أخباره، ونهلت من علومه وفنونه. في حين كانت نهضة الأمم وحياة الشعوب موقوفة على ملوكها وحكامها، بنى العرب نهضتهم مستندين إلى تاريخهم ولغتهم ودينهم، فنبغوا في الطب، والفلك، والهندسة والرياضيات، والفلسفة، والرسم، وغيرها من المعارف، وأسسوا لكثير من العلوم، بجانب عبقريتهم في الأدب والشعر والترجمة، فغدوا أعظم الأمم، وأنفعها للعالم، وأراد الكاتب بهذا العصر هنا عهد الخليفة العباسي «هارون الرشيد»، والتي أضحت دولته في ذلك الوقت تضاهي ممالك الفرس والروم في عزِّها واكتمال شملها.
عصر المأمون
يعتبر عصر المأمون من أزهى العصور في تاريخ الحضارة الإسلامية، وذلك في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والعلمية والأدبية، فقد استطاع المأمون أن يطيح بأخيه الأمين في الصراع على سدة الحكم بعد وفاة والدهما هارون الرشيد، وأن يوحِّد أركان الدولة الإسلامية، ويخضعها لحُكمه ويقضي على كافة جيوب التمرد داخلها، وقد عُرف المأمون برجاحة عقله، وحبه للعلم والعلماء، حيث تبحَّر في الفلسفة وعلوم القرآن، كما درس الكثير من المذاهب، حتى قيل عنه إنه لو لم يكن المأمون خليفة لصار أحد علماء عصره! ولكن إن خسرت الحضارة الإسلامية المأمون عالمًا، فقد كسبت مقابل ذلك كثيرًا من العلماء، حيث كان المأمون حريصًا على رعاية العلماء وتوفير كل ما يحتاجونه، كما اهتم ببناء المكتبات والمستشفيات، وشجع على نشر العلم، كل هذه الأمور كانت كفيلة بأن تدفع المؤرخ أحمد فريد الرفاعي إلى التأريخ لهذا العصر المزدهر، وبيان ما كان فيه، على التفصيل والإجمال، خاصة وأن التاريخ الإسلامي — بشكل عام — ما زالت تعوزه المصادر الجادة كما يعوزه التنظيم والترتيب والتحقيق والاستقراء، فما بالنا إذا تعلق الأمر بفترة هامة كهذه من تاريخ الحضارة الإسلامية.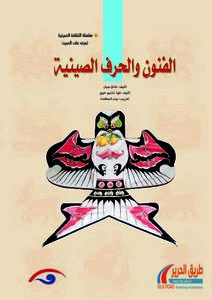
الفنون والحرف الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
لسماء زمان وللأرض حيوية وللمواد جمال وللعمل إبداع. الفنون والحرف الصينية تتمتع بشهرة غير مسبوقة في تاريخ الحضارة المادية بين مختلف الأمم في العالم. ولعدة آلاف من السنين كانت الحرف اليدوية الشعبية في تطورها كصدى لإيقاع الحياة في الصين القديمة والحديثة في ظل مقولة الصينيين الشهيرة "العمل مع شروق الشمس والراحة مع غروبها" . والصين التي تغزو منتجاتها اليوم كل شبر في أرض المعمورة ليس تفوقها الحالي وليد اللحظة بل له خلفية تاريخية من الإبداع الفني والحرفي تعود لآلاف السنين، وحيث أن كل أنواع الحرف اليدوية في أبكر حالاتها ترتبط بالاستخدام وهي دائما عملية وبسيطة ودافئة، وتتركز عظمتها في امتلاك الحكمة التي تتكيف مع الحضارة الزراعية. وحتى أروع الحرف اليدوية في البلاط الإمبراطوري الصيني قديما وبين النخبة من البشر مثل التقاليد البسيطة ما زالت باقية حتى اليوم وتكشف عن لمسات لآثار واقعية. كل ذلك يرتبط بالثقافة الزراعية الصينية الدائمة وموقعها الجغرافي الفريد الذي خلف لنا تراثا ثقافيا غنيا يحتوى على حكمة الحياة وإبداع الإنسان .فإذا كنت منبهرا بالتقدم الصناعي لصين اليوم فتعال معنا إلى هذا الكتاب الذي سيزيد انبهارك بصين الأمس ويجعلك متفهما لسر تقدم الصين.
التاريخ لا يُنسى: انتقاد المبعوثين الصينيين لزيارة رئيس وزراء اليابان ضريح ياسوكوني
في 26 ديسمبر 2013 قام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيارة ضريح ياسوكوني علنا. في 21 ابريل 2014 بدأت فعاليات مهرجان الربيع بضريح ياسوكوني والتي استمرت لثلاثة أيام، وقام رئيس الوزراء شينزو آبي وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتقديم القرابين. إن حكومة آبي تحاول جاهدة إحياء النزعة العسكرية، لتتحدى علنا النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تعرضت للإدانة بشدة من قِبل المجتمع الدولي، فأصبحت مشكلة ضريح ياسوكوني محط اهتمام الرأي العام الدولي مرة ثانية. يكرم ضريح ياسوكوني 14 مجرم حرب من الدرجة الأولى في الحرب العالمية الثانية من بينهم هيديكي توجو، وهو زمر لتوسع العدوان العسكري الياباني خلال الحرب العالمية الثانية. إن الموقف الذى تبنته اليابان بشأن ضريح ياسوكوني يتضمن ما إذا كانت اليابان تفهم بشكل صحيح وتتأمل بعمق تاريخ عدوانها. وقد لاقت زيارة الساسة اليابانيون لضريح ياسوكوني مشاعر الغضب والكراهية لدى الدول الآسيوية ووصفوها بأنها "زيارة الأشباح". فزيارة آبي لضريح ياسوكوني تلحق أكبر أذى بمشاعر شعوب كل الدول التي عانت من العدوان العسكري الياباني وحكمه الاستعماري، وطريقها المعاكس هذا يثير الحذر الشديد والمخاوف القوية لدى الدول الآسيوية والمجتمع الدولي بشأن اتجاه التنمية المستقبلية في اليابان. من أجل ردّ ضربة قوية لسلوك آبي الشائن بزيارته لضريح ياسوكوني، وفضح النوايا السيئة للقوى اليمينية اليابانية في محاولتها لتجميل تاريخ عدوانها العسكري، واستعادة الحقيقة التاريخية، وكسب تأييد الرأي العام العالمي للصين والدول المتضررة الأخرى، كتب المبعوثون الدبلوماسيون الصينيون بالخارج في وسائل الإعلام المحلية مقالات تعبر عن موقف الصين. هذه المقالات تكشف للمجتمع الدولي حقيقة مشكلة ضريح ياسوكوني وجذور مشكلة التاريخ بين الصين واليابان، وتكشف أيضا خطر زيارة آبي للضريح وسياسة اليمين المحافظ على أمن وسلام منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم كله، كما تحث القوى اليمينية في اليابان برئاسة آبي على مواجهة التاريخ، ووقف الاستفزاز والتخلي عن النزعة العسكرية. وقد قمنا بتجميع أكثر من 60 مقالا عن انتقاد المبعوثين الدبلوماسيين الصينيين لزيارة رئيس الوزراء الياباني ضريح ياسوكونى ونشرها في كتاب بسبع لغات (الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، العربية واليابانية).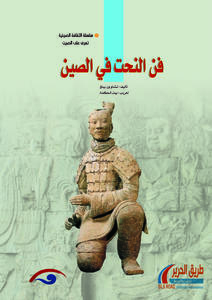
النحت الصيني (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
شتهرت أغلب الحضارات القديمة بمنحوتاتها التي ظل بعضها باقيا حتى يومنا هذا، وفي عالمنا العربي خلفت لنا الحضارة المصرية العديد من المنحوتات الحجرية التي ظلت شاهدة على حضارة الفراعنة العظماء، ولكن ماذا نعرف عن تاريخ وإبداعات فن النحت الصيني؟ فقد تطور فن النحت الصيني منذ آلاف السنين، وقد تشكلت أساليبه المتميزة خلال التقلبات الزمنية والتغيرات الثقافية، بما يعكس مقاييس الجمال والمفاهيم الثقافية الخاصة للصينيين. يعتبر تاريخ تطور النحت الصيني تاريخا لتطور الثقافة التقليدية ومفاهيم علم الجمال عند الصينيين، كما هو دليل ملموس على التبادل الثقافي بين قومية هان والقوميات الصينية الأخرى وكذلك دول العالم الأخرى. والمنحوتات الصينية متنوعة بين الحجرية والنحاسية والخشبية وإن كانت المنحوتات الخشبية هي الطاغية عليها والأكثر جمالا وإبداعا، فدعنا عزيزي القارئ نأخذك لرحلة داخل حضارة الخشب الصينية لتتعرف على مقومات الجمال عند الصينين قديما وتشهد جانبا من عظمة الحضارة الصينية.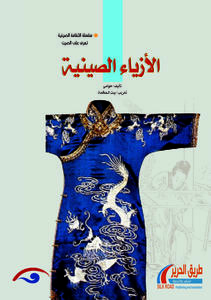
الأزياء الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
عتاد الصينيون منذ القدم في ثقافتهم على أن يعتبروا الضروريات الأساسية للحياة اليومية هي الملبس والمأكل والمسكن والعمل، وقد جعلوا الملبس بين هذه اللوازم الأربعة في المقام الأولى، والأزياء بلا شك تلعب دورا مهما جدا ومؤثرا في حياة الصينين. والصين تعد دولة للأزياء ذات تاريخ قديم وعريض في تصميم الأزياء والاهتمام بكل تفاصيلها، ويذخر التاريخ الصين بسجلات عديدة تؤرخ لمراحل تطور صناعة الأزياء وثقافتها عند الصينين كما أنه مازال باقيا حتى اليوم الكثير من الملابس الأثرية التي تعبر عن ثقافة كل عصر من عصور التاريخ الصيني، ومع تمازج القوميات الصينية وتنوعها في ذات الوقت، تميزت الأشكال والألوان والتصميمات بين قومية وأخرى وبين مكان وأخر، والأزياء من الملامح الثقافية التي يعتز بها الصينيون منذ القدم وحتى يومنا هذا، و مازالت من أهم مظاهر التمييز بين كل جماعة وغيرها وبين كل قومية وغيرها من القوميات، وإذا استعرضنا الأزياء الصينية في القرن العشرين، نجد كثيرا من الأنماط والأشكال، حيث لكل مكان ومحفل زيه الخاص الذي يحرص الصينيون على ارتدائه، وفي هذا الكتاب نتعرف على كل أشكال الملابس عند الصينيون ونتفهم منها ملامح الثقافة الصينية كما نستكشف بعدا جديدا من ابعاد الحضارة الصينية التي ظلت بعيدة عنا حتى وقت قريب.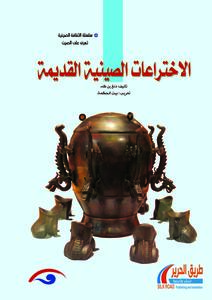
الاختراعات في عصور الصين القديمة (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
تعتبر الصين منبعا هاما من منابع الحضارة البشرية، وقد ظهرت بها حضارة علمية وتكنولوجية مشرقة في عصورها القديمة، وتقدمت على دول العالم الأخرى في الأغلبية الساحقة من عصور التاريخ. انبثقت العلوم والتكنولوجيا الصينية المتنوعة من الاكتشافات والبحوث الدقيقة، وشكلت مفهوم «التناغم بين الطبيعة والإنسان»، بما أغنى حضارة الأمة الصينية وقدم إسهامات بارزة للبشر. ويمكن القول إن الاختراعات في عصور الصين القديمة موضوع بلا نهاية وكنز فيه نفائس لا تحصى، ولعلك عزيزي القارئ سوف تندهش عندما تعرف من خلال هذا الكتاب حجم وعدد الاختراعات والاكتشافات التي قدمتها الحضارة الصينية للبشرية والتي مازلنا نستخدمها حتى الآن ويكفي أن تعرف ان صناعات الورق والكتابة والطباعة والبارود أيضا هي اختراعات صينية خالصة تحتفظ الصين بحقوق ملكيتها الفكرية قبل أن يكون هناك ما يسمى بالثقافة الغربية التي سطت على الكثير من إبداعات الثقافات الشرقية بما فيها حضاراتنا العربية وأيضا الحضارة الصينية التي تقف معنا في نفس الجانب منذ القدم وحتى الآن..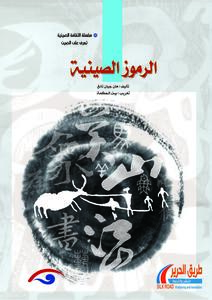
الرموز الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
يقدم هذا الكتاب الشيق عرضا موجزا عن المعارف الأساسية لثقافة الرموز الصينية العظيمة من خلال الكلمات السلسة والبسيطة والصور الجميلة بما يتسنى للقراء الأعزاء الحصول على بعض المعارف عنها دون أن يأخذ منهم وقتا طويلا، حتى سيخيل للقارئ الكريم عند القراءة أنهم يقومون برحلة ممتعة في «مملكة الرموز الصينية الفريدة». وأن الرموز الصينية الآتية من أعماق التاريخ راحت تأخذ طريقها مرفوعة الرأس نحو مستقبل مشرق. وبالنسبة للقارئ العربي الذي دائما ما يشغله تساؤلات عدة مثل: ماهي الرموز الصينية ؟ وهل هي رسوم؟ أم أحرف؟ أم مقاطع متراكبة؟ وهل لهذه الرسوم دلالة على معانيها؟ من أجل الرد على كل هذه التساؤلات نقدم لك عزيزي القارئ هذا الكتاب الذي سيأخذك لعالم اللغة الصينية الساحر ورموزها الشيقة التي ستكتشف خلفها الكثير والكثير من الحكايات.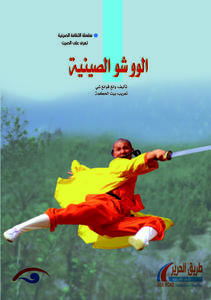
الوو شو الصينية (سلسلة الثقافة الصينية)
تشتهر الصين منذ القدم بين كل شعوب العالم برياضات الدفاع عن النفس والفنون القتالية العالية، وتعتبر هذه الفنون القتالية من ملامح الثقافة الصينية التي تعكس طريقة تفكير الصينيين منذ القدم وتبلور لجوهر الثقافة الصينية التقليدية، كما أن الفنون القتالية عند الصينيون هي انعكاس للنفسية الوطنية في مجال اللياقة البدنية للدفاع عن النفس. وإذا تناولنا رياضة الووشو كمثال من ضمن الفنون القتالية الصينية نجد أنها تمثل الجوهر الفلسفي للفكر للصيني وهي جزء عملي يعكس الكثير من تعاليم الكونفوشية مع دمج نظريات من الطاوية والبوذية فيها، فهي ليست رياضة فحسب بل تحوي خليطا من التعاليم الثلاثة الأكثر انتشارا بين الصينين، وتشكل بذلك نظام الووشو الكامل ليكون بمثابة «ثقافة الووشوو» الفريدة في العالم التي تتميز بها الصين وتحوي العديد من ملامحها الثقافية.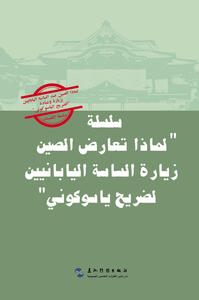
سلسلة "لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين لضريح ياسوكوني" (مجموعة من 5 مجلدات) (باللغة العربية)
سلسلة "لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين لضريح ياسوكوني" نبذة عن الكتاب: تضم هذه السلسلة خمسة كتيبات: "كيف أُنشأ ضريح ياسوكوني"، "ما العلاقة بين ضريح ياسوكوني والثقافة والدين في اليابان؟"، "كيف كان ضريح ياسوكوني خلال حرب العدوان الياباني على الصين؟"، "ما الفرق بين الضريح قبل وبعد الحرب؟"، "لماذا أصبحت زيارة ضريح ياسوكوني موضوع حساس؟" فمن خلال التعرف على تاريخ ضريح ياسوكوني وتأثيره على المجتمع الياباني، تكشف الوجه الحقيقي للضريح، ومن ثم توضح للعالم لماذا تعارض الصين زيارة الساسة اليابانيين للضريح. نبذة عن الكاتب: بو بينغ، باحث في معهد التاريخ الحديث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. الاتجاه الرئيسي للبحث هو تاريخ العلاقات الصينية اليابانية، والعلاقات الدولية في شمال شرق آسيا، وتاريخ الغزو الياباني للصين، وتاريخ حرب مقاومة اليابان. من مؤلفاته "ضريح الأرواح الحائمة ـــــــــــ ضريح ياسوكوني والنزعة العسكرية اليابانية"، "الحرب اليابانية الكيميائية خلال فترة الحرب العالمية الثانية"، "تاريخ القرن الماضي للشمال الشرقي" وغيرهم. توصية المحرر: منذ العديد من السنوات، زار الساسة اليابانيون ضريح ياسوكوني مرة أخرى، لتلحق زيارتهم هذه أكبر أذى بمشاعر الشعب الصيني وكثير من الشعوب الآسيوية التي عانت من العدوان الياباني، مما جعل العلاقات بين اليابان وهذه الدول في غاية التوتر. كما أصبحت التطورات حول ضريح ياسوكوني محط اهتمام الجميع. ولأن ضريح ياسوكوني هو ملك لليابان وحدها، لذلك ليس واضحا للأجانب ما هي طبيعة هذا الضريح الياباني، فمعظم الناس دائما ما يميلون إلى التكهن معتمدين في ذلك على خبراتهم الخاصة ومعرفتهم. إن القوى اليابانية اليمينية المحافظة دائما ما تثير مثل هذا التساؤل: تستطيع كل دولة أن تقيم مراسم إحياء لذكرى خلال إحياء ذكرى البطل القومي Shrine، فعلى سبيل المثال تستطيع أمريكا أن تعتبر قبر الجندي المجهول هو Shrine الخاص بها، كما يستطيع الروسيون إشعال مشاعل الميدان الأحمر بموسكو لفترة طويلة، ويستطيع الصينيون وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب، فلماذا لا يحق لليابانيين إحياء ذكرى Shrine ــــــــــ زيارة ضريح ياسوكوني؟ في الحقيقة أن ضريح ياسوكوني هو ليس بأمر يمكن التحدث عنه ببساطة من خلال Yasukuni Shrine. تقدم كتيبات هذه السلسلة بكل موضوعية تاريخ ضريح ياسوكوني وتأثيره على المجتمع الياباني، ليتمكن القارئ من رؤية الوجه الحقيقي لضريح ياسوكوني.
من زاوية القاهرة
مدينةٌ تطلُّ على العالم وتُشرِفُ على تاريخه القديم والحديث، هكذا كانت القاهرة في عيون المؤرِّخ المصريِّ «محمد شفيق غربال»، ومن زاوية القاهرة أخذ يقرأ تاريخ العرب، يدرسه ويتمعَّن فيه، ويقدِّمه للقارئ في هذا الكتاب، كما قدَّمه للمستمع في سلسلة إذاعية حملت ذات العنوان، ويحتوي الكتاب على خلاصة دراسات عميقة ومتفحِّصة رامت إزاحة الغبار عن التاريخ العربي، وإزالة ما أُلصِق به من افتراءات شوَّهته وانتقصت منه ومن مكانة العرب بين الأمم، مضيفًا إلى تلك النظرات في التاريخ والشخصية العربية قبساتٍ من حياة عدد من العظماء الذين غيَّروا وجه التاريخ، وخلَّدتهم ذاكرة العالم كمفكِّرين ومجدِّدين ومصلحين رصدهم المؤلِّف وفَضْلَهم من زاويته الراقية بالقاهرة.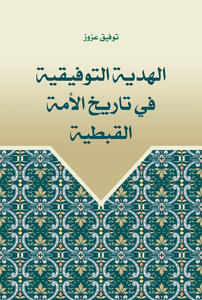
الهدية التوفيقية في تاريخ الأمة القبطية
منذ بدايات العصور التاريخية، كانت كلمة «قبطي» تُطلَق على الإنسان المصري القديم، ولم يكُن هذا الاسم في ذلك الوقت يحمل في طيَّاته أيَّ دلالة دينية، ولكن عقب دخول العرب ﻟ «مصر» أثناء الفتح الإسلامي، أصبح لهذه الكلمة دلالةٌ أخرى، فصارت تُعبِّر عن معتنقي الديانة المسيحية تمييزًا لهم عن غيرهم. عن كل ذلك وأكثر، يحدثنا «توفيق عزوز» في هذا الكتاب، شارحًا لموجز تاريخ الأقباط في «مصر» منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث، فيعرفنا على أصلهم وسبب تسميتهم بهذا الاسم، ويتحدث عن بعض عاداتهم القديمة المشهورة، ودياناتهم ولغتهم، وأعظم ملوكهم وحُكامهم، مشيرًا إلى الصراع التاريخي الطويل الذي خاضه ملوك الأقباط لأجل الحفاظ على حُكمِهم للبلاد، هذا بالإضافة إلى الوقوف على أحوال الأقباط في العصر الحديث، فيذكر لنا أهم أعيادهم، وأشهَر مدارسهم وكنائسهم وجمعياتهم.
الصهيونية
في الوقت الذي كانت فيه الصهيونية تنفذ مخططاتها في فلسطين والأراضي العربية بحرص وإصرار شديدين، كانت الحكومات العثمانية تغضُّ الطرف، وتقلل من أهمية التحركات اليهودية التي لم تفتر منذ أواخر القرن التاسع عشر. ولمَّا كان «نجيب نصَّار» مهمومًا بالقضية، ومُجدًّا في التوعية بالخطر المُحدِق الذي تمثِّله الصهيونية؛ فقد سخَّر صحيفته «الكرمل» لنشر الملفات التحذيرية، ومتابعة الأخبار والخطط بالنقل المباشر عن المصادر العبرية، وبخاصة الإنسيكلوبيديا اليهودية — وهي الموسوعة التي عكف على كتابتها طائفة من نُخبهم، واحتوت على أدبياتهم وأيديولوجياتهم وتوجهاتهم الاستعماريَّة. هذا الكتاب هو مجموع ما وقع بين يدي صاحب الكرمل حتى عام ١٩٠٥م من وثائق تتضمن نشأة الصهيونية ونموها، وغاياتها ومراميها، وطرق انتشارها وتغوُّلها. ويعقِّب المؤلِّف عليها مُستنهضًا الهمم، في محاولة لتجنُّب لعنات الأجداد والأبناء التي يستمطرها السماحُ بإضاعة البلاد.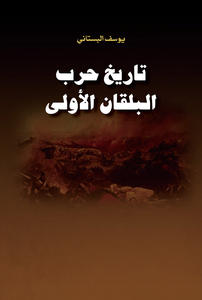
تاريخ حرب البلقان الأولى
كانت الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر قد وصلت لحالة ملحوظة من الضعف بسبب العديد من المشكلات الداخلية وظهور العديد من الحركات الانفصالية والوطنية في دول الخلافة، كما تَرافق ذلك مع تزايد التوتر بينها وبين دول الجوار، خاصةً «روسيا القيصرية»، التي كانت تطمع في زيادة نفوذها بأوروبا؛ فعملت على حشد دول البلقان ضد العثمانيين وتوسطت لإبرام اتفاقيات حربية بين بلغاريا واليونان وصربيا؛ فزادت تلك الاتفاقيات من سخونة الأجواء بين البلقان والأستانة، وأُعلنت الحرب من جانب دول البلقان ضد الدولة العثمانية التي لم يكن جيشها مستعدًا بشكل كافٍ على عكس جيوش البلقان، التي أخذت بأحدث الأساليب الحربية وزودت نفسها بأفضل الأسلحة؛ لتنتهي المعارك بشكل كارثي للعثمانيين، حيث خسروا الكثير من الأراضي في أوروبا، كما دُمر جزء كبير من جيشهم.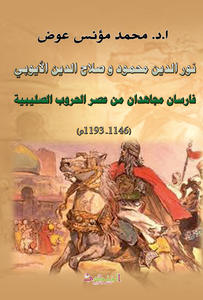
نور الدين محمود و صلاح الدين الأيوبي فارسان مجاهدان من عصر الحروب الصليبية
نتعرض في الصفحات التالية تعريفاً لنور الدين محمود (1146- 1174م ) ، ومصادر تاريخه وذلك علي نحو موجز كي يكون ذلك مدخلاً لتناول جهاده ضد الصليبيين . نور الدين محمود ، هو ابن عماد زنكي أتابك الموصل (1146م ) ابن آق سنقر ، ولد من أسرة تنتمي إلي قبيلة السابيو التركية عام 1118م ، والعام المذكور رحل فيه الملك الصليبي بلدوين الأول ( 1100- 1118م ) الذي يعد المؤسس الفعلي لمملكة بيت المقدس الصليبية ، وهو نفسه العام الذي رحل فيه الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين Alexius Comneneت ( 1081- 1118م ) الذي عاصر مقدم الحملة الصليبية الأولي (1095- 1099م ) ، وذلك يعني انه ولد في عصر الحروب الصليبية بعد 19 عاماً من مقدم الصليبيين إلي المنطقة و غزوهم الدموي لبيت المقدس عام 1099م .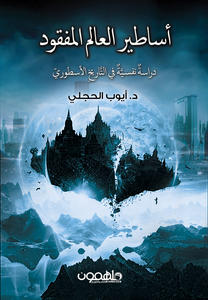
أساطيرُ العالمِ المفقودِ
الإنسان القديم - بداية الوجود وفجر التاريخ الأول- عرف الطبيعة البكر التي كانت بالنسبة له مجهولاً غامضاً، يمور بالأخطار المحدقة عند غياب الشمس، فعاش في هذا الغموض أحقاباً عديدة متتالية، حتى أَلِفَ المحيط حوله، وبدأ يصوغه بلمسته الإنسانية الأولى مبتعداً عن الهمجية والمشاعية، ومرتقياً الدرجة الأولى في سلم التطور الطبيعي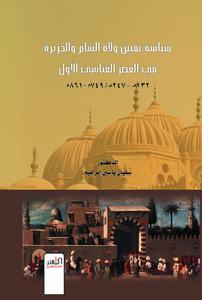
سياسة تعيين ولاة الشام والجزيرة في العصر العباسي الاول
على الرغم من الدراسـات الـكثيرة التي تناولت مختلف المجالات في العصر العباسي ، إلا إن موضوع ( سـياسـة تعيين ولاة الشـام والجزيرة في العصـر العباسي الأول 132 – 247 هـ / 749 – 861 م ) لم يحظ بما يستحقه من اهتمام الدراسات العلمية الحديثة . لذلك فان دوافع اختيار هذا الموضوع وأهميته ، ربما لا تكمن في ندرة تناول الباحثين له فحسب ، بل في طبيعة عصره الذي تميز بأكفّاء الخلفاء العباسيين حزماً وسياسةً، إلى جانب إمكانياتهم العسكرية والاقتصادية الكبيرة ، ثم في تعامله مع مناطق جغرافية غير اعتيادية مواجهة للعدو التقليدي ( الروم البيزنطيين ) وما فيها من إرث حضاري ، ومزيج سكاني ، نمت فيه حركات المعارضة ، وكثرت فيه النزعات القبلية والثورات المحلية .
فصل في تاريخ الثورة العرابية
يتناول محمود الخفيف في هذا الكتاب تاريخ الثورة العرابية باعتبارها حركة وطنية قومية بُعثت في أواخر القرن التاسع عشر، حيث ثار الوطنيون من المدنيين والعسكريين على التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية، كما ثاروا على حكم الخديوي وما آلت إليه البلاد من فساد في عهده. وقد انتهت ثورة عرابي بعد أن أخمدها الاحتلال واستطاع بالتعاون مع القصر أن يشوه صورة هذه الثورة ويحط من القيمة الوطنية لزعيمها. وقد عمد محمود الخفيف من خلال هذا الكتاب إلى إنصاف التاريخ الوطني المصري عبر استعادة الحقيقة التاريخية، واسترداد الكرامة الوطنية، حيث أعاد الاعتبار لزعيم الثورة أحمد عرابي، وبيَّن دوره الوطني الكبير في مواجهة الاحتلال والحكم الداخلي الفاسد.
مصر العثمانية
ألف جرجي زيدان هذا الكتاب عام ١٩١١، بغرض تدريس التاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية آنذاك. ويناقش الكتاب الحال الذي كانت عليها مصر عند الفتح العثماني، ويطرق الكتاب إلي أصل ونشأة الدولة العثمانية، وارتباطها بالتاريخ المصري، كما يدرس فترة حكم سليم الأول باعتباره السلطان العثماني الذي فتح مصر. وقد حرص زيدان خلال هذه الكتاب علي الموازنة بين العام والخاص، فربط في كتابه بين العهد العثماني العام المتمثل في الخلافة الإسلامية، والعهد العثماني في مصر باعتباره أحد المراحل التاريخية التي مرت بها تاريخ مصر العام. كما لم تقتصر الدراسة التاريخية في هذا الكتاب على الجانب السياسي بل امتدت لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والحضارية.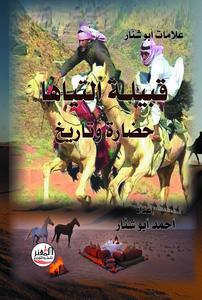
قبيلة التياها حضارة وتاريخ
إن الحكومات الاسرائيلية المتطرفة المتعاقبه منذ احتلال فلسطين تواصل حربها المفتوحة على وجود الإنسان الفلسطيني في أرض وطنه وتتعدد أشكال وأوجه هذه الحرب لتطال جميع مناحي الحياة الفلسطينية من سرقة واسعة النطاق للأرض، وتهجير للسكان وهدم منازلهم وحصار المدن والبلدات والقرى الفلسطينية ومن عمليات استيطان وتهويد للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني ومن إجراءات عسكرية احتلالية تقيد حركة الفلسطينيين وتنكل بهم وتحولهم إلى أسرى في وطنهم. وتتكامل أدوار المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ حلقات هذه الحرب ومراحلها المتعاقبة ومع ذلك فالحقيقه أن إسرائيل تواجه حالة من انعدام اليقين بكل ما يتعلق بمستقبل وجودها في هذه المنطقة.
ذو النورين عثمان بن عفان
حفلت حياة «عثمان بن عفان» بكثير من الأحداث الجِسام، ولعل من أبرز هذه الحوادث هي التطور الاجتماعي، الذي حدث مع أول أيام البعثة النبوية، فقد أحدث الإسلامُ انقلابًا كبيرًا في المجتمعات العربية ضد عادات ونُظم ومعتقدات، ولم تَسْكُن ثورة هذا الانقلاب إلا مع بدايات عهد «عثمان». أما ثاني هذه الحوادث فهي مقتله. إذ كان مقتل خليفة المسلمين بعد بضعة سنوات من وفاة رسولهم حدثًا له توابعه ودوافعه التي غيَّرت شكل الدولة الإسلامية فيما بعد. وقد نجح العقاد في تخطي صعوبة تناول سيرة «الخليفة المقتول» عبر عرضه لأهم العوامل التي أدت لوصول الأمر إلى ما آلت عليه، من تناحر وخلاف، أصبح فيما بعد نواة لأكبر فتنة عاصرت العهود الإسلامية بعد ذلك.
ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية
بعد المصير الذي تلقَّته المَلَكيَّة في «فرنسا»، انطلقت الحملات الفرنسيَّة لمحاربة مضادِّيها والاستيلاء على مَمَالكهم، وفي عام ١٧٩٨م، تَقرَّر شن حملة غزو «مصر» بقيادة «نابليون بونابارت» بهدف ضرب الإمبراطورية الإنجليزية في الشرق، وبعد استيلائه عليها شن «نابليون» عام ١٧٩٩م حملة لغزو بلاد الشام خوفًا من رغبة الدولة العثمانية في استعادة «مصر»، والتي باءت بالفشل وانتهت إلى اتفاقيَّة صُلح عام ١٨٠٠م نُقِضَت شروطها، فاندلعت الحرب من جديد بين جيش «نابليون» وجيش الدولة العثمانية بمساندة «الإنجليز»، وانتهت إلى اتفاقية صُلح جديدة عام ١٨٠١م كان على إثرها انسحاب الجيوش الفرنسيَّة من «مصر» بصورةٍ نهائية.بلغة شعريَّة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى، وببعض المَيْل لتمجيد المُحتلِّ الفرنسي، يسرد «نقولا التركي» حكايات العامَّة عن الحملة الفرنسية على «مصر» و«الشام».
رجال الحكم والإدارة في فلسطين
تحتلُّ فلسطينُ أهميةً خاصةً في التاريخ الإسلاميِّ؛ فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وقد قَدَّر الحكامُ هذه الأهميَّة حق قدرها، حتى إنَّ الخليفة الأُموي «سليمان بن عبد الملك» فكَّر أن يتَّخذها مقرًّا للخلافة، وبذل العربُ جُلَّ ما في وسعهم حتى يستردوها من الصليبيين. وقد حُكِمت فلسطينُ في عهودٍ إسلاميَّةٍ عديدة؛ منها العهد الراشدي، والأموي، والعباسي، والعثماني. وقد تعدَّدت أساليبُ الحكم والإدارة فيها بتعدد مراكز الحكم؛ فانتقلت تبعيتها بين دول الشام، وكانت أحيانًا تمثل إمارةً مستقلةً بذاتها، بل إن القدس في العهد العثمانيِّ اعتُبرت «متصرفية» تتصل بنظارة الداخلية مباشرة. ويُصنِّفُ هذا الكتاب قائمة ببليوجرافيا هامة لمن يريد أن يتصدَّى لدراسة تاريخ فلسطين في العهد الإسلامي؛ فقد جاء هذا الكتاب ليسد نقصًا في المكتبة العربية.
أبطال مصر
قطعت مصر شوطًا طويلًا من الكفاح السياسي في الربع الأول من القرن العشرين بغية أن تنال استقلالها عن الإمبراطورية البريطانية التي كانت في عنفوانها آنذاك، حيث كان مجابهة قوى كبرى مثلها يبدو عملًا عبثيًّا لا طائل منه، ولكن ذلك لم يمنع الحناجر المصرية أن تصدح بنداء الحرية في الميادين والمحافل العالمية، فحتى بعد نجاح ثورة ١٩١٩م ظلت حكومة التاج البريطاني تماطل وتناور أملًا منها في أن تُميت القضية، وتجعل من فرض الحماية الإنجليزية أمرًا واقعًا؛ فتذرعت بحجج واهية كصون الأقليات وحماية عرش السلطان، وساقتها في ما سُمي بـ «مشروع كرزون» الذي أصاب الأمة المصرية بخيبة أمل كبرى عند صدوره، ولكن الله سخَّر لمصر أبطالًا وقفوا أمام هذه الألاعيب الاستعمارية وقد توحدت قلوبهم على هدف واحد هو مصر الحرة ذات السيادة.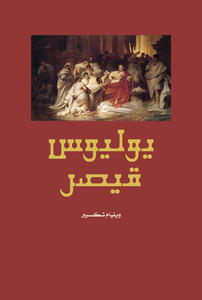
يوليوس قيصر
أثارت انتصارات «يوليوس قيصر» الأخيرة إعجاب سكان «روما» وفخرهم؛ فخرجوا للطرقات والميادين العامة مُحتفلين، وقد ارتدوا أفضل ملابسهم وكأنه العيد، وتزيَّنت الشوارع لاستقبال الفاتح العظيم؛ الأمر الذي أزكى من النيران المُستعرة في قلوب حُسَّاده من أعضاء «مجلس الشيوخ»، والذين رأوا في قيصر ديكتاتورًا قد بالغ القوم في تقدير فضله. واستغل هو حب الجماهير وتقديرهم له فزاد من سلطاته ليحكم قبضته أكثر على «روما»؛ الأمر الذي لم يجعل لهم خيارًا سوى أن يُنهوا حياته، فتآمر عليه الجميع، حتى أخلص قادته وأحبهم إليه «بروتاس». وتربَّصوا به خارج «الكابيتول»، حيث تناوبوا عليه بالطعن؛ ليسقط غارقًا في دمائه في مشهد رهيب.
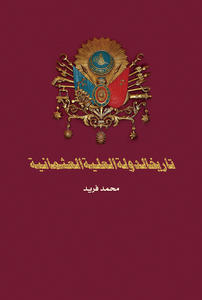
تاريخ الدولة العلية العثمانية
يستهلُّ محمد فريد كتابه «تاريخ الدولة العلية العثمانية» بعبور سريع على تاريخ دُوَلِ الخلافة المتعاقب، بدءًا من الخلافة الراشدة حتى دولة المماليك. ثم ما يلبث بعد ذلك أن ينتقل بصورة تفصيلية إلى تاريخ الخلافة العثمانية منذ نشأتها حتى نهايتها تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني. ويُعَدُّ التاريخ العثماني من أكثر التواريخ الإسلامية إثارةً للجدل، حيث اختلف المؤرِّخون حول تقييمه بين مؤيِّد ومعارض؛ فهو تاريخ شَهِدَ الكثير من الفتوحات والإنجازات الحضارية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما شهد في الوقت ذاته تدهورًا تَمَثَّل في انصراف السلاطين عن أحوال الناس، واهتمامهم بصناعة الأمجاد الشخصية بدلًا من تلبية احتياجات الرعية. وتنبُع أهمية هذا الكتاب من كونه يُلقِي نظرةً شاملةً على تاريخ الدولة العثمانية بصورة موجزة قدرَ الإمكان، وبقلم أحد كبار رموز الحركة الوطنية المصرية أوائل القرن العشرين.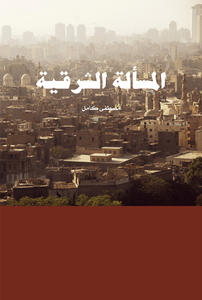
المسألة الشرقية
«المسألة الشرقية» هو عمل تاريخي بالأساس، إلا أنه لا يخلو من غرض سياسي قَصَدَ به «مصطفى كامل» نُصرَة القضية المصرية، عرَّف فيه المسألة الشرقية بأنها ذلك الصراع القائم بين دول أوروبا ودولة الخلافة العثمانية المترامية الأطراف ووجودها في قلب القارة العجوز، ولعل المتأمل يرى أن الغرض الأبرز من مناقشة مثل هذه القضية الكبيرة هو وضع حركة الاستقلال التي كان يقودها «مصطفى كامل» من أجل تحرير مصر في إطار مُحدد، من خلال التركيز على عداوة «بريطانيا» لمصر وللدولة العثمانية والعالم الإسلامي، فالمسألة المصرية لم تكن إلا حلقة في ما أصبح يُعرَف في السياسة الدولية في القرن التاسع عشر بالمسألة الشرقية.
هارون الرشيد
لعل الخليفة «هارون الرشيد» هو أكثر خلفاء العصر العباسي شهرة ومعرفة بين الناس وذلك لِمَا تَحَقق في عصره من نهضة عِلْمية وأدبية، حيث قَرَّب من مجالسه الشعراء والأدباء وأهل العلم كما ازدهرت حركة التجارة الخارجية ونَمَت العلاقات السياسية بين دولة الخلافة وممالك أوروبا فأهدى الرشيدُ الهدايا النفيسة والطريفة للإمبراطور «شارمان» التي عَكَسَت ما وَصَلَت له الحضارة العربية مِنْ تَقَدُّم آنذاك. أيضًا طار صيت الرشيد إلى أن بَلَغ الغربَ بسبب ما حَكَتْه روايات «ألف ليلة وليلة» عن الحياة الباذخة التي كانت عليها قصور الخليفة. كما يسرد المؤلف في هذا الكتاب الكثيرَ من الأحداث السياسية الكبرى على عهد الرشيد كصعود «البرامكة» وتنامي نفوذهم ثُمَّ محنتهم الشهيرة بسبب انقلاب الخليفة عليهم.
تاريخ حماة
يُعَدُّ هذا الكتاب من أوائل الكتب التي عُنيت بتسجيل تاريخ «حماة» المدينة السوريَّة العريقة، مشتملًا على أحداثها الكبرى منذ نشأتها وحتى بدايات القرن العشرين. والمؤلِّف من واقع معايشته للمدينة — بوصفه ابنًا من أبنائها، نشأ وعاش فيها، وشغف بتقصِّي أخبارها فيما عاصره وفيما سبقه — يستعرض «أحمد بن إبراهيم الصابوني» تاريخ مدينته بدءًا من عصر الحيثيين الذي يرجع إلى نحو ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد، مرورًا بحروبهم مع المصريين، ثم عصر بني إسرائيل، يليه اليوناني، فالروماني، وصولًا إلى عصر الحكم الإسلامي. ويقدِّم الصابوني وصفًا مفصَّلًا للمدينة القديمة، متناولًا أبرز معالمها العمرانية والحضارية، وخصائص سكانها، ويأتي كذلك على ذكر عدد من أعلام حماة وفضلائها الغابرين.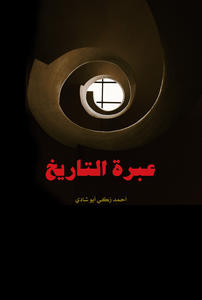
عبرة التاريخ
«إلى عشاق العدل والوطنية. ومحبين الإنصاف والمساواة. إلى الباكين على مصائب الأمم. وكارثات الشعوب. أزف روايتي الأولى التي تبحث في أحوال بولاندا في القرن السابع عشر وكيف قام أبراشياؤها بها فدافع وانتصر. بل كيف يكون الاتحاد ومبلغه والتآزر وقوته، ومن ثم كيف قُسمت تلك المملكة المسكينة بين روسيا وألمانيا والنمسا وكيف يتعدى الإنسان على أخيه الإنسان فيسليه أغلى شيء لديه وهو حريته. تلك روايتي أول ما أخرجته فكرتي تركتها بلا تهذيب لتكون تذكارًا لي من أيام صغري إذا ما بلغت يومًا ما مبلغ الرجال وهو جل ما أريده وتتمناه نفسي. فعذرًا أيها القوم الكرام إن مرت عليكم بعض الغلطات والعذر عند كرام الناس مقيول.»
تاريخ النبات عند العرب
«تاريخ النبات عند العرب» هو كتاب علمي في ثوبٍ توثيقيٍ تاريخي؛ فالكتاب يتناول تاريخ النبات عند العرب بوصفه من العلوم الأثيرةِ لديهم، وقد قسَّم الكاتب هذا الكتاب إلى أربعة أجزاءٍ جمعت بين طيَّاتها أوجه الحُسْن المعرفي التي تبرهنُ على عِظَمِ هذا العلم؛ بوصفه علمًا مصيريًا في حياة الإنسان، وقد برع الكاتب في تصنيف حيثيات هذا العلم لغويًا، وعلميًا، وتاريخيًا، وجغرافيًا؛ حيث تناول الكاتب تاريخ علم النبات في شبه الجزيرة العربية ومدى وثاقة ذلك العلم بالصحيح من لغة العرب، ثم تناول تاريخ النبات من الناحية الطبية، واقْتَفَى أثره عبر العصور المختلفة: الإسلامية، والأموية، والعباسية، ثم تحدَّث عن تاريخ الفلاحة عبر البلدان المختلفة؛ فتحدَّث عن الفلاحة في فارس والأندلس، وذكر العلماء الذين عكفوا على التدوين لهذا العلم وأشهر مؤلفاتهم فيه، كما تحدَّث عن اهتمام الهنود بهذا العلم، وتناول مَنْ اهتموا بالتدوين لهذا العِلم في العراق، والشام، ومصر في عهد الدولة الفاطمية والأيوبية، واختتم كتابهُ بتناوله للتاريخ الجغرافي لهذا العلم عبر رحلات الرَّحالة العرب.
بداءة عصر البطالمة
كانت مصر قبل مجيء البطالمة ترزح تحت الاحتلال الفارسي الذي اتخذ منذ يومه الأول نهجًا عدائيًّا تجاه ثقافة المصريين وعقائدهم، حيث سخر الفرس من أديانهم؛ فدنسوا المعابد وأبطلوا الشعائر الدينية، كما فرضوا دينهم على المصريين قسرًا، ناهيك عن العلاقة السيئة والمتوترة على الدوام بين الإدارة الفارسية والمصريين. لذلك رأى المصريون في حملة «الإسكندر الأكبر» نوعًا من التحرير؛ خاصة بعد ما أظهره «البطالمة» من احترام لمعبودات المصريين القديمة، وإدراكًا منه لأهمية مصر وموقعها الجغرافي أمر «الإسكندر الأكبر» بإنشاء مدينة ساحلية جديدة هي «الإسكندرية» التي أصبحت بعد فترة وجيزة واحدة من أهم مدن العالم التجارية ومنارة علمية عظيمة يقصد مدارسها ومكتباتها طلبة العلم من كافة الأصقاع، تعرف أكثر على حكم البطالمة لمصر وأثرهم في حضارتها مع كتاب «بداءة عصر البطالمة» لإسماعيل مظهر.