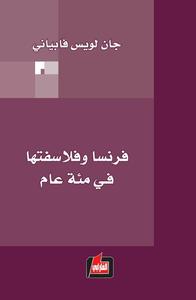
فرنسا وفلاسفتها في مئة عام
هذا الكتاب يقدم بحيوية غير عادية وجريئة قراءة متاحة للجميع، في الحياة الفكرية الفرنسية عبر أبرز ممثليها وصناع تميّزها ألا وهم فلاسفتها، من أين يستمدون هؤلاء هذا المقام الإجتماعي الذي تميّزت به فرنسا بتخصيصه لهم؟...ما يقدمه جان لويس فابياني في كتابه هو إجابة عن هذا السؤال يستحضر فيها بدايات تكوّن هذا الدور فيعرض علينا المفاهيم والأنساق التي انبنى عليها، وكذلك الحياة الإجتماعية للأفكار منذ بدايات الجمهورية الثالثة وحتى نهاية القرن المنصرم.
العرب في زمن المراجعات الكبرى
يحاول الباحث في هذا الكتاب الاقتراب من عمليات تفكيك المجتمع والدولة في العالم العربي، حيث يفحص ويراجع آليات التفكيك الرامية إلى مزيد من تقويض مكاسب التاريخ العربي المعاصر. ويواصل أيضًا جهده الفكري الذي بذله طوال عمله البحثي، الهادف إلى بلورة أسئلة النهضة والحداثة والتاريخ في الفكر العربي المعاصر، مفترضًا أن معطيات التشخيص والتعقّل والسؤال تمكّن من معاينة المكاسب التي حصلت ومحاصرة التحديات التي تحول دون تحقيق مشروعات الإصلاح والتحديث.
سورن كيركگورد في نقد الدين الجماهيري

الكون والفساد
«الكون والفساد» كتاب يضم بين دفتيه أفكار فلاسفة اليونان القدامى من أقدم العصور وحتى عصر أرسطو؛ حيث يتناول أرسطو الآراء السابقة التي ناقشت الكون ومكوناته، والأجسام وماهيتها وفسادها؛ فيقوم بتشريح هذه الآراء، كما يعرض الأسس التي قامت عليها نظريته، ثم يَصُوغ هذه النظرية في قالب فلسفي بديع. كما يحتوي الكتاب على ثلاث رسائل موجَّهة إلى كبار معارضيه، وهم: «ميليسوس»، و«إكسينوفان»، و«غرغياس»، حيث يتناول نقدَ نظرياتهم المتعلِّقة بالكون، والنظرية الوجودية، كما ناقش فكرة وحدانية الله. وقد كان لهذا الكتاب عظيم الأثر على فلاسفة المسلمين في العصر الوسيط، حيث تُرجم لأول مرة على يد «ابن رشد»؛ الذي لقَّبَه «دانتي» ﺑ «الشارح الأكبر لأرسطو».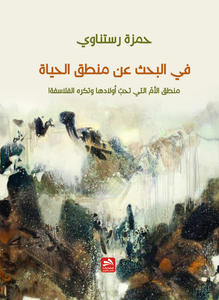
في البحث عن منطق الحياة- (منطق الأم التي تحب أولادها وتكره الفلاسفة!)
؟ عندما نزرع بذرة القمح في الأرض لماذا لا تنتش نبات الفاصولياء؟! عندما نذبح بقرة لن نتوقّع عودتها إلى الحياة بعد ثبوتِ موتها؟! عندما نترك تفاحة معلّقة في الهواء لماذا لا تطير بجناحين! هذه أمثلة بسيطة لإقناع بعض البشر– من العدميّين والخوارقيّن – بوجود منطق للحياة وقانون للكون، ولا نقصد الحياة هنا بدلالتها البيولوجية فقط أوالكون بدلالته الفلكية خاصّة. في الحقيقة إنّ مشروعيّة وجود منطق وقانون هي نفسها مشروعيّة وجود العلم الذي هو بحث لاكتشاف منطق وقانون ناظم في شرطهِ العامّ والخاصّ، مع التذكير بكون المنطق هو مناطق، والقانون هو قوانين.
افتتاحات فلسفة التنوير (دينس ديدرو)
إنَّ صورة الحرية وسط المتاريس والحواجز المحاصرة بها في اللوحة الشهيرة للرسام (يوجين ديلاكرو) تصلح لأن تكون حقاً رمزاً لمدينة باريس المتمردة. إنَّ «الحواجز»، و«عاصفة سجن الباستيل» و«أحداث الثورة الفرنسية» هي بالواقع، شعارات مألوفة لدينا ومعروفة جداًً منذ أيام التعليم المبكرة الأولى في مدارسنا. فبواسطة تلك الشعارت، إذا جاز لنا التعبير، يستحضر كل واحد منا في ذهنه صورة مشرقة ومفعمة عن حياة هذا العصر في فرنسا. فنحن نتخيل سلسلة الأحداث المهيبة والمدهشة لذلك الفيضان الاجتماعي العظيم، الذي طرد الحكم الملكي، بعيداً مع كل امتيازاته الملكية كطبقة مترفة وقاد في الوقت نفسه إلى تشكيل نظام اجتماعي جديد. إنَّ مجمل الشعب الفرنسي ثار وأعلن العصيان، ضد النظام الملكي القديم، برجوازيون وحرفيون وفلاحون وانتصروا في هذا الكفاح. ولكن حين نتأمل في تفاصيل تلك الثورة، فإنَّ من المهم جداًً أن نسبر ونفهم الأمر بعمق وأن نتعامل معه على أنه أكثر من مجرد مكاسب حققها الثوار بقلب النظام وإزالته، وأن لا نهمل أو نتغاضى بصمت عن موضوع هؤلاء الفلاسفة التنويريين الذين أسسوا وأورثوا الشعارات التي رفعت بواسطة المتمردين، هؤلاء الذين وضعوا المهام الملحة على كاهلهم وكاهل الفلسفة. بعبارة أخرى، هؤلاء الفلاسفة هم الذين مهدوا وعبدوا السبيل إلى الثورة عن طريق أفكارهم ومطالبهم الفكرية. وتنبغي الإشادة، أولاً وأخيراً، بهذه المجموعة الصغيرة من الكتّاب أو الفلاسفة التي التفت حول مشروع الأنسكلوبيديا، حيث تحددت هويتهم وعُرفوا فيما بعد بالأنسكلوبيديين. أما الشخصية الرئيسية واللاعب الأساس في هذه المجموعة فقد كان الفيلسوف دينس ديدرو.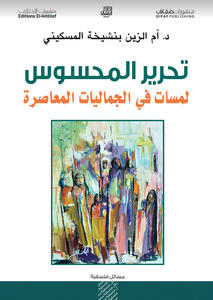
تحرير المحسوس لمسات من جماليات المعاصرة

النص والخطاب
يبحث هذا الكتاب في فلسفة المصطلح وهويته، وفي الإشارة اللغوية والرمز، ويعرج على دراسة التصور اللساني للنص، وكذلك على التصور الأدبي والتصور الإلكتروني، وهو باب جديد في هذا الحقل. ويفصح المؤلف عن ذلك بقوله: "يؤدي الإدراك البنيوي للمصطلح إلى ارتسامه بنائيًا من ثنائية تتشكل من: تسمية + تصور. والتسمية وفق ذلك هي الملصق اللغوي الذي يُصمّم لاحتواء النص وتأطيره وحمله والنهوض به في كينونة حافظة أو حامية محملة بطاقة ادخار أو احتشاد حي ونابض يقبل التأثير والتأثر، وفق شرائط التاريخ والثقافة ونمو معطيات التحضر المجتمعي من مفصل إلى مفصل آخر أكثر تطورًا ومعاصرة". باختصار، فإن هذا الكتاب محاولة لاكتشاف الفروق بين المدلول المعجمي والتصور المصطلحي، وسعي لتحديد التصورات واختلافها وتمايزها بين التصور النحوي التركيبي والتصور الدلالي والتصور التداولي. 
نقد نقد العقل العربي: نظرية العقل
نقد النقد ليس ظاهرة جديدة في الثقافة العربية الحديثة. فكتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين استتبع نحواً من عشرين رداً، كذلك وجد من يردّ على الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق بكتب كاملة. هذا التقليد هو ما يحاول جورج طرابيشي استئنافه في نقده نقد العقل العربي لمحمد عابد الجابري، ولكن من منظور مباين جذرياً. إن نقد النقد الذي يحاوله المؤلّف ليس دفاعياً. فمأخذه الأساسي على نقد الجابري كونه غير نقدي. والقراءة الجابرية للعقل العربي باتت تمثّل في نظره عقبة إبستمولوجية لأن الجابري قد أسر العقل العربي في إشكاليات مغلقة. وما لم تفكَّك هذه الإشكاليات، فإن أية مناقشة للنتائج والأحكام التي انتهى إليها مؤلف تكوين العقل العربي وبنية العقل العربيستظلّ تدور كما لو على محور فارغ.+++من هذه الإشكاليّات المطلوب تفكيكها قبل محاولة استخلاص أجوبة جديدة: إشكالية العقل المكوِّن والعقل المكوَّن، وإشكالية التفكير بالعقل والتفكير في العقل، وإشكالية العقلانية المغربية واللاعقلانية المشرقية، وإشكالية الهوية الضدية للعقل العربي بالمقابلة مع العقل اليوناني القديم والعقل الغربي الحديث.+++نظرية العقل هو الجزء الأول في مشروع متعدّد الأجزاء لإعادة قراءة العقل العربي الإسلامي في فضائه الثقافي الخاص، وفي استمراريته – كما في قطعه – مع العقول الحضارية السابقة واللاحقة.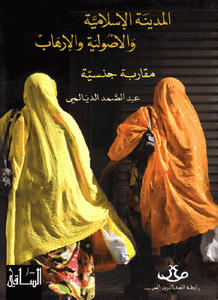
المدينة الإسلامية والأصولية والإرهاب
لماذا يتحوّل المسلم إلى أصولي متشدّد؟ وكيف يتحوّل الأصولي المتشدّد إلى أصولي انتحاري؟ ما هي الدوافع التي تسمح بفهم هذه الظاهرة التي يعاني منها إسلام اليوم؟ يركّز هذا الكتاب على أهمّية العامل الجنسي في تشكّل الشخصية الأصولية والإرهابية، وهو العامل الغائب في مختلف الدراسات السابقة للموضوع. المقاربة هنا لا تتنكّر لأهمّية العوامل الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية في تشكّل القراءة الأصولية الإرهابية للنصّ المقدّس وللواقع. لكنّها تهدف إلى إغناء المقاربات السابقة وتطعيمها بعناصر نفسية، جنسية بالخصوص. وتظهر أن الربط بين الحرمان الجنسي والأصولية الإرهابية ما هو في نهاية المطاف إلا تفصيل في الحرمان الاقتصادي، وتعميق للعلاقة المعقّدة بين الفقر والإرهاب.
خطاب الكرامة وحقوق الانسان
يتناول هذا الكتاب المرتكزات الفلسفية لمفاهيم الكرامة وحقوق الإنسان بالنقد والتحليل. يناقش الكاتب بعض أهم التوجهات الفكرية المعاصرة في شأن هذه المسائل، بما فيها تلك التي تنهض بالكرامة والحقوق على أسس عقلانية، وتلك التي تعطي الدور الأكبر للمشاعر والانفعالات والوجدان. أما وجهة نظر الكاتب نفسه فتتبدى في محاولته تأسيس مفاهيم الكرامة والحقوق انطلاقًا من الحاجات والمصالح والرغبات البشرية الطبيعية، وقدرة الإنسان على التعاطف، ومقاومة كل ما من شأنه أن يقلل من فرصه الحياتية للعيش الكريم.
بلغة الغواص في الأكوان إلى معدن الاخلاص في معرفة الإنسان
خصّص ابن عربي كتاباً منفصلاً، وسمه بوسم البُلغة، لتُفهَمَ الغاية من إيجاد الوجود من خزائن العلم الإلهي الباطن إلى الصورة الظاهرة المتمثلة في الكون، حيث يكون هذا الوجود بتعدد مراتبه وتعيناته هو الحقيقة الإلهية المطوية في الإنسان. من هنا برزت الحاجة إلى معرفة الإنسان نفسه بنفسه، ومعرفته بالعالم لمعرفة ربه. فيزول التعارض بين باطنه وظاهره بالمعرفة الحقة. لأن الإنسان هو مجلى الكماليات الإلهية الحقة، متمثلة في الخلق على الصورة وهو العالم الصغير. فنصّ "بُلغة الغواص في الأكوان إلى معدن الإخلاص في معرفة الإنسان"، مؤلف موسوعي، شأنه شأن مؤلفات الشيخ الأكبر ابن عربي، يجمع بين التصوف والفلسفة ويتميز بجدلية تلقينية عالية ومتفرّدة، توضّح علاقة الإنسان بالله وبالعالم وتدقق في قضايا إنسانية شديدة التعقيد والأهمية؛ كقضية الخلافة والاستخلاف وجدلية التأثر والتأثير والكمالية الآدميّة وغيرها من القضايا.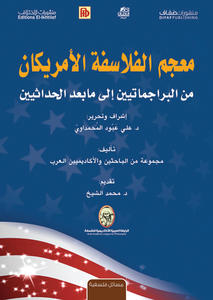
معجم الفلاسفة الامريكان من البراجماتيين إلى ما بعد الحداثيين

الذات في الفكر العربي الإسلامي
يبحث هذا الكتاب عن الذات في الفكر العربي الإسلامي في صورها الفلسفية والصوفية، الفردية والتاريخية، الأنطولوجية والعمرانية؛ وفي جملة من المفاهيم والقضايا المتصلة بمفهوم الذات كالعقل والحق والعدل والدين والوجود والماهية. وتقوم إشكاليته الأساس على إذا كانت هذه "الذات" التي تتكلم عليها الفلسفة العربية الإسلامية تشير حقًا إلى الهوية الفردية (الأنا) أم إلى الماهية العامة (الإنسان بما هو إنسان)، وتقوم أيضًا على ما هي العلاقة التي تنسجها مع هذه الذات مع مفاهيم متقابلة، مثل الماهية والجوهر والنفس والعقل والأنا والهوية والوجود، وما هي صلتها بالجسم المغري بأحاسيسه وأهوائه وانفعالاته وقواه وغرائزه الجامحة، وبالذات المطلقة الجاذبة بكمالها التام وبهائها الغامر.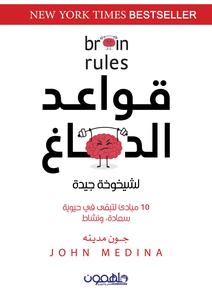
قواعد الدماغ
لا يملك معظمنا أدنى فكرة عما يدور في عقولنا، في حين كشف جون مدينه.. اخصائي بايولوجي في دراسة تطور وعمل خلايا الدماغ واستشاري في الأبحاث تلك التفاصيل.. كما أثبت حاجة الدماغ للأنشطة البدنية ليعمل بشكل أفضل. كيف نتعلم؟ وكيف يؤثر النوم والتوتر تحديدًا على أدمغتنا؟ ولماذا يعتبر أداء العديد من المهام في وقت واحد ضربًا من الخيال؟ ولماذا ننسى بسهولة ولماذا يجب علينا تكرار ما تعلمناه حديثًا؟ وهل حقَا يختلف دماغ الرجل عن المرأة؟ يعرض جون مدينه، عالم البيولوجيا الجزيئية، في كتابه الذي يحمل عنوان “قواعد الدماغ” كيف يمكن لعلوم دراسة الدماغ، والتي شكلت محور اهتمامه طوال حياته، أن تؤثر على الطريقة التي نعلّم بها أطفالنا وكذلك على طريقة عملنا.
الحرية والعنف
في وقت يهيمن الأنموذج العلمي على عقول الفلاسفة، تبدو الكتابة عن حرية الإنسان مشروعًا محفوفًا بالمخاطر، أولها الوقوع في تعميمات لا تفيد تقدم البحث عن الإنسان. في سعيه إلى بناء علاقة الإنسان بحريته، يطرح هذا الكتاب تساؤلات عدة: ألا يشكّل مفهوم الحرية ذاته الوهم الأكبر الذي أضفاه الإنسان على نفسه عبر العصور المختلفة، كي يخفي المرء حقيقته عن نفسه ذاتها؟ كيف يمكننا أن نؤسّس علميًا مفهومًا كهذا ربما لم يكن في العمق إلا حكمًا مسبقًا غير عقلاني؟ كيف يمكن تثبيت الطابع العلمي الموضوعي لمثل هذه الحرية؟ ألسنا أمام مفهوم يستعصي على كل نَسْقَنَة، وكل بنيوية للفكر؟ ألا تمثل فلسفة الحرية خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى ميل الفلسفة الحالي إلى أن تكون موضوعية في عمق ماهيتها، والتي تجد في مثل هذه الموضوعية سبب وجودها، بل وجودها عينه؟
أوهام ما بعد الحداثة
صدر عن سلسلة "ترجمان" عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "أوهام ما بعد الحداثة"، وهو ترجمة ثائر ديب لكتاب تيري إيغلتون The Illusions of Postmodernism، الذي يستكشف فيه انبثاق ما بعد الحداثة وأصولها، ويكشف عمّا تنطوي عليه من تجاذب وتناقض، لكن اهتمامه الرئيس لا يتركّز على الفلسفة ما بعد الحداثية بصيغها المعقدة بقدر ما يتركز على ثقافة ما بعد الحداثة وبيئتها ككل، مخاطبًا خصوصًا طلاب الفكر ما بعد الحداثي ومستهلكي بضاعته الشعبية. في كتابه هذا، يدافع إيغلتون عن أهمية النظرية الماركسية في الوقوف في وجه التفضيل الحالي بين النقاد لمرحلة ما بعد الحداثة، ويحاجّ أنّ "ما بعد الحداثة"، بنظرها إلى العالم على أنه مجزأ وحقيقي وغير محدد، هي الخلف غير الكافي للماركسية التي يمكن أن تقدم في انتقادها للرأسمالية رؤية أخلاقية أكثر واقعية إلى المجتمع. يتألف الكتاب (199 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من استهلال وستة فصول. يقول إيغلتون، في "استهلال"، إنّ مصطلح ما بعد الحداثة (Postmodernity) يشير إلى مرحلة تاريخية مخصوصة، أما مصطلح ما بعد الحداثيّة (Postmodernism) فيشير بصورة عامة إلى شكل من أشكال الثقافة المعاصرة. وما بعد الحداثة أسلوب في الفكر يبدي ارتيابًا بالأفكار والتصورات الكلاسيكية، كفكرة الحقيقة والعقل والموضوعية والهوية، وفكرة التقدم الكوني أو الانعتاق، والأُطُر الأحادية، والسرديات الكبرى أو الأسس النهائية للتفسير. وهو نزع إلى التمسّك بالمصطلح المألوف أكثر "ما بعد الحداثيّة" كي يشير به إلى الشيئين كليهما، نظرًا إلى ارتباطهما الوثيق والواضح. السيار والبدايات يسأل إيغلتون، في الفصل الأول، "بدايات": ماذا لو وجد اليسار نفسه فجأةً وقد أزيح جانبًا، وليس مغلوبًا أو مُسْتَنْزَفًا فحسب، ينطق بخطاب نشاز لا ينسجم مع الحقبة الحديثة، حتى إنّ أحدًا لا يكلّف نفسه عناء استكشاف قيمته الحقّة، شأنه شأن لغة الغنوصيّة أو لغة الحبّ الفروسي؟ ما الذي يُحْتَمَل أن تكون عليه ردّة فعل اليسار السياسي على مثل هذه الهزيمة؟ وفي رأيه، لا شك في أنّ كثيرين سوف ينجرفون إلى اليمين، نادمين على ما اعتنقوه في السابق من وجهات نظر مثالية طفولية. ولا شك في أنّ من سواهم سوف يحافظون على إيمانهم بقوة العادة والحنين، متشبثين تشبّثًا قلقًا بهويةٍ خيالية، ومعرِّضين أنفسهم لما يمكن أن يجرّه ذلك من خطر العُصَاب. يقول إيغلتون إنّ اللاكليّة قد تكون مسألة استراتيجية أكثر منها مسألة نظرية، "بمعنى أنّه قد يكون هنالك نوع من النظام الكلّي، وبما أنّ أفعالنا السياسية لا تستطيع أن تفلَه ككلّ، فإنّ من الأفضل أن ننتصح بأن نخفّف حمولتنا ونلتفت إلى مشاريع أشدّ تواضعًا لكنّها أكثر قابلية للحياة". تجاذبات وجدانيّة يرى المؤلف، في الفصل الثاني، "تجاذبات وجدانيّة"، أن ليس في مقدور أحد أن يستنبط التفكيك أو اللياقة السياسية من تنفيس كفاحية الطبقة العاملة أو من إحباط الحركة الطلابية. فالضرورة التاريخية لا تظهر إلا على نحو استرجاعيّ، كإنشاء أو فرضية بعد الحدث. وبالطبع، فإن ما من شيء ضروري قطّ في ما يختصّ بما بعد الحداثية، الأمر الذي يمكن أن نجزم بأنَ المدافعين عنها يوافقون عليه لسوء حظها، وذلك نظرًا إلى وجود كثير من الخواتيم الممكنة التي يمكن أن تنتهي إليها هزيمة سياسية مفترضة. يضيف أنه مهما تكن المنابع الأخرى التي يمكن أن تنبع منها ما بعد الحداثية، كالمجتمع ما بعد الصناعي وتسفيه الحداثة نهائيًا وتفشّي الطليعة من جديد وتسليع الثقافة وظهور قوى سياسية جديدة حيّة وإفلاس أيديولوجيات كلاسيكية معينة تتناول المجتمع والذات، فإنّها تظلّ أيضًا وأساسًا ثمرة إخفاق سياسي كان عليها أن تدفع به إلى النسيان، أو أن تضطر إلى أن تخوض مع شبحه صراعًا لا يتوقف. وفقًا لإيغلتون، لا سبيل إلى إنكار أنّ الموضوعات السياسية المتميزة التي طرحتها ما بعد الحداثيّة هي ضروب الاستبدال بالفعل. وما من أحد وقع على مفهوم الطبقيّة الباهت الذي اختُزِل إلى ضرورة عدم الشعور بالتفوّق الاجتماعي على الآخرين، أو لاحظ الآثار الزَرِيّة التي خلّفها الجهل بالبنية الطبقية والشروط المادية في بعض السجالات ما بعد الحداثية المتعلقة بالجندر أو الكولونيالية الجديدة، يمكنه أن يستخفّ بالخسارات السياسية المريعة الحاصلة. ما بعد الحداثية والنظر إلى التواريخ يقول إيغلتون، في الفصل الثالث، "تواريخ"، إنّ ما بعد الحداثية ترى أنّ التاريخ أمر غائيّ؛ أي إنّه يقوم على اعتقاد مفاده أنّ العالم يتحرك على نحوٍ غَرضيّ صوب غاية محدّدةٍ مسبقًا هي غاية محايثة له أو ماكثة فيه، حتى في هذه اللحظة بالذات، وهي ما يوفّر الدينامية اللازمة لما تراه أعيننا من تجلٍّ وظهور لا يلينان. فالتاريخ له منطقه الخاص، وهو الذي ينتخب مشاريعنا التي تبدو حرّةً في الظاهر كي تخدم مراميه الخاصة المستغلقة. وقد تكون ثمّة حالات من التعوّق هنا أو هناك، أما بصورة عامة فالتاريخ أحادي الخطّ، وتقدميّ، وحتميّ. وتمثّل رؤية التاريخ بوصفه متناقضًا دحضًا للأسطورة القائلة بأن الماركسيين هم من المتعصبين السُذّج للتقدم، هذه المغالطة التي يبدو أنّها انحشرت في أذهان بعض ما بعد الحداثيين بحيث بات من المتعذّر استخراجها. وفي رأيه، من الخطأ أن نعتقد أنّ جميع السرديات الكبرى تقدمية: لا شكّ في أنّ شوبنهاور كان مأخوذًا بواحدة من السرديات الكبرى، مع أنه ربما كان الفيلسوف الأشدّ تشاؤمًا على وجه الأرض. لكن السجال ضد التاريخ بوصفه تقدميًا لا يعني أنه لم يكن هنالك أيّ تقدّم على الإطلاق، فهذا اعتقاد بعيد كلّ البعد عن العقل والمنطق على الرغم مما تبديه ما بعد الحداثية حياله من احتفاء ينمّ على روحها الكلبيّة الشديدة. فليس ضروريًا أن تكون من المؤمنين بعصر ذهبي كي ترى أنّ الماضي كان أفضل من الحاضر من بعض النواحي. الذات ما بعد الحديثة يقول إيغلتون في الفصل الرابع، "ذوات"، إنّ الذات ما بعد الحديثة هي ذات يشكّل جسدها جزءًا لا يتجزّأ من هويتها. فالجسد أصبح شاغلًا شديد التواتر من شواغل الفكر ما بعد الحديث. وتراجع الطاقات الثورية ترافق مع ضرب من الاهتمام بالجسد راح يحتلّ مكان هذه الطاقات. فتحوّل الجميع من الاهتمام بالإنتاج إلى الاهتمام بالانحراف. أما اشتراكية غيفارا فأفسحتْ المجال لما جاء به ميشيل فوكو وجين فوندا من اهتمام بالبدن وعناية بالجسمانيات. واستطاع اليسار أن يجد في التشاؤمية الغاليّة الشديدة عند الأول، بخلاف مزاياه السياسية الناشطة، أساسًا منطقيًا رصينًا يبرر الشلل السياسي الذي أصاب هذا اليسار. وفي اعتقاده، من المهمّ أن نرى، كما لا تفعل ما بعد الحداثية بوجه عام، أننا لسنا مخلوقات ثقافية أكثر منّا مخلوقات طبيعية. فنحن كائنات ثقافية بفضل طبيعتنا؛ أي بفضل ضروب الأجساد التي نمتلكها ونوع العالم الذي تنتمي إليه هذه الأجساد. مغالطات بين التراتبية والنخبوية يُخطّئ إيغلتون، في الفصل الخامس، "مغالطات"، من يخلط بين التراتبية والنخبوية، ولا سيما أنّ مصطلح النخبة مصطلح ضبابيّ بما فيه الكفاية، وكثيرًا ما يُخْلَط بينه وبين مصطلح الطليعة التي هي أمر مختلف تمامًا. ويرى أنّ من النمطيّ أن يُبرز بعض ما بعد الحداثيين كيف أنّ أحكامنا، شأنها شأن أي شيء آخر من أشيائنا، مشروطة بثقافتنا إلى حدٍّ بعيد. فنظرًا إلى تكويننا الجمالي على نحوٍ معين، لا نستطيع أن نتمالك أنفسنا عن رؤية ميلتون بوصفه فنًا عظيمًا، إلا بقدر ما نستطيع أن نتمالك أنفسنا عن رؤية نوع معين من الكلاب بوصفه كلبًا. ويرى، في هذا الفصل أيضًا، أن تؤمن بالجوهرانية لا يعني بالضرورة أن تحمل وجهة النظر البعيدة عن المنطق القائلة إنّ جميع خصائص شيء ما جوهرية بالنسبة إليه. فأن يكون لك وزن ما هو أمر جوهري كي تكون إنسانًا، لكن اتّصافك بحاجبين كثّين ليس كذلك. وأن تؤمن بالجوهرانية لا يعني أيضًا أن تزعم أنّ ثمّة قطيعة حادّة بين الشيء والآخر، وأنّ كلّ شيء منحبس في فضائه الكيانيّ (الأنطولوجي) المنيع عن كلّ شيء آخر. تناقضات ما بعد الحداثية يقول إيغلتون، في الفصل السادس والأخير، "تناقضات"، إنّ التناقض الرئيس في ما بعد الحداثية هو تناقض يشبه بعض الشيء ذاك الذي في البنيوية القديمة الطراز. ويسأل: أكانت البنيوية راديكالية أم محافظة؟ إنه لمن السهل أن نرى كيف كانت البنيوية نوعًا من تكنوقراطية الروح، والاختراق الحاسم الذي اخترقتْ به دفعة الحداثة ذات الطابع العقلاني حَرَم الذات الداخلي. إنّ من السمات اللافتة في المجتمعات الرأسمالية المتطورة كونها ليبرتارية وسلطوية معًا، تعددية وأحادية. وليس من الصعب أن نتبيّن سبب ذلك. فمنطق السوق هو منطق لذّة وتعدّد، منطق ما هو زائل لا استمرار فيه، منطق شبكة من الرغبة عظيمة لا مركز فيها ويبدو الأفراد مجرد آثار زائلة لها. في رأيه، تغرف ما بعد الحداثية بعضًا من منطق الرأسمالية المادي وتحوّله ضدّ الأسس الروحية للرأسمالية على نحوٍ هجومي وعنيف. وهي تبدي في هذا ما يتعدّى التشابه العابر مع البنيوية التي تشكّل واحدًا من مصادرها البعيدة. فالفكر ما بعد الحداثي الخاص بنهاية التاريخ لا يستشرف لنا مستقبلًا يختلف كثيرًا عن الحاضر الذي نحن فيه. والغريب أنّ ما بعد الحداثية تجد في كونها كذلك مدعاةً للفرح والاحتفال. لكنّ هناك في حقيقة الأمر كثيرًا من ضروب المستقبل الممكنة، ومن بينها مستقبل اسمه الفاشية. وأعظم محكّ بالنسبة إلى ما بعد الحداثية، بل إلى كل مذهب سياسي آخر، هو كيف تواجه ذلك.
معالم الوعي القومي
في الأندية جميعها حديث متصل عن القومية، وليس الأمر بعجيب، فطبيعي أن يكثر الأخذ والرد في هذا الموضوع اليوم. وكنت منذ أمد قد عقدت النية على الخوض في هذا المجال مع الخائضين، ثم رأيت من الخير أن أعمد إلى بعض ما كُتب عن القومية عندنا فأنظر فيه، وأعلق عليه. والحق أن ما قد كُتب عن القومية في اللغة العربية ليس بيسير القدر، فخشيت أن يتسع العمل أمامي ويتشقق في وجوه، فتضيع الفائدة المرجوة. ولذلك عزمت أن أحصر عملي في كتاب واحد ذي قيمة أحترم كاتبه. وصدر «الوعي القومي»(30) للدكتور قسطنطين زريق، وهو من الشباب الذين يحرصون على أن يكون لهم تفكير جدي رزين في القضايا. فأرسلت كلمة أولى في الكتاب(31) ثم كلمة ثانية أوسع(32) ولكني في الكلمتين كنت مستعجلًا وقد أبديت فيهما اعترافًا عامًا بفضل الدكتور لا أتزحزح عنه. وها أنا اليوم أعيد الكرة للمرة الثالثة، وقد شعرت أن النظر المتأني في هذا الكتاب والتعليق المستفيض عليه إنما يستدرج إلى معالجة موضوع القومية الخطير. فهذا السِفْر الذي تجده بين يديك أيها القارئ هو نقد لكتاب «الوعي القومي». وآمل أن أكون وفّقت فيه إلى أكثر من نقد كتاب بعينه، فزدت بعض وضوح مسائل لم تزل مختلطة غامضة حتى في أذهان بارزي رجال الثقافة منا...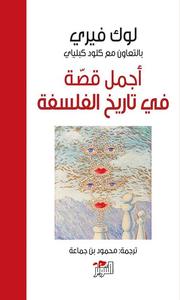
أجمل قصة في تاريخ الفلسفة
إن هذا الكشف التدريجي لدى البشرية عن ذاتها يتواصل بكل بداهة إلى أيامنا هذه. لذا سنكمل هذه السيرة الطويلة بنظرة في السياق الحالي وفي الأجوبة غير المسبوقة التي بوسْع الفلسفة تقديمُها عن حيرة العصر الحاضر، وبالكشف عما في طموحاتنا من مبادئ يَقُوم عليها داعٍ للوجود مشروعٌ. ويبدو تصوُّر هذا الداعي اليوم في غاية الإشكال، وإن كنا نحسّ بالحاجة إليه أكثر مما مضى على الإطلاق.
نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي
يقدّم المؤلّف في هذا الكتاب مشروعاً لنهضة جديدة لليسار في العالم العربي بعد الانكسارات والتراجعات الكبرى التي شهدها هذا اليسار في العقود الأخيرة، لا سيّما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانهيار التجربة الاشتراكية عموماً. ويستند في مقاربته هذه إلى خبرته الطويلة في العمل السياسي والفكري، علماً بأنه أحد أبرز رموز التيار الماركسي في لبنان وفي العالم العربي. ويقترح جملة من المبادئ والأفكار التي يراها ضرورية لخروج اليسار من أزمته الراهنة. ويركّز على أهمية القيام بقراءة غير أيديولوجية للمتغيّرات والتحوّلات التي تجري في العالم المعاصر، بغية استخلاص العناصر الأساسية التي يمكن لليسار الجديد أن يستند إليها في تحديد أهدافه ووسائل نضاله. يتضمّن الكتاب في القسم الأخير منه نصوصاً منتقاة لكلاسيكيي الماركسية: ماركس وإنجلز ولينين وبليخانوف وروزا لوكسمبورغ وغرامشي.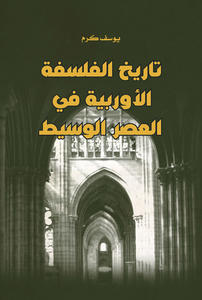
تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط
يتناول الكتاب مرحلةً هامَّة من تاريخ الفلسفة، ألا وهي الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، وقد استهلَّ الكاتبُ كتابَهُ بمقدِّمةٍ أجلى فيها المراحل التي مرَّت بها الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، والتي عُرِفَتْ – آنذاك – باسم «الفلسفة المدرسية». وقد قَسَّم الكتاب إلى أبوابٍ وفصول عرضت الملامح التي تألَّفَت منها تلك المرحلة الجذرية من تاريخ الفلسفة؛ فتناول في الباب الأول الأعلام الفلسفية الرائدة والمُمَيِّزَةِ لتلك الفترة، وتطرَّق في الباب الثاني إلى العصر الممتد من النهضة التي بعثها شارلمان في الربع الأخير من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثاني عشر، وما اتَّسم به هذا العصر من ازدهار للحركة العلمية. ثم انتقل الكتاب بعد ذلك للحديث عن انفصال المدارس عن السلطة الأُسقفية، والثورة على المعاني المجردة والنزوع إلى الواقع التجريبي.
من نقد العقل إلى هيرمينوطيقا الرموز
يشكل التأويل خاصية مميزة للكينونة الإنسانية. فالإنسان يحاول دومًا الاقتراب من الوجود، من خلال لقاءات الدهشة الأولى، حيث يجد نفسه منخرطًا، من البداية إلى النهاية، في عمليات التأويل، سواء بكيفية عفوية وغير منظمة (التأويل كممارسة يومية وحياتية)، أم بطريقة منهجية وواعية (التأويل باعتباره نظرية وفَنًا)، سعيًا منه إلى فهم العالم والآخر وذاته. نشير، في هذا الصدد، إلى أن النصوص من الموضوعات التي شكلت محور اهتمام الإنسان، حيث حاول تأويلها من أجل تقييد معانيها والإمساك بدلالاتها؛ لأن النصوص تتميز بعدم إفصاحها عن مكنوناتها كلها دفعة واحدة، وبكيفية مباشرة ونهائية.
التواصل والحوار: أخلاقيات النقاش في الفكر الفلسفي المعاصر
إنّ الرهان الإيتيقي في أعمال هابرماس تنتظم في جملة المسائل العملية والفلسفية لإخراج مشكلات نصوصه وأعماله وتأويلها، وهو ما يجعل الأمر مشترطاً لخطاب أيكولوجي وبيوإيتيقي مثلما هو متواتر في ظاهرة الاستنساخ وعالم البيئة، حيث يحرص عن كشف أزمة الخطاب المعاصر بين التقني والتواصلي، وهو ما أفضى، بالأساس، لخلق مقاربة فكرية متداخلة تحتمل الاختلاف والتنوع. إنه ينطلق من فضاء رمزي يفترض عملية النقاش التي تكون شاملة لأعضاء المجمع السياسي المنظم الذي وقع إعادة فهمه في إطار "ذوات حقوقية" تستند إليها ديمقراطية عالمية لحقوق الإنسان. فالمسائل الأخلاقية تظلّ مشروطة بالبعد السياسي أولاً من جهة القيم العملية، وثانياً من جهة التوظيف الأيديولوجي الذي يوجه الخطاب الأخلاقي لقضايا الحقوق والسياسة؛ حيث تسمح لنا الأخلاق بتبرير التحليل حول منزلة الأخلاق، وأعني تفكيره في الأنساق والمعارف التي تدخل طرافة "إيتيقا الحوار" من وجهة علم الوراثة الذي تقصّى فيه هابرماس مشكل الطبيعة البشرية. إنّ هذا الطور من هذا الفهم يعدّ طريفاً بما أن الحوار والنقد وإعادة البنى الإيتيقية ورهاناتها العملية، تجعل المشروع التواصلي يتجاوز الفهم المتسرّع، الذي يعتبر أن الذات تأصيل كيان، مما يجعل المسائل الأخلاقية تستمد شرعيتها من براديغم البينذاتية من حيث هي شرط للنقاش الأساسي في رسم جغرافية المعقولية التواصلية. (المؤلف) الناصر عبداللاوي ـ تونس. باحث أكاديمي وكاتب عربي مختص في الفلسفة السياسية والإيتيقية المعاصرة. ـ عضو منسق للرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، وفي مخبر "الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسفية الفيلاب. مهتم بالمقاربات المعاصرة إضافة إلى كونه مدير منتدى المواطنة العربي الذي يضم عدداً من الأكاديميين والباحثين من العالم العربي
الفلسفة القرآنية
يقرر العقاد في هذا الكتاب أن العقيدة الدينية هي فلسفة الحياة التي يعتنقها المؤمنون، وليس أدل على العقيدة الإسلامية من كتابها القرآن الكريم. ويعرض في هذا الكتاب أهم المباحث الفلسفية التي ناقشها الفلاسفة القدامى، وعالجها القرآن في محكم آياته؛ مبينًا وجهة النظر القرآنية فيها. ويتناول الكتاب عددًا من القضايا مثل؛ نظرة القرآن للعلم وفلسفة الأخلاق. كذلك يبين رأي القرآن في قضايا الحكم والطبقية، طارحًا النظرة القرآنية لوضع المرأة. ويناقش المسائل الاجتماعية الهامة كالزواج والميراث والرق. وأفرد جزءًا كبيرًا لمناقشة أكثر المسائل الفلسفية أهمية، وهي الغيبيات أو ما وراء العقل؛ فيبين عقيدة القرآن في الإله، وما افترضه من فرائض وعبادات على الخلائق. ويناقش فلاسفة المادة في مسألة الروح وكنهها وترويضها بالتصوف، وأخيرًا مستقرها في الحياة الأخرى. مستشهدًا بآيات القرآن المناسبة لكل قضية.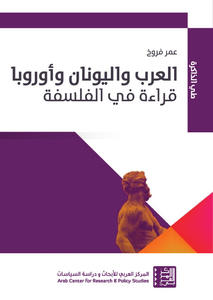
العرب واليونان وأوروبا: قراءة في الفلسفة
صدرت الطبعة الأولى من كتاب عمر فروخ هذا عام 1944، وكان عنوانه: الفلسفة اليونانية في طريقها إلى العرب. وقد وقعت تلك النشرة في تسعين صفحة ونيف. ودار أكثرها (70 صفحة) حول الفلسفة اليونانية منذ ما قبل سقراط وإلى الأزمنة الكلاسيكية المتأخرة (القرنان الرابع والخامس للميلاد). أما القسم الأخير (الفصلان السادس والسابع) (71 - 94)، فقد دار حول نقل الفلسفة اليونانية مباشرةً، وإنما على جانب المترجمين السريان أنفسهم. وطبع المؤلّف كتابه بشكله الأول في عامي 1947 و1952. ثم أطال القسم الثاني من دون أن ينقص من القسم الأول في نشرةٍ ثانية صدرت عام 1960 بعنوان: العرب والفلسفة اليونانية. وقد وقعت هذه النشرة في مائةٍ وسبعين صفحة. ووقع الفصلان المطوّلان في نيّفٍ وستين صفحة.
غابة الحق
سعى الكثير من الفلاسفة والمفكرين إلى الخروج من واقعهم المرير؛ حيث رسم كل منهم مدينة فاضلة تسود فيها بين أفراد المجتمع السعادةُ والعدل والمساواة. ومن الدعوات المبكرة لهذه المدينة كانت دعوة «أفلاطون» في كتابه «الجمهورية»، وتبعه فلاسفة آخرون كالقديس «أغسطين» في كتابه «مدينة الله»، وتوماس مور في كتابه «يوتوبيا». غير أن فرانسيس مراش يقدم لنا مدينته بشكل مختلف تمامًا عن كل الذين سبقوه، وإن استقى مبادئه من نفس المصدر؛ حيث وضعها في قالب روائي يجذب به القارئ، لا سيما وأن الكثيرين يفرُّون من قراءة الفلسفة. وقد وضع فرانسيس الأُطُرَ التي شيَّد عليها مدينته الداعية إلى السلام والعدل والمساواة الخالية من الحروب، وفي مقدمتها تهذيب السياسة والثقافة والأخلاق والمحبة، والقضاء على الشر وأعوانه والجهل والكبرياء والكذب والبخل، فليت الحكام يقرءون ليقيموا جمهورية العدل.
نقد نقد العقل العربي - وحد العقل العربي الاسلامي
يقوم كل مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، على اصطناع قطيعة معرفية بين فكر المشرق وفكر المغرب، وعلى التمييز بين مدرسة مشرقية إشراقية ومدرسة مغربية برهانية، وعلى التوكيد أن رواد المشروع الثقافي الأندلسي ـ المغربي ـ ابن حزم وابن طفيل وابن رشد وابن مضاء القرطبي والشاطبي ـ تحركوا جميعهم في اتجاه واحد هو اتجاه رد بضاعة المشرق إلى المشرق، والكف عن تقليد المشارقة، وتأسيس ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة أهل المشرق.+++هذا الجزء الثالث من مشروع طرابيشي لـنقد نقد العقل العربي يتصدّى لتفكيك تلك الإبستمولوجيا الجغرافية من منطلق توكيد وحدة بنية العقل العربي الإسلامي، ووحدة النظام المعرفي الذي ينتمي إليه بجناحيه المشرقي والمغربي، ووحدة المركز الذي تفرّعت عنه دوائره المحيطة. فلا التحوّل من دائرة البيان إلى دائرة العرفان أو دائرة البرهان، يعني انعتاقاً من جاذبية نقطة المركز، ولا التنقل بين الخانات يمكن أن يكون خروجاً عن رقعة شطرنج العقل العربي الإسلامي الذي يبقى يصدر عن نظام إبتسمي واحد مهما تمايزت عبقريات الأشخاص وعبقريات الأماكن.+++هذا الكتاب، إذ يرفض التوظيف الأيديولوجي الإقليمي لمفهوم القطيعة الإبتسمولوجية، يتوسّل حفريات المعرفة الحديثة ليعيد بناء وحدة الفضاء العقلي للتراث العربي الإسلامي، وليقترح قراءة اتصالية – لا انقطاعية – للإسهامات المميزة للمدرسة الأندلسية، سواء أتمثلت في مقاصدية الشاطبي، أم عرفانية ابن طفيل، أم الانتفاضة النحوية لابن مضاء القرطبي. وهذا، بالإضافة إلى إعادة فتح ملف الفلسفة المشرقية لابن سينا واقتراح حل جديد للغزها.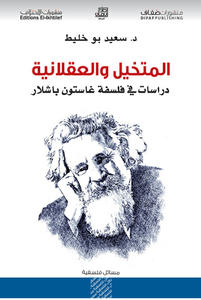
المتخيل والعقلانية دراسات في فلسفة غاستون باشلار
يشكل هذا الكتاب دراسات في فلسفة غاستون باشر، وهي تعمل على تفكيك الأساس النظرية و المفهومية لمشروع باشر النقدي من خلال متابعة الأعمال التي أنجزها، حيث أعاد باشر النظر في مجموعة من المقولات ، كما لفت النظر إلى أخر. وأسس على مستوى مجلات البحث طرائق اخرى في التفكير. وبالفعل، شكلت المقاربة الباشلارية مسوغا نظريا و منهجيا لنحت أدوات مفهومية مكونت صيرورة العلم من إيجاد انفتاحات جديدة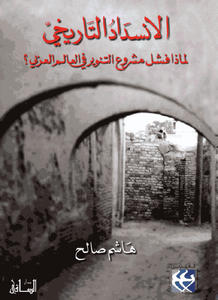
الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟
المسائل المطروحة في هذا الكتاب تمثّل عناوين المأزق العربي، ومحور اهتمام الباحثين والمحللين الاستراتيجيين والقراء والمتابعين. ولعل الخطورة تتمثل في كون هذه المسائل أكثر ارتباطاً بوجود العرب ومصيرهم وتقدمهم ومستقبلهم، ويتوقف على حلها مسار العالمين العربي والإسلامي، وموقفهما من تحديات العصر وإشكاليات الديموقراطية والحداثة والغرب والإسلام والمرأة والعولمة والانفتاح. يشخص هذا الكتاب أمراض المجتمع العربي، ويضع الإصبع على المشكلات التي أعاقت محاولات الاستنهاض، وأدّت إلى فشل الإصلاح الديني في الإسلام بينما نجح في المسيحية. ويشرح أسباب الانحطاط الحضاري في العالمين العربي والإسلامي، وتحوّل الإرهاب إلى وباء أصولي يهدّد المجتمعات. كذلك يتطرق إلى ظاهرة التهجم على المقدسات وحرية التعبير في الفكر الأوروبي، وإلى أنماط المثقفين العرب، والفهم الأصولي للدين ومسبّبات الانسداد التاريخي، وإلى الحضارة الحديثة والرؤية الأصولية للعالم.
المفهوم الفلسفي عند جيل دولوز
ينظر هذا الكتاب إلى جيل دولوز بصفته فيلسوفًا شديد الفضول، يهتم بكل ما يشكله حاضره وينتجه عصره؛ إذ وجه جلّ فكره نحو القبض على مساحة حدْثية مرآوية، طاويًا سحر كتابته لتجاوز الأماكن الفارغة من المعنى. وقع الاختيار على المفهوم الفلسفي عنده لأنه أكثر الفلاسفة اشتغالًا على المفاهيم الفلسفية، من خلال حواراته مع كبار الفلاسفة. يطرح هذا الكتاب جملة تساؤلات، منها: ما الطريقة التي توسلها دولوز في قراءته التراث الفلسفي؟ كيف تشكل النص الدولوزي؟ ما الخيط الناظم في الكتابة الدولوزية بين الآداب والفلسفة؟ ما علاقة الفلسفة بقطاعات أخرى كالعلم والفن والأدب؟ ما السبيل إلى الخروج من الخواء، والظفر بالاتساق والتماسك؟ ويسعى إلى الإجابة عنها من خلال إقامة مناظرات بين دولوز وفلاسفة آخرين، كأفلاطون وأرسطو وديكارت وكانط وهيغل ونيتشه وهايدغر وغيرهم.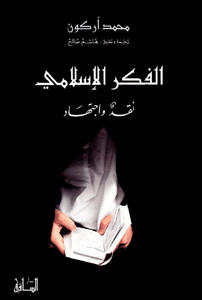
الفكر الإسلامي
مساهمة تجديد من محمد أركون في مجال الفكر العربي والإسلامي، ركيزتها الفحص والنقد وسبر أغوار الحدث في مساره التاريخي وعلى ضوء معطيات معاصرة. وتزداد أهمّية المحاولة حين يُنظر إليها من منظور ما نشهده الآن، حيث الاهتزاز والاضطراب والتساؤل.+++الكتاب يضع القرآن في مواجهة الصيغ النظرية للفكر الحديث هادفاً من ذلك إلى إنشاء رؤية نقدية في ميادين العلوم الإنسانية، بما يتجاوز التفاسير المتداولة.+++فالمطلوب، في عرف الباحث، إعادة تحديد المفهوم الغربي ذاته بصفته فضاءً تاريخياً وثقافياً. وإعادة التحديد تتعدّى المثال الإسلامي لكنّها، في رأيه، تتمّ بفضل هذا المثال.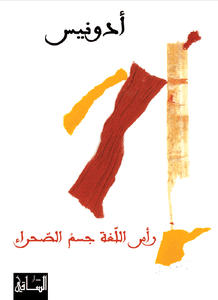
رأس اللغة جسم الصحراء
مقالات، أفكار، تأملات، رؤى في غيب الواقع وروح الغيب، تمتد من رأس اللغة إلى جسم الصحراء. +++ يستنطق أدونيس وجوده المثنى: ذات المثقف في مقابل المكان والزمن. +++ بذكاء الناقد والمفكر وحدس الشاعر المتغرّب يقرأ: الغربة، الذاكرة، الواقع، المنفى، الدين، السياسة، الأدب والشعر... علّه يفصح بالنثر ما اختزله بالشعر.
نظرية التطور وأصل الإنسان
تُرَاوِدُ الإنسانَ — منذ أن وُجِدَ على ظهر الأرض — أسئلةٌ كبرى، أحدُ هذه الأسئلة سؤالُ الأصل أو المركز أو ما كان يُطلِق عليه الإغريق «اللوجوس»، واختلف البشر فيما بينهم في الإجابة على هذا السؤال؛ فرَدَّهُ الملاحدة إلى الطبيعة/المادة، ورَدَّهُ أهل الدِّين إلى الخالق. وتُعَدُّ نظرية التطور نظريةً فلسفيةً بيولوجيةً، ذات أُسُسٍ مادية طبيعية، ترد الإنسان إلى أصل مادي. وهي إحدى النظريات الكبرى التي حققت ذيوعًا كبيرًا في الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبرغم اقتصار داروين على استخدام النظرية داخل الحقل البيولوجي، إلا أنها تحولت إلى فلسفة ورؤية للعالم تَأَسَّسَ عليها تراث لا يُستهان به من العلوم الاجتماعية والطبيعية على حَدٍّ سواء.
أصل التفاوت بين الناس
يعدُّ هذا الكتاب من الكلاسيكيات الفلسفية والاجتماعية العالمية، وهو مَعِيْنُ فكرٍ فلسفي متجدد للمتخصصين في الفلسفة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية؛ لما له من أهمية مفصلية في ترسيم حدود فاصلة يُبنَى عليها التفكير في نشأة التفاوت الاجتماعي والصراعات المترتبة عليه. ويهتم هذا الكتاب بإجلاء مبادئ الديمقراطية السياسية القائمة على إرساء قواعد الاشتراكية التي دعا إليها روسو. ويحمل هذا الكتاب تأملات الإنسان التي تُستلهَم من طبيعته المتجردة التي تحمل في طَوِيَّتها جوهر الأصالة في التكوين الإنساني، وذلك من خلال دراسته للإنسان، وحاجاته الحقيقية. ويشتمل الكتاب على وصف خيالي لحال الإنسان الذي تكبله الأغلال في كل مكان، كما يعلِّل الفساد القائم بين البشر بالتفاوت بين أفراد المجتمع في المعاملات. ومَنْ يقرأ هذا الكتاب يدرك أنه أمام نصٍّ فلسفيٍّ فريد استطاع أن يفرض نفسه لثلاثة قرون على الفكر البشري.
تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب
ترجع فكرة تأليف هذا الكتاب إلى نحو عشرين عامًا مضت، منذ كنت أتلقى العلم في مدرسة ليون الجامعة، وفي تلك المدينة الجميلة المطمئنة، دونت أوائل تلك الفصول، وقد صحبتني الأماني و«الكراسات» في سائر أسفاري بين ليون وجنيف ولندن وفيرنزة (فلورنسا)، ومرت علينا معًا فترة الحرب العصيبة وأنا في صحبة هؤلاء الفلاسفة الاثني عشر، ننهض تارة ونرجو رؤية النور والضياء، وطورًا نرقد في مثار النقع نسمع صدى صوت المدافع في الفضاء. إلى أن شاءت الأقدار أن يلبس هؤلاء الحكماء المتقدمون ثياب الظهور في عالم الوجود المادي، فلم أشأ أن أطيل حبسهم فأسلمت بيدي تلك الأوراق، التي أصبحت في نظري «معتقة صفراء» دقيقة الجسم ضخمة البخار، وهكذا برز إلى عالم البعث والنشور اثنى عشر(3)(*) فيلسوفًا من المشارقة والمغاربة، وقد تدثر كل بالقباء أو المرقعة أو المسوح أو الدراعة أو الجبة التي تليق به لدى مثوله بين أيدي قراء هذا الزمان.
أحلام الفلاسفة
يضم هذا الكتاب بين دفتيه أروع أحلام فلاسفة العالم، إنه الحلم الذي يحيا من أجله الإنسان حتى الآن «اليوتوبيا» أو «المدينة الفاضلة». ذلك الموضوع الذي أُثير منذ أمدٍ بعيد؛ فقد ابتدأه «أفلاطون» في العصور القديمة ثم «توماس مور» في عصر النهضة، وتوالت الأحلام والأفكار حتى الآن، كلٌّ منهم يؤسس مدينته ويضع أسس نظامها، وقد اختار هؤلاء الفلاسفة النظام «التضامني»، فتارة يكون هناك اشتراك فى ملكية رأس المال، وتارة أخرى نراه اشتراكية في مواجهة الثورة الصناعية، ثم شيوعية في مواجهة الرأسمالية، وأخيرًا يجيء الحلم المصري «خيمى» الذي يسعى فيه «سلامة موسى» أن يؤسس يوتوبيا مصرية. حقًّا اختلف الفلاسفة في تحديد اسم المدينة، ولكنهم اتفقوا في الحلم.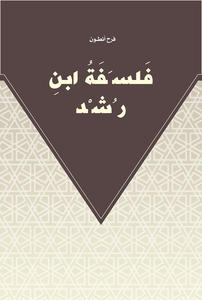
فَلسَفَةُ ابنِ رُشْد
يستعرض فرح أنطون في هذا الكتاب فلسفة «ابن رشد» من حيث مصادرها، وبنيتها، ومجال تأثيرها الذي امتد ليشمل الشرق والغرب، وكان سببًا في النهضة الأوروبية الحديثة، حيث استفاد القديس «توماس الأكويني» من أفكار «ألبرت الكبير» الذي تعلم من خلاله الفلسفة الرشدية، والتي استطاع بها الأكويني أن يتجاوز العقبة الكأداء التي كانت تؤرق الفكر الأوروبي، وتحكم العقل الجمعي الأوروبي إبان هذه الفترة، وكانت هذه العقبة تتمثل في رأي الأوروبيين المسيحيين في التعارض بين الحقيقة الإلهية والحقيقة العقلية؛ لذلك كانت الفلسفة وكثيرٌ من العلوم تعد كفرًا، فجاءت فلسفة ابن رشد وكتاباته لتؤكد على أن هذا التعارض ظاهري، ويكون عادة إما نتيجة للقصور في فهم الواقع، أو عدم الفهم الحقيقي للنص، وهو ما مهد بعد ذلك لقيام عصر النهضة الأوروبي.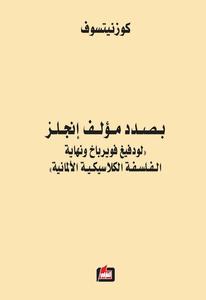
بصدد مؤلف إنجلز
فضلاً عن مؤلفات ماركس وإنجلز ولينين، تصدر دار “التقدم” كراريس مبسطة عن مؤلفات إعلام الماركسية-اللينينية. والكراس الذي كتبه الفيلسوف والكاتب الاجتماعي والسياسي السوفياتي فاسيلى كوزنيتسوف عن مؤلّفَي “لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية” يعرض ظروف وأسباب كتابة هذا المؤلف، ومكان الفلسفة الكلاسيكية الألمانية التاريخي ودورها في نشوء النظرية الماركسية، ويكشف جوهر الانقلاب الثوري الذي قام به ماركس وإنجلز في ميدان الفلسفة.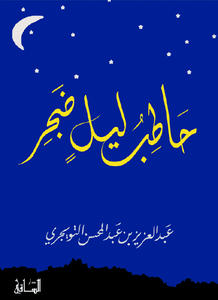
حاطب ليل ضجر
لمن سيقرأني في هذه الرسائل قد يراني، أو لا يراني، متوارياً خلف جُدُر نفسية، وهذا الاحتمال بأن يكون لي قارئ لا أبنيه على فلسفة تعرض نفسها على الطريق العامة، ولكني بقدر طاقتي واحتمالي حاولت أن أبني على هذه الأوراق صوراً أثقلت كاهلي فقلت لها: تحولي عنه إلى خارج البيت الذاتي! فمَن لا يرْمِ أثقاله وهمومه عن عاتقه في مثل هذا الهذيان الذي لا يعني غير كاتبه، فقد يتآكل في ذهنه وعقله وتفكيره كل جميل في هذه الحياة ويصير إلى جذع يبس وتخشّب لا ظل له فيطرحه لتستريح فيه ذاته من طول السفر...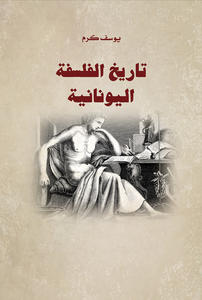
تاريخ الفلسفة اليونانية
«الفلسفة» هي حياة اليوناني القديم، الذي ترجم حياته وأولوياته بناءً عليها؛ فقد أرجع كل شيء إليها، كما أنه لم يُبدِع في شيء مثلما أبدع في الفلسفة والأدب. وقد قدمت لنا الفلسفة اليونانية أعظم الفلاسفة على الإطلاق؛ فهم الذين وضعوا بذرة الفلسفة للعصر الحديث، فقد وضع هؤلاء الفلاسفة المبادئ الأولى للفلسفة، ولكنهم أيضًا لم يأتوا من العدم؛ فثَمَّة إرهاصات كانت بمثابة بصيص من النور الذي حوَّلَهُ فلاسفة اليونان إلى شعلة حملوها ليضيئوا بها شمس الحضارة الإنسانيَّة. وهو ما التقفَه الفلاسفة المسلمون والأوروبيون على حدٍّ سواء؛ ليستكملوا مسيرة العلم التي لا تنتهي أبدًا. وقد حدَّد لنا يوسف كرم الأُطُر الأساسية التي قامت عليها الفلسفة اليونانية منذ فجر التاريخ، وحتى انتهاء دور الفلسفة اليونانية، ليبدأ طَوْرٌ جديد من الفلسفة السكندرية والمدرسية.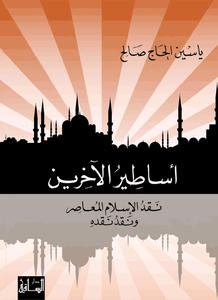
أساطير الآخرين
يتناول هذا الكتاب المسألة الإسلامية، أي الأسئلة الأخلاقية والفكرية والسياسية التي يثيرها وضع الإسلام في العالم المعاصر. ويحاول فتح الإسلام للتفكير والنظر والمساءلة، أو تحويله إلى موضوع ثقافي. وذلك اعتراضاً على القطيعة بين الإسلام والتفكير النقدي الحديث والمعاصر. وبينما تصدر مواد الكتاب عن مقدّمات وانحيازات علمانية، لم يجامل الكاتب طروحات علمانية رائجة، تبدو له وجهاً آخر لطروحات الإسلاميين الأكثر تشدّداً. يطوّر المؤلف فهماً تاريخياً للإسلام المعاصر النافي لتاريخيته. ويعتبر أنه متشكّل وفقاً للحداثة، وإن كان معترضاً عليها أيديولوجيا. ويظهر كم أن مشكلات الإسلام المعاصر وثيقة الصلة بمشكلات المسلمين المعاصرين الاجتماعية والسياسية، وإن كانت لا تختزل إليها بالكامل. ويخترق الكتاب همٌّ إصلاحي. يدافع بقوة عن حرّية الاعتقاد الديني باعتبارها شرطاً لقيام مفهوم الدين ذاته، وبالتالي لاتساق العقل. ويزكّي تصوراً غير مألوف للإصلاح الإسلامي، قائماً على تحرير ووحدة السلطة الدينية الإسلامية وتقويتها، مقابل تبعثرها الحالي وتبعيتها للسلطات السياسية. كما يبلور مفهوماً للعلمانية بوصفها فصلاً للدين عن السيادة، أي الإكراه والولاية العامة، وليس عن السياسة ذاتها.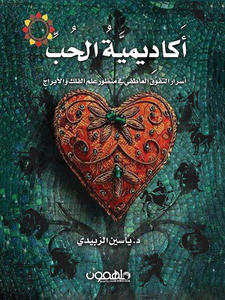
أكادمية الحب
يتحدث الكتاب عن اساليب التواصل الفعال والايجابي مع الشريك في منظور علم الفلك السايكولوجي. وينقسم الكتاب الى قسمين الاول يعنى بشرح الاساليب الفعالة للتواصل مع المرأة عبر شرح ستون موقف حياتي واقعي لمختلف الانماط النسوية. في حين يعنى القسم الثاني بالتعامل مع الرجل ضمن اطار المواقف الحياتية الواقعية لمختلف انماط شخصية الرجل. ان طبيعة عملي في التدريس الاكاديمي جعلتني اكتب الكتاب بشكل محاضرات يستطيع من يقرأها بتمعن ان يخطو بثقة الى هدفه، فقد كتبتها باسلوب يشابه الى حد ما طريقتي في القاء المحاضرات، فعندما ابدأ محاضرة في موضوع جديد فانني احاول ان اشد انتباه الطلاب عبر تقديمي الموضوع عن طريق طرح الاسئلة التي تستفز التفكير وتدفع الانسان الى اسلوب العصف الذهني من اجل ان يقدم ارائه ويجعلها تتفاعل مع طروحات المحاضرة وموضوعها، وبعد ذلك ادخل في تفاصيل المحاضرة محاولا ربطها بالجانب الواقعي والعملي من حياة الطلاب لانهيها بعد ذلك بخلاصة لما تم شرحه. وكذلك الحال في كتابتي لاكاديمية الحب، فقد اخترت خمس اسرار مؤثرة لكل برج من الابراج ممكن لمن يتأملها او يفقه فحواها ان يحصد علامة مميزة في امتحان الحب، سُبقتْ هذه الاسرار او الدروس بمقدمة تعريفية لطبيعة البرج سواء للمرأة او للرجل مع اسئلة تستحث التفكير من اجل استكشاف البرج الذي ساشرح عنه وعن كيفية التقرب اليه، وبدلاً من ان اعطي القارئ نصائح جافة، ارتأيت ان اعطيه مثالا حيا لقصة حدثت معي او مرت باحد اصحابي او معارفي تبين له اسلوب التصرف السليم الذي يحاكي عواطف المقابل، ثم بعد ذلك احاول ان الخّص ما سردته عبر افكار واضحة بجمل قصيرة. حتى اذا ما استطاع القارئ ان يتفهم النصيحة والاسلوب المثالي للتعامل عندها يستطيع ان يبتكر اسلوبه الخاص الذي يقربه من محبوبه وفق المنظور العام الذي رسم في هذا الكتاب.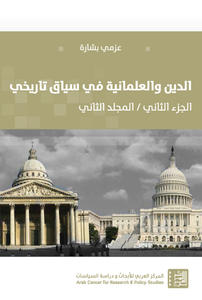
الدين والعلمانية في سياق تاريخي: الجزء الثاني / المجلد الثاني
يُقسم هذا المجلد ثلاثةَ أقسام، نتناول في القسم الأول النماذج التاريخية والمقارنة بينها من عدة زوايا؛ وفي القسم الثاني نتناول بالفحص والنقد نظريات العلمنة، كما ننتقد نقدها أيضًا من خلال مقاربات تتداخل فيها بين العلوم الاجتماعية وعلم التاريخ. أما في القسم الثالث فنعالج توليد العلمنة لنقيضها أكان ذلك على مستوى عودة الديانات التقليدية إلى القيام بدور في المجال العام أم بنشوء الديانات السياسية وأشباه الديانات البديلة كجزء من عملية العلمنة ذاتها. وأخيرًا نطرح تصوّرَنا لأنموذج معدّل أكثر تركيبًا لنظرية العلمنة. وهذه الجدة هي نتاج مقاربتنا المختلفة لتاريخ الأفكار في المجلد الأول من الجزء الثاني، وللصيرورة التاريخية ولنماذج العلمنة المختلفة أيضًا. نقدّم هنا ملخصًا مقتضبًا لما جاء في فصول هذا الكتاب. ويتكرر في بداية كل فصل للتسهيل على القارئ. ونرى أن يطّلع عليه من يرغب في قراءة الكتاب لأنه يساعده في فهم خريطة النص وموقع كل فصل فيه، لكن الاكتفاء به يوقع القارئ في أخطاء. وكما هو معروف فإن الهيكل لا يكفي للتعرف إلى شخصية صاحبه. ولا يمكن معرفة ما نريد قوله في هذا الكتاب من دون قراءة النص.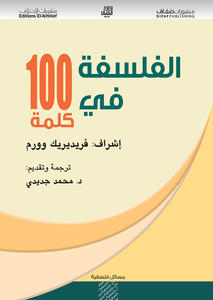
الفلسفة في 100 كلمة
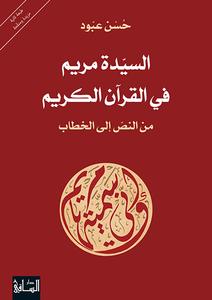
السيدة مريم في القرآن الكريم
أول قراءة أدبية تقدّم رؤية القرآن الكريم للأنثوي والأمومي من خلال صورة السيدة مريم. وهي تصدر في هذا الوقت الحساس من تاريخ صراع الإسلام لإحياء ذاته وللتحديث. تعدّ شخصيّة مريم نموذجاً فريداً. ليست فقط شخصيّة مسيحية مباركة تُستدعى لأهمية الحمل بـ ;الكلمة;، لكنّها أيضاً الأنثى التي تُستدعى لأهمّية الخصوبة عند العرب. تعرض المؤلّفة آراء المفسّرين المسلمين بنبوّة مريم بين مثبت ونافٍ. وتقرأ سورة مريم وقصّتها في القرآن، على التناصّ مع صورتها وقصّتها في الموروث المسيحي. وتزعم مركزية اللقاء الكبير بين الديانتين في شخصيّة مريم. يفتتح هذا الكتاب حقلاً جديداً في دراسة السورة القرآنية كخطاب، وفي منظور النقد النسوي ومعيار ;الجندر; للتحليل.
السلف المتخيل: مقاربة تاريخية تحليلية في سلف المحنة؛ أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل المتخيل
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب رائد السمهوري السلف المتخيل: مقاربة تاريخية تحليلية في سلف المحنة؛ أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل المتخيل، ويحاول الباحث فيه أن يجيب – كما أوضح في مقدمته – عن السؤال: "هل مفهوم السلف يعبّر عن جماعة حقيقية أم متخيّلة؟"؛ إذ دائمًا ما يُحتَجُّ بالسلف الصالح وأفعالهم على الإطلاق، من دون تمييز بين متفق عليه وهو موطن إجماع، ومختلف فيه وهو محل نظر واجتهاد. ويتخذ الكاتب ما يسمّيه "سلف المحنة" أنموذجًا لدراسته، ويعني المؤلف بـ "سلف المحنة" السلف الذين احتجّ بهم الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن، كما يعني بهم كذلك أحمد بن حنبل ذاته من حيث هو نفسُه سلفٌ لأهل السنة باختلاف مذاهبهم الفقهية. يتكون الكتاب (450 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة، وتمهيد، وبابين؛ يتألف أولهما من فصلين، والثاني من ثلاثة فصول. في السلف ومفهومه في مقدّمة الكتاب، يوضح السمهوري أهدافه من الكتاب، ويستعرض منهجه فيه، والأسئلة التي يروم الإجابة عنها، مبينًا أن معنى المتخيّل ليس هو الكذب والدجل، لكنه "إعادة التمثل"، و"إعادة الإنتاج"، و"الإسقاط"، "والانتقاء"، بحسب الأحوال والظروف والسياقات، منبهًا إلى أهمية الجانب التاريخي في دراسة الأفكار والمذاهب والعقائد، ومشيرًا إلى أن المحنة (أي محنة خلق القرآن) لم تكن دينية الاتجاه، وإن لبست لبوس المذاهب والعقائد، لكنها، بحسب وجهة نظره، نتاج صراع اجتماعي – سياسي، بين العرب/ بغداد/ الأمين، والعجم/ خراسان/ المأمون، مثنّيًا بتناول أهم الدراسات والكتب التي تناولت شخصية أحمد بن حنبل، والحنابلة، ويوجه فيها نقده لما يستحق النقد. ينتقل المؤلف بعد هذا إلى تمهيد بعنوان "مفهوم السلف: قراءة دلالية تاريخية"، خصصه لبحث معنى "السلف" في اللغة والاصطلاح، مؤرخًا بداية ظهوره وانتشاره ومعانيه وموطنه من "الاحتجاج الديني"، معتمدًا على التفريق الأصولي (أي في منهج أصول الفقه الإسلامي) بين ما هو "إجماع" قطعي معتدّ به شرعًا وواجب الالتزام، وما يقع في دائرة الاختلاف السائغ الاجتهادي، وكيف يجري الخلط بين هذين النوعين من الاحتجاج تحت غطاء "السلف". ويعرّج على مفهوم "خير القرون"، مثبتًا أن هذه الخيرية هي خيرية أخلاقية مستشهدًا بالنصوص الشرعية وأقوال الفقهاء والمحدّثين. الطريق إلى سلف المحنة في الباب الأوّل، "رحلة المتخيل: في الطريق إلى سلف المحنة"، يسيح السمهوري سياحة تاريخية في أبرز الحوادث التاريخية التي سبقت المحنة في الفصل الأول الذي عنونه "عصر بني العباس: الدعوة والدولة"، وأن الدولة العباسية نشأت بدافع من الثأر الذي يلفت الانتباه وروده بكثافة في كتب التاريخ على ألسنة العباسيين ودعاتهم، أي الثأر من الأمويين ومن كل ما يمثلهم، ليفيض في شرح بدء انطلاق الدعوة العباسية في خراسان التي كانت موطن الدعوة العباسية وشيعتها، وفيها ظهر شعارهم الرسمي "الرايات السود واللباس الأسود"، وأن دعوتهم كانت تقوم على "التشيع" لآل البيت، مع شيء من مذهب الجهم بن صفوان الذي كان داعية من دعاة العباسيين، مع ميل إلى فقه الرأي. في مقابل ذلك، يتحدث عن بغداد وعن سلطة أهل الحديث فيها وظهور مصطلح "أمير المؤمنين في الحديث". فلئن كانت خراسان هي أرض الدعوة العباسية التي انطلقت منها وكان فيها أنصارها ودعاتها وأولياؤها، فإن بغداد هي موطن أهل الحديث وعاصمتهم، وكان لهم فيها المنعة والقوة والتأثير، في سرد تاريخي يستعرض أهم الحوادث حتى وقت الفتنة بين المأمون (كان في خراسان، وأمه خراسانية، وأخواله خراسانيون، ومال إلى مذهب التجهّم في العقائد، والرأي في الفقه)، وأخيه الأمين (أمه عربية هاشمية هي زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، ومال إلى مدرسة أهل الحديث). يصل المؤلف بعد هذا السرد إلى محنة خلق القرآن ودور أحمد بن حنبل فيها، بوصفه من أعلام مدرسة أهل الحديث وأئمتها. يؤرخ السمهوري في الفصل الثاني، "لحظة الانفجار وبداية نشوء سلف المحنة"، بداية المحنة وإرهاصاتها في عهد المأمون، ثم اشتدادها في عهد المعتصم، ثم تفاقمها في عهد الواثق، مسلطًا الضوء على موقف أحمد بن حنبل وصموده، معتمدًا على الروايات التاريخية الحنبلية التي رواها شهود العيان من أقدم المصادر المتاحة، ومقارنًا بينها وبين روايات المعتزلة. ابن حنبل وابن حنبل المتخيّل ينتقل الباحث إلى الباب الثاني، "سلف المحنة: أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل المتخيّل"، ليبين الفروق بين الروايات الأولى للمحنة في عصرها، ثم كيف أضيفت إليها روايات تعتمد الخوارق والمبالغات كلما امتدّ الزمن، معتمدًا على المنهج الحديثي لعلماء محدثين كبار من أمثال الذهبي ومحمد بن إبراهيم الوزير ليبين الصحيح من المكذوب في سرد أخبار المحنة. في الفصل الثالث، "أحمد بن حنبل وتأسيس سلف المحنة"، تناول المؤلف شخصية أحمد بن حنبل وأهم صفاته، كما تناول مشروعه العلمي، وأهم معالم منهجه في الفتاوى والاستنباط، وموقفه من المختلفين مذهبيًا من الفرق المخالفة؛ كالمرجئة، والشيعة، والجهمية، وغيرهم. في الفصل الرابع، "تأبيد سلف المحنة: أحمد بن حنبل المتخيّل"، عمد الكاتب إلى تأريخ بداية نشوء وضع الأخبار الخيالية على أحمد بن حنبل، مما لا يصحّ حديثيًا، ونسبة أقوال في العقيدة إليه ليست مما يمكن الجزم به، مسلطًا الضوء على كتابين اعترض عليهما بعض كبار المحدثين؛ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، والرسالة الموسومة "باب القول في المذهب" التي ألفها حرب بن إسماعيل الكرماني، وهي منسوبة إلى أحمد بن حنبل، لكنه ليس مؤلفها. هذان الكتابان مصدران لأحمد بن حنبل متخيّل، ليس بحقيقي. وفي الفصل الخامس والأخير، "تعدد المتخيل: مرحلة البربهاري وما بعده إلى ما قبل ابن تيمية"، يرصد الكاتب تطورات المذهب الحنبلي، واختلاف الحنابلة في فهم كلام الإمام أحمد بن حنبل في العقائد، فالحنابلة تيارات متعددة، وبينهم اختلافات في باب العقائد، وهناك من يعتمد منهج التفويض، وهناك من يعتمد منهج التأويل، وهناك من يقبل ظواهر النصوص. كما يرصد الباحث علاقة الحنابلة بالتصوّف، وبعلم الكلام.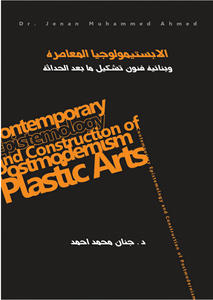
الابسنيمولوجيا المعاصرة
يعرف عصرنا بعصر العلم والتكنلوجيا بتفاصيله الدقيقة، وبما يطرحه من مشكلات نظرية وعملية تسهم في رفد المعرفة العلمية وأساليب التفكير العلمي، حتى بات العلم والنظرية العلمية المهيمن الرئيس على كل حياتنا، ولأن الأبستيمولوجيا المعاصرة التي شهدها العقد الأول من القرن التاسع عشر تُعَد المدخل لمقاربة مجمل القضايا الفكرية بوصفها نظرية المعرفة العلمية التي أسهمت في إثراء وإغناء تطور الفكر العلمي من جهة، والعمل على نشر المعرفة العلمية على نحو واسع من جهه اخرى، التي تقوم ايضا توصيفا لحركة الفكر والنتاج الفكري المنضبط الموجه، ومن ثَم تحليله وتقييمه وتقويمه على مستوى التحليل العلمي.
المعجزة أو سبات العقل في الإسلام
يسلّط هذا الكتاب الضوء على آليّة داخلية لاستقالة العقل في الإسلام، ولكنّه يبقي الباب مفتوحاً أمام إعادة قراءة قرآنية يمكن معها للإسلام أن يتصالح مع العصر ومع الروح العلمي الحديث. +++ ما ميّزالإسلام القرآني عن المسيحية الإنجيلية واليهودية التوراتية هو غياب المعجزة النبوية: فليس في القرآن من معجزة سوى القرآن نفسه بوصفه معجزة عقلية غير مادّية. ولكن في سياق المنافسة مع الديانتين التوحيديتين القائمتين على برهان المعجزة النبوية الحسّية، ومع الفتوحات التي أدخلت إلى الإسلام أمماً شتى غير ناطقة بالعربية، لم تعد المعجزة البيانية العقلية القرآنية كافية وحدها لتثبيت الإيمان. وهكذا نُسبت إلى الرسول معجزات مادّية راح يتضخّم عددها قرناً تلو القرن حتى قدّرها كتّاب السيرة المتأخّرون بثلاثة آلاف معجزة. +++ ومع هذا التحوّل المتأخّر للإسلام إلى دين معجزات، ومع تعميم الاعتقاد بإمكانيّة الخرق الذي لا ضابط له للقوانين الصغرى والكبرى للحياة والطبيعة والكون، دخل العقل في مرحلة سبات، وغابت عن أفق الحضارة العربية الإسلامية إمكانيّة ثورة كوبرنيكية تنقلها من جمود القرون الوسطى إلى دينامية الحداثة وفتوحات العقل العلمي.
نقد العقل العلماني
يقدم هذا الكتاب دراسة مقارنة بين عبد الوهاب المسيري في نقده العقل العلماني وأسسه المعرفية في التراث الغربي، وزيغمونت باومان، وهو ليس بحثًا عن أدلّة مادية موضوعية تثبت "السرقة الفكرية" والتأثر الصريح الذي لا ينكره المسيري، بل كيفية صوغ النماذج التفسيرية الرئيسة وتوظيفها في نقد هذا العقل والحداثة، حيث يتجلى التقاء الخطاب النقدي عند باومان (اليهودي) والمسيري (المسلم) في أنموذجين أساسيين: الحداثة الصلبة (العقلانية المادية) والحداثة السائلة (المادية اللاعقلانية). كما يسعى هذا الكتاب إلى استكشاف الخرائط الإدراكية للحداثة الغربية والعقل العلماني عند باومان والمسيري، لأن كلًّا منهما يرى الحداثة العلمانية رؤية معرفية شاملة لله والإنسان والطبيعة، ويستخدم النماذج التفسيرية والصور المجازية نفسها لكشف هذه الرؤية، وإن اختلفا في وصفات الخلاص من مأزق الحداثة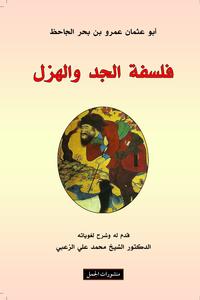
فلسفة الجد والهزل
هذه الرسائل الأربعة يشملها اسم (رسائل في الأخلاق المحمودة والمذمومة) أرسلها أبو عثمان ابن أبي دؤاد وابن الزيات لتكون دستوراً أخلاقياً ومصباحاً اجتماعياً يستضيء به هذان الوزيران ومن نهج نهجهما في تدبير الممالك، إذ الأخلاق، كما يراها علماء الأخلاق سارية يرتفع عليها علم الأمة ما زالت قوية مدعمة بالمكارم وينخفض ويهيض جماحها ما جنحت وتنكبت النهج القويم والصراط المستقيم.