
البيئة الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
يتناول كتاب "البيئة الصينية" الوضع البيئي في الصين، والتركيز على التنمية والتقدم في مجال حماية البيئة بالصين. ويقوم الكتاب بعرض وصف مفصل للنظم الإيكولوجية الطبيعية والتنوع البيولوجي والسيطرة على التلوث ومكافحته والبيئة الحضرية والريفية بالصين وغيرها من الجوانب، كما يتناول الكتاب أيضا الإنجازات التي حققتها الصين في مجال حماية البيئة، ويعكس أيضا المشاكل البيئية الموجودة في الصين. ويستخدم هذا الكتاب الكثير من البيانات والحقائق المتنوعة، فضلا عن الاهتمام بالعلمية وسهولة القراءة.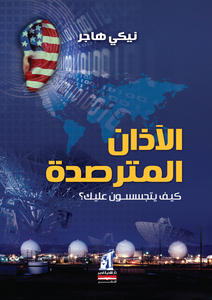
الآذان المترصدة
حينما تقرأ هذا الكتاب ستعلم أنك جزء من هذا الكون الخاضع لعمليات تجسس واسعة يقوم بها النظام الأمريكي المهيمن على العالم، لحلفائه قبل أعدائه. وستعلم كيف تتم علميات التجسس عبر البريد الألكتروني والمكالمات الهاتفية والفيسبوك والتليكسات وغيرها.. للأفراد كما للدول والمنظمات، بما فيها الكيانات المعروفة بولائها للولايات المتحدة وحلفائها مثل الأمم المتحدة. وستدرك أن تسريبات "إدورد سنودن" الموظف بوكالة الأمن القومي الأمريكية المتعلقة بتجسس أمريكا على العالم، ما هى إلا جزء صغير من معلومات تم إعلانها ثم توقف الحديث فيها بأوامر من القوة العظمى الحاكمة لهذا العالم. ليس هذا فحسب... حيث يكشف هذا الكتاب حقيقة منظمة "إتشليون" بدولها الخمس والقابعة في نيوزيلندا لمتابعة دبيب البشر وأسرارهم وأدق تفاصيل علاقتهم، عبر كل الوسائل المتاحة ومن خلال العديد من محطات وأقمار التجسس المنتشرة بعناية فائقة في كل بقاع العالم. إنهم يتجسسون عليك .. فاعرف كيف يتم ذلك.
القوميات والأديان الصينية (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية)
تُعد الصين إحدى الدول الموحدة متعددة الأعراق، حيث تحتوي الصين على العديد من الأديان المختلفة. وقد جمعت الاتصالات الوثيقة والاعتماد المتبادل والاندماج والاشتراك في السراء والضراء بين أبناء القوميات الصينية المختلفة منذ زمن بعيد، بحيث تشكلَ نمطاً من التنوع الموحد للأمة الصينية، وهكذا استطاعت القوميات الصينية المختلفة خلق حضارة صينية عريقة ورائعة. وتلتزم الصين الحديثة بالعديد من السياسات القومية التي تتمثل في المساواة والوحدة والمساعدة المتبادلة بين القوميات، واحترام وحماية حقوق الحريات الدينية لكافة القوميات، كما عززت من الائتلاف والوئام بين شتي أبناء الصين من مختلف القوميات، إلى جانب تعزيز التنمية الشاملة للأقليات القومية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.
المجتمع الصيني (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية) (باللغة العربية)
لن يمكن حصر هذا العملاق الضخم المتمثل في المجتمع الصيني في مثل هذا الكتاب الصغير، وإنما يركز الكتاب فقط على عدة جوانب ترتبط ارتباط وثيقا "بالحياة الشعبية"، حيث يقوم بشرح وتحليل النقاط الهامة المتعلقة بملامح المجتمع الصيني بكل إيجاز، وعرض أكبر التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الصيني وبعض النواحي التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الشخصية أمام القارئ. ونأمل أن تساعد هذه الأنماط البراقة التي يضمها الكتاب القارئ على تذوق بعض من الخصائص الأساسية للمجتمع الصيني. وربما تكون الصورة تلخيص للعناصر الصينية: ببعض التفصيل، يركز الكتاب على الوصف والتصوير، ولكن هناك أيضا المزيد من المعلومات التي تحتاج من القارئ البحث والاطلاع للاستفادة منها.
تاريخ موجز للمواطنية
إن هذا المسح التمهيدي لتاريخ المواطنية ومبادئها وممارستها، مبنيٌّ على التسليم بأن الأوضاع الراهنة والنقاشات بشأن المواطنية لا يمكن فهمها دون معرفة الخلفيات التاريخية. يزوّدنا المؤلف بذلك، من خلال سرد تحليلي لوظيفة المواطنية وكبار المنظرين، من ;إسبرطة; إلى الزمن الحاضر، يحتوي على مقتطفات من نصوص أساسية. كما يسأل القارئ أن يعرض كيف تتميّز المواطنية عن الأشكال الأخرى للهوية المجتمعية ـ السياسية، وذلك باستخدام الإثباتات التاريخية التي يقدمها. ويركز، بصورة خاصة، على الافتراضات الشائعة بأن المواطنية والجنسيّة هما صنوان، متشككاً في هذه المقولة، باعتماده على أسس الخبرات التاريخية والصعوبات التي تثيرها.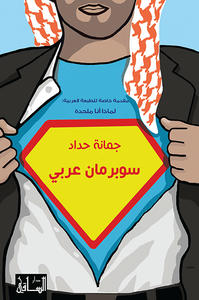
سوبرمان عربي
ليس هذا الكتاب بمانيفستو ضدّ الرجال بشكلٍ عام، ولا هو بمانيفستو ضدّ الرجال العرب بشكل خاص. ولكنّه صرخة مدوّية في وجه صنفٍ محدّد من الرجال: الرجال الذكوريين، أو أشباه سوبرمان، كما يحلو لهم تصوير أنفسهم. لكن سوبرمان مجرّد كذبة. بعد كتابها «هكذا قتلت شهرزاد»، تستكمل جمانة حداد كتاباتها المثيرة للجدل لتفضح النظام البطريركي الذي لا يسيطر فقط على عالمنا العربي بل يتعدّى حدوده أيضاً. فمن الديانات السماوية ومفهوم الزواج إلى الذكورية المتجذّرة والازدواجية السائدة في التفكير، تتوغّل في حاجتنا الماسّة إلى ذكورية جديدة في ظلّ أزمنة الثورات والتغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط.
تجديدُ الوعيِ
والكتاب مؤلَّف بقلم خبير في هذا الأمر مشهود له بالكفاءة والأصالة وسعة المعرفة ودقة النظر فيه؛ (ولا ينبئك مثل خبير)؛ هو الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم، وهو من رواد الفكر الإسلامي المعاصرين في هذا المجال.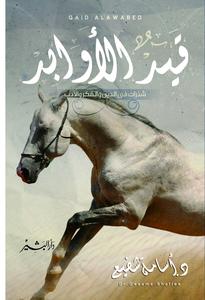
قَيْدُ الأَوَابِد
الأصل في كتابة مقدمات الكتب أنها تنطلق من شعور بالإعجاب والتقدير والمحبة للكتاب وصاحبه، إذ لا يُتَصَوَّر أن يقدم المرء لكتاب لم يعجبه موضوعه ولم يرقه أسلوبه، والحق أن هذه المقدمة تنطلق من وفرة وافرة من هذا الشعور، فالدكتور أسامة شفيع، صاحب هذا الكتاب، صديق كريم، أتيحت لي معرفته منذ سنوات، وكان له فيما مضى من حياتي أعظمُ الأثر، توجيهًا ونصحًا وإرشادًا، حتى غدا وجودُه فيها جزءًا عزيزًا أصيلًا منها.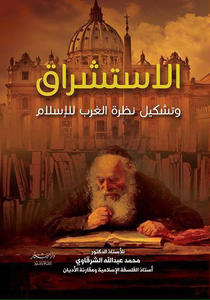
الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام
ركز هذا البحث على تتبع دراسة المستشرقين لأصول الفكر الإسلامي: القرآن والحديث لما له في ذاته من أهمية علمية، ولما للاستشراق كله من أهمية إذ أنه يمثل مستوى من مستويات الحوار بين الحضارتين الإسلامية والغربية، كما يمثل وجهًا من وجوه العلاقة التاريخية بين الإسلام والغرب، وكما أنه المسئول عن رسم الصورة النمطية المتوطنة في الغرب عن الإسلام والمسلمين، كما أنه المسئول عن تشكيل العلاقة المتوترة بين الإسلام والغرب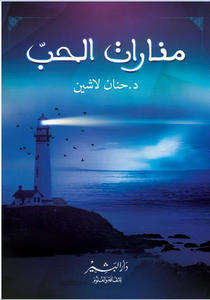
منارات الحبّ
الزواج ليس معركة فيها قائد ومقود،الزواج علاقة إنسانية جميلة تشبه السفينة في قلب المحيط الذي أحيانا تكون أمواجه هادئة وأحيانا اخري تكون أمواجه عاتيه،ولكي تبحر السفينة في خضم محيط الحياة حتي تعبر نحو شط الامان لابد من منارات تضي الطريق... ولكن منارات الحب هي البداية.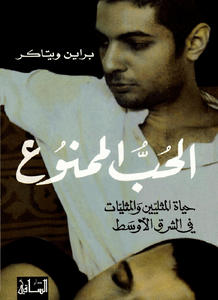
الحب الممنوع
لا تزال المثلية من المحظورات في البلدان العربية. فيما يعترض عليها رجال الدين لكونها خطيئة شنيعة، تمتنع الصحف عن الحديث عنها مباشرة وتتناولها بأسلوب يكتنفه الغموض، فتشير إلى ;ممارسات مخجلة; و;سلوك منحرف;. وبرغم القبول المتنامي للتنوع الجنسي في أماكن مختلفة من العالم، فإن المواقف منه باتت في الشرق الأوسط أكثر تصلباً. يرسم براين ويتاكر صورة أشخاص يعيشون حيوات سرية يعتريها الخوف في كثير من الأحوال، صورة أبناء وبنات يتعرّضون للضرب وتنبذهم عائلاتهم أو يرسلون لتلقي علاج نفساني ;ليبرأوا;، صورة رجال يُحتجزون ويُجلدون لتصرّفهم كالنسوة أو آخرين قد سجنوا فقط لأنهم حاولوا العثور على الحب عبر الإنترنت. في خضمّ الحديث عن إصلاح في الشرق الأوسط، تبقى المثلية إحدى المسائل التي يفضّل تقريباً معظم الأفراد في المنطقة تجاهلها، ومع ذلك ثمة حيّز ضيق من التغيير والتسامح. الحب الممنوع، المُفيض في المعلومات والمكتوب بأسلوب جذاب، يلفت إلى هذا الموضوع الشديد الأهمية وإن بعد تأخير طويل.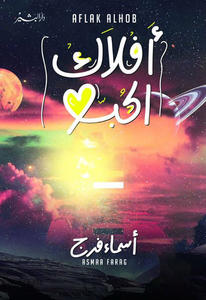
أفلاك الحب
وهكذا الحال في علاقتنا الإنسانية، فوَضَع في الإنسان غريزة الحب والاهتمام، ووضع له إطارًا ونظامًا عالميًّا لتتويجه، ألا وهو الزواج. وأرشدنا في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم إجمالًا، واجتهادات المجتهدين وخبرات السابقين كنوع من الإيضاح إلى بعض المعايير والقواعد التي تجعل الحب يدور في فلكه الصحيح مدى الحياة، وحمَّلنا نحن مسؤولية الاختيار بعد ذلك.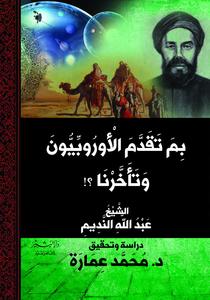
بِمَ تقدم الأوروبيون.. وتأخرنا؟
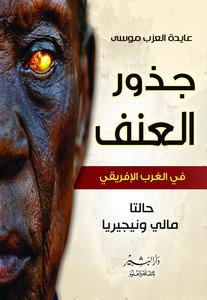
جذور العنف في الغرب الأفريقي
كانت هناك في أفريقيا قبائل وشعوب ودول متجمعة ومصنفة على أساس من الحركة الذاتية للتاريخ الأفريقي، ومبعثها الأوضاع الداخلية وتطورها وأساسها عناصر تاريخية تكونت عبر التفاعل التاريخي الأفريقي، جرى هذا الأمر طبقًا لما يتسم به الوجود الأفريقي من توازنات ذاتية بين قواه المتنوعة ولكن طبقًا لأطماع القوى الأوروبية الاستعمارية وإصرارها على السيطرة على ما تستطيع السيطرة عليه من الأراضي والشعوب الأفريقية بقوة عسكرية متطورة وبقسوة عنصرية غير مفهومة مما أدى إلى تقسيم الوجود الأفريقي أشلاء أشلاء.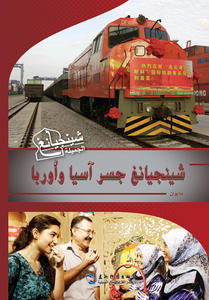
شينجيانغ جسر آسيا وأوربا (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
نبذة عن كتاب: يجمع الكتاب بين النصوص والصور، ويستعرض الكتاب صورة انفتاح شينجيانغ على العالم استعراضا حيا استنادا على مجموعة كبيرة من الأمثلة الحية والبيانات التفصيلية، ويتناول الكتاب بصورة شاملة كيفية استغلال شينجيانغ لمزاياها الإقليمية، كما يعرض الكتاب دور شينجيانغ الكبير باعتبارها جسر التواصل بين آسيا وأوروبا من خلال معارضها وموانيها وجذب رؤوس الأموال والتعاون وغيرها من الأشكال، وبالتالي حققت طفرة اقتصادية كبيرة
القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي
صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد الرحمن الشهبندر القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي، في طبعة ثانية بعد أن صدرت الطبعة الأولى في القاهرة في عام 1936. هذا الكتاب (320 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) بحسب تقديمٍ كتبه صقر أبو فخر، دراسات معمقة كان الشهبندر نشر معظمها في مجلة المقتطف القاهرية بين عامي 1934 و1935، عالج فيها مجموعة من الموضوعات الحيوية التي كان المفكرون العرب يتصدّون لها آنذاك بالبحث والتفكّر؛ مثل المدنية، والمرأة والرجل، ومصير الأسرة الشرقية، والشيوعية والأسرة، والدولة، والحكومة والرعية، والمذاهب السياسية، وأشكال الحكم الصالح، والحركة الكمالية، والاندماج الوطني أو التجانس، والوطنية، والزعامة، ووحدة الأمة، والثورة، والدين والثقافة، وأصل الشعور الديني، والدين والنهضة الأخلاقية الحديثة. التحرير والبناء يندرج جميع تلك الموضوعات في سياق رؤية الشهبندر إلى مستقبل العالم العربي، والتي يمكن إيجازها في محورين: تحرير البلاد العربية من الاستعمار، وبناء الدولة الحديثة المتجانسة. جعل الشهبندر قضية الخلافة والسلطنة، علاوة على فكرة "حكومة القاهرين" ومسألة التجانس (الاندماج الاجتماعي) في بؤرة بحوثه ومقالاته وخطبه، وتوفر دائمًا على التنبيه إلى مزايا فصل الخلافة عن السلطنة، وكان يردد أنّ "ما سُمي بِـ ’الخلافة‘ منذ أعصار [عصور] لم يكن سوى سلطنة مذمومة وحكومة مردودة شرعًا. وأن الذين كانوا يسمّون بِـ ’الخلفاء‘ لم يكونوا غير الملوك والسلاطين". وقسّم الشهبندر، في هذا الحقل من المعرفة، الحكم خمسة أشكال، هي: الشكل العصامي الديمقراطي؛ والشكل العظامي الأرستقراطي الاستبدادي الأوتوقراطي؛ والشورى النقابي الشيوعي اللاوطني؛ والفاشستي المتطرف في الوطنية؛ والشكل المستبد العادل أو النيّر، وهو ما اعتبره ملائمًا للحكم ولا يوجد شكل ملائم غيره، وراح يبشر به في البلاد العربية، بالتحديد في الشام والعراق. من المحيط إلى المحيط يقول الشهبندر في مقدمة الكتاب: "ليس من قصدنا أن تتناول هذه المقالات التي نشرناها تباعًا في مجلة المقتطف جميع القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي؛ فهذه أكثر من أن تتناولها مجلة مهما اتسع صدرها، بل حسبنا أن نخص بالذكر منها هذه الموضوعات الرئيسية التي عالجناها بشيءٍ من الإيضاح ربما لم نكن لنحتاج إليه لو اقتصرنا على الكتابة لمصر أو لسورية أو للعراق مثلًا. أمّا والعالم العربي متسعٌ فسيح يمتد من المحيط إلى المحيط ويحوي أنواعًا من التربية المتفاوتة في الدرجات، فلا بدَّ من ملاحظة هذا التفاوت بتقديم الشروح والإيضاحات الضرورية، مع الإشارة إلى مثل هذه القضايا عند الأمم الأخرى". ويضيف: "في الحق أن سهولة الاتصال بين شعوب الأرض وتقريب المسافات بين القارات وشدة الامتزاج بين الثقافات وارتباط المصالح بين الممالك، كل ذلك سينهنه من غرب الذين يزعمون أنهم خلقوا خلقًا خاصًّا كذّب من بعده النسّابون، وسيجعل القضايا الاجتماعية في المجتمع البشري متشابهة وطرق معالجتها متقاربة، لأن الإنسان بالغًا ما بلغ من التأثر ببيئتِه الخاصّة تابع في تدرّجهِ لقواعد اجتماعية عامة مستقاة من تجارب واختبارات متماثلة في جميع الأفراد والجماعات".
العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة
صدر عن سلسلة "قضايا" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب عبد العلي الودغيري العربية أداةً للوحدة والتنمية وتوطين المعرفة، يتناول فيه مؤلفه وضع اللغة العربية الفُصحى في المرحلة الراهنة وما تعانيه من مشكلات وتحدّيات قد تأتيها من جهة أعدائها وخُصومها، "وهو أمرٌ مفهومٌ، أو من جهة أهلها وذَويها وفي بِيئاتها وداخل مجتمعاتها الحاضِنة لها، وهو ما قد يَستعصي أحيانًا على الفَهم، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى عناءٍ في توضيحه وتوثيقه، لأن لسانَ الحال ناطِقٌ به والواقع شاهِدٌ عليه"، بحسب توصيف الودغيري نفسه في مقدمة الكتاب. يتألف هذا الكتاب (216 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من خمسة فصول. تحديات تواجهها العربية في الفصل الأول، "العربية وموجات التحّديات"، يحصر الودغيري التحدّيات التي واجهَتها اللغةُ العربية في أربع موجات: الموجة الأولى برزت منذ بداية طريق النهضة العربية الحديثة، "فبمجرد ما بدأ الاحتكاكُ الفعلي والقويّ بآلة الحضارة الغربية الحديثة المتفوِّقة في كل جوانبها المادّية والعلمية والثقافية واللغوية والسياسية والعسكرية والاقتصادية، انكشفَ المستوى الذي انحدرَت إليه اللغة العربية في ذلك الوقت، وما وصلت إليه الفُصحى على الخصوص من ضعفٍ وقصور في معجمها ومفرداتها وجمودٍ في أساليب تعبيرها، وتخلُّفٍ في طرق تعليمها". وتتلخص الموجة الثانية في جملة من العقَبات الجديدة التي وقفت في طريق اللغة العربية خلال مرحلة الاحتلال الأجنبي الاستيطاني الذي سيطر على البلاد العربية والإسلامية. في حين ظهرت الموجة الثالثة في فترة ما بعد الاحتلال الاستيطاني لعدد من الدول العربية وحصولها على الاستقلال؛ فالاحتلالُ الأجنبي لم يكن ليغادر الأرض التي سيطر عليها إلا بعد تثبيت جذور لغته وثقافته، وغَرسِها في العقول والنفوس. أما الموجة الرابعة فهي موجة العولمة التي بدأت اقتصادية وتجارية وتحولت إلى دعوة إلى عولمة لغوية وثقافية، تكون فيها السيادةُ المطلقةُ في العالم كلّه للغةٍ واحدة متفوِّقة ومسيطِرة، هي اللغة الإنكليزية. ثم يعرض المؤلف في باقي هذا الفصل العوامل التي كانت وراء تغيُّر نظرة أهل اللغة إلى لغتهم، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز مكانة اللغة العربية الجامعة. العربية في سياق العولمة في الفصل الثاني، "العربية في سياق العولمة وتحدياتها"، يتناول الودغيري العولمة، وهي، بحسبه، في جانبها الثقافي "معناها تعميمُ نموذجٍ معيَّن من القِيَم والأذواق والمفاهيم الثقافية والاجتماعية المُصاحِبة لنموذج القِيَم الاقتصادية، ورؤيةٍ خاصة للعالَم، وفلسفةٍ للحياة، وتفسيرٍ خاص لأمور الدين والأخلاق والسلوك والعادات، ومحاولةُ فرض ذلك بطريقة أو أخرى، نمطًا موحَّدًا، فيُطالَب العالَمُ المختلِفُ فكرًا وثقافةً وحضارةً وديانة وأخلاقًا وسلوكًا، بأن يأخذ به ويتبنَّاه ولا يَحيد عنه. وهذا النموذج المطلوب فَرضُه هو النموذج الغربي الأمريكي". يتم فرض هذا النموذج من طريقين: الطريق الحريري الناعم الذي تتسرَّب بواسطته هذه المفاهيم وتنتقل إلى الناس من دون شعور ولا إبداء مقاومة، وطريق الفرض والإكراه والإلزام الذي يتم به نقلُ المفاهيم الغربية للعولمة التي يُراد تعميمُها إجباريًا، وتفرضُه بصورة أو بأخرى القوى العالميةُ المُهيمِنة. ويتناول أيضًا مسألة التعليم بشروط العولمة، واللغة العربية في سياق العولمة. يقول المؤلف: "بحجة العَولمة ومتعلِّقاتها، إذن، أصبح مطلوبًا من العربية رغم كونها تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة بين أكبر لغات العالم من حيث حجم الانتشار على الأقل أن تتخلى عن مكانتها وموقعها ودورها الأساسي في التنمية المحلّية والإقليمية، لصالح لغة العولمة بامتياز وهي الإنجليزية، والاكتفاء بدور المساعد لها في المشرق العربي". ضرورة العربية للتنمية العربية في الفصل الثالث، "العربية: ضرورتُها للتَّنمية ودَواعيها الاقتصادية"، يرى الودغيري أن البحث في علاقة العربية بالاقتصاد هو في جوهره "بحثٌ في العلاقة الجَدَلية بين تنمية العربية باعتبارها لغةَ الأمّة الجامِعة، وتنميةِ المجتمع تنميةً شاملة عميقة وقابِلة للاستمرار والدَّيْمومة". والتَّنمية كلمةٌ حلَّت مَحلَّ كلمة النَّهضة، وهناك شروط ضرورية كثيرة لقيام أيِّ إقلاعٍ اقتصادي واجتماعي وثقافي سليم أو تنميةٍ حقيقية شاملة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أهمّها: أمنٌ واستقرارٌ سياسي واجتماعي؛ رأسُ مالٍ بشري؛ رأسُ مالٍ مَعرفي. بحسب المؤلف، استيرادُ المعرفة بلغاتها الأجنبية لا يؤدي إلى تحصين الثروة المعرفية وتحقيق ما يمكن أن نسمِّيه الأمن المعرفي، "فالمعرفةُ ثروةٌ باهظةُ الثمن ووجودُها أمرٌ حيويُّ وضروريٌّ جدًّا لتنمية المجتمع، ولذلك فإن امتلاكَها، لا استعارتَها أو استِئْجارَها، هو الشيء الوحيد الذي يضمن هذا الأمن ويُحقِّقه. وخيرُ وسيلة لامتلاكها وهَضمها هو نقلُها إلى اللغة الوطنية المشترَكة (لغة الأمّة)، واستِنباتُها داخل مجتمعاتنا بهذه اللغة لا بغيرها". يضيف: "لا شك في أن المعرفة، بكل أشكالها وأنواعها وتجلِّياتها المختلفة التي تُكوِّن في جملتها ما يُعرَف بمجتمع المعرفة، مرتبطة أشدَّ الارتباط بالثقافة التي تُنتِجها وتنتمي إليها من ناحية، واللغة التي تعبِّرُ عنها وتُكتَسَب أو تُصاغُ بها، وتؤدّيها أو تكون حامِلًا لها، من ناحية ثانية؛ إذ لا معرفة بلا لغة، مهما كان الأمر. وارتباطُ اللغة بالمعرفة بهذا الشكل الضروري، هو الذي يجعلنا نقول إن اقتصاد المعرفة مرتبط أشدّ الارتباط باقتصاديات اللغة. أي إن الرأسمال المعرفي لا يمكن أن ينفصل عن الرأسمال اللغوي، كلاهما وجهانِ لثروة واحدة". لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات في الفصل الرابع، "لغةُ التدريس وتدريسُ اللغات (في التجربة المغربية)"، يقول الودغيري إن الدعوة إلى تدريس الدارجة أو جعلها لغةً للتدريس ولو في المراحل الأولى ليست سوى مدخل لتنفيذ مخطط يرمي إلى الإجهاز على اللغة العربية والتمكين من وراء ذلك للّغة الأجنبية التي لم يستطع الاحتلالُ نفسُه أن ينشرها بالطريقة التي ينشرها اليوم، وإن الدعوة إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية المشتركة في تلقين كافة المعارف والعلوم لا يعني إقصاء اللغات الأجنبية أو تهميشها في العملية التعليمية، وإن الدعوة إلى استعمال العربية في التعليم أمرٌ طبيعي جدًا في كل بلد ينتمي إلى المجموعة العربية، وليس معناه القضاء على لغات وطنية ومحلّية أخرى. بحسبه، لا يمكن العربية أن تنمو وتتطور إلا بإدخالها في مجال تعليم التقنيات والعلوم الدقيقة، وفي التعليم العالي على الخصوص، ومن يعمل على التراجع عن استعمال اللغة الوطنية الدستورية، فإنما يعمل على قتل الفصحى وتراجعها، وفي قتل الفصحى قضاءٌ على العربية كلها؛ ومن يقول بإرجاء استعمال العربية إلى حين الفراغ من تَهيِئتها وإصلاحها والنظر فيها، إنما يُماطِل ويُسوِّف ويُخادع الناس ويستهزئ بعقولهم ويستخفُّ بقُدراتهم العقلية، لأن أيّ لغة لا يمكن تطويرها وتنميتها وتهيِئتها وهي مُبعدةٌ ومهمّشَة. يتهم المؤلف الإعلام المسموع والمرئيّ بالتواطؤ ضد العربية والفصحى، فلا بد من إصلاحه ليقوم بدور المسانِد للمدرسة في خدمة اللغة الوطنية. ويرى أن تَغوُّل التعليم الخاص على العمومي من دون إخضاعه للمراقبة التربوية الصارمة، وإلزامه تطبيق مقرّرات الدولة ومناهجها وسياستها اللغوية، خطرٌ كبير يجب تصحيحُه. المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية في الفصل الخامس، "المسألة اللغوية عند النُّخَب الوطنية (علال الفاسي نموذجًا)"، يقول المؤلف إن النُّخَب التي قادت الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية من تونس إلى المغرب الأقصى "انتبَهت مُبكِّرًا إلى دسائس الاحتلال الفرنسي حين بدأ تطبيقَ سياسته اللغوية والتعليمية الرامية إلى إبعاد العربية والفصحى على وجه الخصوص، من المدرسة والإدارة وتعويضها بالفرنسية، وإصدار التعليمات الصارمة لحُكّام المناطق بعَرقلة المدارس العربية والقرآنية على وجه الخصوص، وحَمْلِ الأُسَر على توجيه أبنائها نحو المدارس الفرنسية. وهكذا بدأ مسلسلُ تهميش اللغة العربية شيئًا فشيئًا والطَّعنِ في صلاحيتها وكفاءتها وتحريض أهلها عليها. وكان سلاحُ مواجهة هذا المخطَّط الاحتلالي، متمثِّلًا في نشر الوعي لمواجهته بكل الوسائل الممكِنة والقيام بحملة مضادّة عملت من جهتها على فتح مدارس أهلية تحافظ على العربية والثقافة الإسلامية بجانب الانفتاح على اللغات الأجنبية. وحين حصلت البلدان المغاربية على استقلالها واصَلت هذه النُّخَبُ العمل من أجل وضع أُسُس مدرسةٍ وطنية يكون من جملة أهدافها تحقيقُ الاستقلال اللغوي وتنمية روح الاعتزاز بالهوية الثقافية والوطنية في نفوس الناشِئة". ويتناول الودغيري علال الفاسي نموذجًا، وهو أحدَ كبار زُعماء الحركة الوطنية التحرُّرية في المنطقة المغاربية، ومن أبرز مفكّريها ومنظِّريها قبل الاستقلال وبعده، وقد استماتَ في مَواقفه ونضالاته الميدانية وكتاباته التَّنظيرية دفاعًا عن اللغة العربية باعتبارها اللغةَ الوطنية المشتركة بين المغاربة وغيرهم من أبناء الدول العربية الأخرى، وعن أهميتها في التعبير عن وجدان الأمة وأحاسيسها وثقافتها وتجسيد هويّتها وصياغة فكرها، وصلاحيتها لتكون لغةَ الحاضر والمستقبل، ومواكبة التطوّر العلمي والتقني والحضاري في كل المجالات. ومعروف عنه دفاعُه عن تعريب لغة التعليم والإدارة والمرافق العامة ومقاومته الشديدة للهيمنة الفرنكوفونية وكل مظاهر التغريب والاستِلاب الفكري والغزو الثقافي واللغوي الموروث عن مرحلة الاحتلال.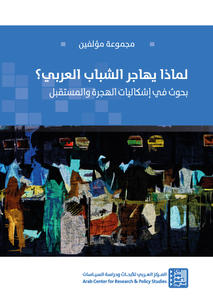
لماذا يهاجر الشباب العربي؟
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب لماذا يهاجر الشباب العربي؟ بحوث في إشكاليات الهجرة والمستقبل، وهو يضمّ بين دفّتيه بحوثًا منتقاة قدّمت ضمن محور "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل"، في المؤتمر السادس للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي عقده المركز في الفترة 18-20 آذار/ مارس 2017 في الدوحة. وتناقش البحوث التي يضمها الكتاب سؤال الهجرة الذي يكتسي أهميةً خاصة في السياق العربي المعاصر، ولا سيّما من جهة ارتباطه بفئةٍ عمرية - اجتماعية تمثّل قلبه النابض ورهانه الأساسي لرفع التحديات المستقبلية التنموية والتحرّرية؛ إذ ازدادت هجرات الشباب العربي في الأزمنة الحديثة، وأضحت إشكاليةً حقيقية في محيط متغير ومعولم وموسوم على نحوٍ متزايدٍ بالنزاعات والصراعات، إضافةً إلى أنّ الهجرة تمثّل العامل الثالث من عوامل النمو السكاني، إلى جانب الولادات والوفيات، وهو ما يجعل دراستها ذات أهمية أيضًا بالنسبة إلى البلدان المستقبلة. يتألف الكتاب (912 صفحة من القطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، من تقديم بعنوان "هجرات الشباب العربي في عالم متغير"، كتبه محرر الكتاب مراد دياني، وثلاثة وعشرين فصلًا موزعة على سبعة أقسام. الهجرة النسوية العربية يتكون القسم الأول، "الهجرة النسوية العربية"، من ثلاثة فصول. في الفصل الأول، "الفتاة العربية والهجرة إلى الجنّات الموعودة: محاولة في الفهم"، تتناول عائشة التايب ظاهرة الهجرة غير المشروعة للفتاة العربية، سواء نحو أوروبا أم نحو بؤر التوتر والنزاع والانضمام إلى الجماعات والتنظيمات المتطرفة، معتمدةً زاوية نظرية تجتهد في مقاربة الظاهرة باعتبارها متعددة الأسباب ومتنوعة العوامل، ومفككةً عناصر الموضوع انطلاقًا من اعتبارها ظاهرة اجتماعية كلية. وفي الفصل الثاني المعنون بـ "هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية للعمل: ظاهرة مستجدة"، تتناول ماريز يونس 15 حالة لمهاجِرات لبنانيات يعملن في دول الخليج العربي، جرى اختيارهن بوصفهن عيّنة احتمالية باستخدام أسلوب عينة كرة الثلج الشبكية، أو من خلال الاستعانة بأصدقاء وصديقات. ولأن عدد الحالات التي جرى استهدافها قليل، تقتصر حدود الدراسة على التعرف إلى هذه الظاهرة الجديدة والكشف عن أبعادها وعن التنوع فيها، والتمايز بين الحالات؛ على أمل أن تؤسس لدراسة أعمق وأشمل على المستوى اللبناني بداية، وعلى المستوى العربي في مرحلة لاحقة. في حين تقول مريم الحصباني في الفصل الثالث، "النوع الاجتماعي والتنقل المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي: تجارب الأكاديميين والأكاديميات اللبنانيين"، إن البحوث بشأن هجرة الطلاب والطالبات لم تزل نادرة عمومًا، والمتعلقة بعلاقة النوع الاجتماعي بمحدِّدات الهجرة الدولية للطلاب لم تزل غائبة تمامًا عن الدراسات العلمية النادرة التي تناولت المنطقة العربية، فتعمل في هذه الدراسة على سد هذه الثغرة، بمحاولة الإجابة عن السؤال: "كيف يؤثر النوع الاجتماعي في قرار انتقال الأكاديميين اللبنانيين المرتبط بالارتقاء بالمستوى التعليمي؟". التقييد الأوروبي ولايقينية المستقبل يتضمن القسم الثاني، "بين القوانين الأوروبية التقييدية ولايقينية المستقبل"، أربعة فصول. يرى محمد الخشاني في الفصل الرابع، "هجرة الشباب العرب إلى دول الاتحاد الأوروبي: قراءة نقدية في السياسة الأوروبية للهجرة"، أن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثّل الوجهة الرئيسة للشباب العرب، يواجه حكامة تتسم بتناقضات يعمل على إبرازها كي يبين العوامل المفترض أن تحفز اعتماد سياسة أوروبية جديدة تخضع لمقاربة "ثلاثية الربح" للفاعلين المعنيين: المهاجر، والدول الموفدة، والدول المستقبلة. ويعمل على تحليل هذه الإشكالية من خلال أربعة تساؤلات: ما حجم الظاهرة؟ وما أبعادها المستقبلية من خلال الدراسات المتوافرة في بعض الدول العربية؟ وما أهم محاور السياسة الأوروبية في مجال الهجرة؟ وما العوامل التي تبرز تناقضات هذه السياسة ونواقصها، وتفرض اعتماد سياسة أوروبية جديدة للهجرة؟ بينما يسلط بشير سرحان قروي في الفصل الخامس، "قوانين الهجرة الانتقائية في دول الاتحاد الأوروبي وآثارها في المهاجرين العرب"، الضوء على مفهوم الهجرة الانتقائية، والأسس التي تقوم عليها في دول الاتحاد الأوروبي، والكشف عن واقع الشباب العرب المهاجرين، خصوصًا ما يسمى هجرة الأدمغة، وأثر هذه الهجرة في الدول المصدّرة هذه الأدمغة. كما يقيّم السياسات والاستراتيجيات الوطنية العربية في مواجهة ظاهرة استنزاف المورد البشري الذي لا يقل أهمية عن استنزاف الثروات والموارد، بل هو أخطر منها. ويعالج العياشي عنصر ووسيلة عيسات في الفصل السادس، "السعي وراء المستقبل المفقود: لماذا يهاجر الطلاب الجزائريون؟" مسائل عدة، منها: لماذا يغامر الطلاب الجامعيون بالهجرة إلى عوالم بعيدة ومجهولة؟ ما المشروع/ الحلم الذي يسعون إلى تحقيقه في المهجر بعد أن استعصى عليهم ذلك في بلادهم؟ وما الوجهات الأكثر استقطابًا لهم؟ ولماذا؟ وكيف يتصورون أرض الميعاد التي يغامرون نحوها؟ وكيف يتصورون مستقبلهم فيها؟ أيوجد أمل في عودتهم يومًا ما إلى الوطن أم أنهم يقطعون تذكرة باتجاه واحد نحو المجهول؟ أما في الفصل السابع "الهجرة الطلابية بين الرهانات المؤسساتية ودوافع الطلاب الدوليين: الطلاب الجزائريون في فرنسا أنموذجًا"، فتتتبع سهيلة إدريس ديناميات الهجرة وإعادة تشكيلها، وإظهار آثار الضغوطات القانونية والاقتصادية والإدارية للدول المستضيفة في مسار الطالب المهاجر، آخذةً في الحسبان السياق العالمي لاقتصاد المعرفة، والإطارات القانونية والتشريعية للبلدان المستضيفة للطلاب الدوليين، وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأصلية للحركة الأكاديمية نحو الخارج. كما تسعى إلى الكشف عن بعض الجوانب المنيرة لإشكالية العلاقة بين هجرة الشباب العرب، وبالتحديد الطلاب، ومسائل هشاشة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فيها. واقع الهجرة إلى أوروبا إعلاميًا في القسم الثالث، "دراسات في واقع الهجرة إلى أوروبا ومقارباتها الإعلامية"، ثلاثة فصول. في الفصل الثامن، "شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا - هويات تائهة ومتصدعة: دراسة حالة حي بورغراوت بمدينة أنفرس"، ينطلق محمد سعدي من فرضية أن ظواهر الفقر والتهميش وسياسات الإقصاء والتمييز، وحتى الثقافة الدينية الإسلامية السائدة لدى سكان حي بورغراوت لا تكفي لتفسير نزعتهم التمردية وتعثر اندماجهم الاجتماعي وتحوّلهم إلى فريسة سهلة في أيدي المتطرفين الدينيين، بل ينبغي التوجه نحو التمزق الهوياتي العنيف الذي يعيشونه، وبحثهم عن المعنى ونوع من الأمان الهوياتي. وفي الفصل التاسع، "الهجرة المغربية إلى فرنسا (1912-1974): أيّ موقعٍ للشباب"، يتناول خالد أوعسو هجرة المغاربة نحو فرنسا، في المرحلة المعاصرة، بوصفها أحد مظاهر علاقة الإنسان بالمجال، معالجًا إشكالية مركزية: كيف حددت هجرة الشباب علاقة المغرب بالعوالم الغربية عمومًا وفرنسا خصوصًا؟ وفي الفصل العاشر، "صورة الشباب العرب اللاجئين في الصحافة الألمانية: مثال مجلة دير شبيغل"، يجيب زهير سوكاح عن التساؤلات الآتية: كيف تنظر الصحافة الألمانية والأوروبية إلى الهجرة الحالية؟ وهل تختلف نظرتها إلى اللاجئ العربي الشاب عن النظرة النمطية التي تنسجها منذ عقود عن المهاجر الأجنبي عمومًا والمهاجر العربي خصوصًا؟ وهل هذه الصورة الحالية لا تعدو أن تندرج في النظرة السائدة بشأن كل ما هو عربي وإسلامي؟ وهل يمكن الحديث عن صور متعددة؟ وهل صحافة هذه الدول تساهم في إعادة صنع صورة نمطية وحيدة للاجئ العربي لاعتبارات أيديولوجية؟ الهبة الديموغرافية والتنمية يشتمل القسم الرابع، "بين وعود الهبة الديموغرافية وإخفاقات السياسات التنموية"، على أربعة فصول. في الفصل الحادي عشر، "الهبة الديموغرافية في الوطن العربي: نعمة أم قنبلة موقوتة؟ المغرب أنموذجًا"، يحلل إبراهيم المرشيد الدينامية السكانية في المغرب وأثرها في ظهور الهبة الديموغرافية في بداية الألفية الثالثة. كما يحاول فهم مدى تجاوب مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مع هذه الظاهرة الاستثنائية، طارحًا السؤال المحوري: هل يمكن اعتبار ظهور الهبة الديموغرافية في المغرب نعمةً أم نقمة؟ في حين يقيس محمد أبو عزيزة في الفصل الثاني عشر، "مدى التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وأثره في قرار الهجرة بين الشباب في مصر"، حجم عدم تطابق التعليم - الوظيفة بين الشباب بالطريقة المناسبة التي تلائم سياق سوق العمل المصرية؛ ويقدم تقويمًا كمّيًا لتأثير عدم تطابق التعليم - الوظيفة في قرار الهجرة بين الشباب. وفي الفصل الثالث عشر، "الهجرة المعاصرة للشباب المغاربة إلى الخارج: بين الواقع الاقتصادي ووهم التنمية"، تروم خديجة عونة تسليط الضوء على استمرار تبعية المغرب للخارج في ظاهرة الهجرة، وتحليل الديناميات السوسيو-اقتصادية للهجرة الخارجية على المستوى الوطني، معتمدةً المنهج الاستقرائي والتحليلي للحوادث في الظاهرة المدروسة ووصفها، ولعلاقاتها المجالية والاجتماعية المتشعّبة. أما الفصل الرابع عشر، "هجرة الشباب وسياسات التنمية المندمجة: دراسة حول شباب مدينة خريبكة في المغرب"، فيؤسس فيه صالح النشاط فرضية بحثه على أن الحدَّ من سيولة هجرة الشباب تحتاج إلى سياسات عامة ناظمة لترجمة حقّ الشباب في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، وإلى إجراءات وبرامج وخطط تعمل على تثمين رأس المال اللامادي للشباب، واستثمار مقدّراته، في أفق تحقيق شروط اندماجه الكامل في البناءين الاقتصادي والاجتماعي. الواقع والفرص والتهديدات يتضمن القسم الخامس، "دراسات سوسيولوجية في الواقع والفرص والتهديدات"، ثلاثة فصول. في الفصل الخامس عشر، "الشباب المغاربيون بين الاستبعاد الاجتماعي وتطلعات الهجرة: مقاربة سوسيو-إمبيريقية مقارنة بين الجزائر والمغرب"، يحلل الهادي بووشمة العلاقة الطردية بين الاستبعاد الاجتماعي للشباب وظاهرة الهجرة، حيث تبدو العلاقة سببية مباشرة بينهما؛ إذ يتغذّى متغير الهجرة من ظاهرة الاستبعاد الذي يبدو سببًا مؤدّيًا إليها. في المقابل، تبدو الهجرة ذاتها سببًا أو عاملًا أو حتى نتيجةً مفضية بدورها إلى ظاهرة الاستبعاد. وفي الفصل السادس عشر، "الشباب وظاهرة ’الحريك‘ في المغرب: مقاربة سوسيولوجية"، يحاول زهير البحيري الوقوف على أسباب الهجرة غير النظامية للشباب المغاربة نحو أوروبا، وعلى تمظهراتها وانعكاساتها في إطار ما بات يُصطلح على تسميته ظاهرة "الحريك"، بوصفها أصبحت اليوم من الظواهر السوسيولوجية التي تستدعي تعميق الدراسة والتحليل. وفي الفصل السابع عشر، "الهجرة الخارجية بين التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي: مقاربة نظرية للفرص والتهديدات"، يدرس هاني خميس عبده التعددية الثقافية، ويكشف عن إرهاصاتها بوصفها إحدى السياسات التي بدأت الدول تستعين بها لتجذب المهاجرين وتشجّعهم على السفر والاستيطان، وكذلك يتناول السياق البنائي الذي أدى إلى إعادة النظر في تلك السياسات، وتراجع الاعتماد عليها في بعض الدول؛ كونها أصبحت تمثّل تهديدًا للدولة القومية (الدولة التي تستقبل المهاجرين)، وتقويضًا للتماسك الاجتماعي. وعود الهجرة العائدة يحتوي القسم السادس، "وعود الهجرة العائدة والحدّ من نزيف هجرة الكفاءات"، على ثلاثة فصول. في الفصل الثامن عشر، "الهجرة العائدة للشباب العرب: إشكاليات الواقع وسياسة الإدماج"، تعرض آسيا شكيرب موضوع الهجرة العائدة انطلاقًا من الواقع الراهن، ومن الإشكاليات التي تواجه الشباب العائدين طوعًا، وآليات إدماجهم واستراتيجياته في المجتمع الجزائري، منطلقة من فرضيتين: يعاني الشباب الجزائريون العائدون مشكلات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ولم تتخذ سياسة الإدماج الجزائرية التدابير اللازمة في سبيل إدماج العائدين. ويبحث منير مباركية في الفصل التاسع عشر، "هجرة الكفاءات الجزائرية: دراسة في جهود الحدّ من نزيفها وإشراكها في التنمية الوطنية"، في فشل مساعي إقناع الكفاءات الوطنية الجزائرية بالعودة إلى الجزائر، إضافةً إلى قصور الجهود والسياسات الجزائرية أو إخفاقها في التعامل مع هجرة الكفاءات وتفعيل دورها التنموي، طارحًا الأسئلة بشأن ما يمكن أن يجعل
الديموغرافيا: التحليل والنماذج
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الديموغرافيا: التحليل والنماذج، وهو من ترجمة الباحثة مدى شريقي لكتاب لوي هنري Démographie: analyse et modèles، ويُعد من أهم المؤلفات الكلاسيكية في مجال التحليل الديموغرافي وأدواته وتطبيقاته. لا يكتفي المؤلف في هذا الكتاب بالتعريف بعلم الديمغرافيا وأدواته وموضوعاته، بل يرشد القارئ إلى عمق مقوّمات التحليل الديموغرافي، كاشفًا في كل خطوة عن مدى التداخلات بين مختلف الظواهر الديموغرافية والطرائق والآليات المتعلقة بتفكيك هذه التداخلات، على نحو يتيح التوصل إلى صورة تحليلية سليمة للمعطى العددي، ويتجاوز القراءات الوصفية التبسيطية للرقم الإحصائي. تحليل ديموغرافي يتألف الكتاب (506 صفحات بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من قسمين؛ يشمل القسم الأول، المعنون "التحليل الديموغرافي"، مقدمة وعشرة فصول. يعرض الفصل الأول، "تحليل نتائج تعداد السكان العام"، تحليلًا لنتائج التعداد العام للسكان، أو بكلمات أخرى دراسة حالة السكان، مع تناول المصادر ودلالات البيانات ونقدها، وتحليلها بمتغير واحد ومتغيرين وثلاثة متغيرات ومتغيرات أكثر أيضًا، فضلًا عن عرض مشكلة تفسير هذه البيانات. ويتناول الفصل الثاني "تحليل موجَز لحركيّة السكان على امتداد عام تقويمي واحد"، دلالات البيانات ومصادرها ونقدها، ويطرح مشكلات التفسير التي يستلزم حلّها معارف أكثر عمقًا؛ إذ يقول المؤلف: "وهدفنا من ذلك تنبيه القارئ إلى خطورة السعي لتقديم تفسيرات متسرعة جدًا لبيانات تتسم بعدم كفايتها، وهي نزعة واسعة الانتشار والشيوع، آملين أن نحفّزه في الوقت ذاته على الذهاب في معارفه التحليلية إلى ما هو أبعد من المبادئ الأولية". أما الفصل الثالث، "عموميات في تحليل الظواهر الديموغرافية"، فيقدم معلومات عامة عن اختيار المؤشرات الخاصة بالظواهر الديموغرافية، والتحليل الطولاني الذي يُسمّى أيضًا "التحليل في الأفواج"، والتحليل المقطعي الذي يُسمّى "التحليل في المراحل الزمنية"، وهو التحليل القائم على دراسة مشاهدات مسجلة خلال عام تقويمي واحد أو على امتداد فترة محددة، أي إنّ هذه المشاهدات تضم أفرادًا ينتمون إلى أفواجٍ متنوع، كما يتناول المؤلف "مخطط لكسيس". زواجية وخصوبة يتناول المؤلف في الفصل الرابع، الذي ورد بعنوان "الزواجية"، ظاهرة الزواجية، سواء في ما يتعلق بالزيجات الأولى، أو بانفصام الرابطة (انفصام الزواج)، أو بالزواج من جديد؛ إذ يقول: "بما أنه بالإمكان دراسة ظاهرة الزواجية من خلال الاكتفاء بدراسة الزواج الأول كمعبّرٍ عنها (وهو خيارنا هنا)، فإن هذا الفصل الذي سيعالجها يُمثل في هذا الصدد أنموذجًا أصليًا للتحليل الطولاني المبني على وقائع غير متجددة". وفي الفصل الخامس، وهو بعنوان "الخصوبة"، يضع المؤلف دراسة "جميع مراتب الأمومة" مجتمعةً في مركز الاهتمام الأكبر، "الأمر الذي يجعل هذا الفصل أنموذجًا أصليًا لدراسة الظواهر المبنية على وقائع متجددة". أما الفصل السادس، "جوانب أخرى متعلقة بالخصوبة: الأسرة"، فيخصصه المؤلف للبحث في الأسرة، بوصفها مجموعة مؤلفة من زوجين وأبناء. وكونها وحدة إحصائية معقدة، من نافل القول إنها تتوقف على الخصوبة والزواج. وفيات وتنقل وحركية ديموغرافية يعالج المؤلف في الفصل السابع، "مقارنات: التحليل والتركيب مقطعيًا"، التحليلَ المقطعي للزواجية والخصوبة، فيُعنى بكل ما يتعلق بهذا النوع من التحليل، باستثناء ظاهرة الوفيات. كما يشير المؤلف إلى أنه كان من الممكن معالجة التحليل المقطعي لظاهرتَي الزواجية والخصوبة في الفصلَين الرابع والخامس، "إلا أن الدراسة المقطعية كانت ستتوجه في هذه الحالة نحو التركيز على الأوضاع والظروف المتعلقة بالظواهر المدروسة أكثر منها نحو البحث في خصائصها المعمقة". ثم يعالج المؤلف، في الفصل الثامن، وهو بعنوان "الوفيات"، ظاهرةَ الوفيات من منظور مقطعي، باعتبار أن التحليل المقطعي هو الغالب في هذا المجال التحليلي. وفي الفصل التاسع، "التنقل والهجرات"، يتداخل في الكتاب أنموذَجا التحليل المقطعي والتحليل الطولاني، وهو ما يجعل وضع حدود حاسمة بينهما أمرًا صعبًا بالنسبة إلى المؤلف؛ عند تحليل الحراك الجغرافي، ووجهات المهاجرين، والهجرات العائدة. ثم يدرس المؤلف في الفصل العاشر، "الحركية الطبيعية للسكان"، حركية السكان التي تنتج من الظواهر السابقة. وفي هذا الفصل يستخدم أول مرة مفهوم "معدل التكاثر الصافي"، كما يخصص مساحة كبيرة، نسبيًا، للبحث في خصائص السكان وحالات الثبات السكاني. وبحسب المؤلف، تسمح معرفة هذه الخصائص بتجنب بعض الأخطاء الجسيمة في التحليل. نماذج للدراسة يتألف القسم الثاني من الكتاب، وهو بعنوان "النماذج"، من مقدمة وخمسة فصول. ففي الفصل الحادي عشر (أول فصول القسم الثاني)، "نماذج تطور السكان"، لا يعالج المؤلف جميع النماذج من هذا النوع، بل يكتفي بنظرية لوتكا والتطورات اللاحقة لها، نظرًا إلى أهميتها، من دون الدخول في تفصيلات، إضافةً إلى بعض الجوانب المتعلقة بسكان المجتمعات التي تتسم بخصوبة ثابتة، والمجتمعات التي تتسم بتركيب عمري ثابت. ويتناول المؤلف في الفصل الثاني عشر من كتابه، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، احتمال الحمل"، احتماليات الحمل، مؤسِّسًا تناوله على أن الحمل حدثٌ عشوائي، وأن كل حمل يتسبب بالضرورة في منع حدوث حملٍ جديد خلال فترة من الزمن، فضلًا عن أنّ كل حمل لا يؤدي إلى إنجاب مولود حي، وأنه توجد حالات عقم مؤقت غير تلك التي تلي الحمل، كما أنه من الممكن أن يكون الزوجان عقيمين بصفة نهائية منذ الزواج، وأن يصبح أزواجٌ آخرون عقيمين بعد الزواج خلال مدة تطول أو تقصر، وأن يصبحوا عقيمين بوصول المرأة إلى سن الخمسين عامًا، إضافةً إلى أن الإنسان قد يتدخل تدخلًا مباشرًا بغرض خفض الخصوبة. نماذج الزواجية يعالج المؤلف في الفصل الثالث عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: عموميات، وفيات الأجنة واحتمال الحمل"، مشكلات مرتبطة بأثر وفيات الأجنّة في الخصوبة، ويحسب توزيع وفيات الأجنّة الموافق للنماذج، وحالات الحمل المتعلق بالأطفال الذين سيولدون أحياءً، ومتوسط الفترة الفاصلة بين الزواج والحمل الأول. ثم يتناول المؤلف في الفصل الرابع عشر، "نماذج تأسيس الأسرة بدءًا من الزواج: مجمل الولادات، وجميع العوامل"، تباينات فترة إيقاف حالات الحمل ضمن مجمل الولادات، وحالات الحمل والولادات الأولى بحسب المرتبة، والعدد النهائي لأفراد للأسرة. وفي الفصل الخامس عشر، "نماذج الزواجية"، يقدم المؤلف بعض وجهات النظر التي تخص نماذج الزواجية (الزيجات في المجمل) على نحو عشوائي، وكحلقات مكتمِلة، وكحلقات انتقالية، فضلًا عن العزوبة العشوائية، والعزوبة الناتجة من اختلال التوازن، وزيجات أبناء العمومة والخؤولة.
مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي، وهو ترجمة جهاد الترك العربية لكتاب ريتشارد سويدبرغ Principles of Economic Sociology (راجعه عمر سليم التل). يقول المؤلف في مقدمته للكتاب إن الهدفين الرئيسين من تأليفه يتمثلان في إدخال منظور جديد إلى علم الاجتماع الاقتصادي، "إضافةً إلى بسط مفاهيمه الأساسية، وأفكاره، واستنتاجاته. إن المنظور الجديد الذي أرغب في تقديمه يركز على نطاق هذا المجال المعرفي؛ إذ ينبغي في علم الاجتماع الاقتصادي ألا يكون اهتمامه محصورًا في تأثير العلاقات الاجتماعية على الأفعال الاقتصادية (الذي هو محل عنايته الرئيسة الآن)، ولكن أن يجعل المصالح محل عنايته أيضًا، وأن يسعى بشكل أعم إلى تثبيت التحليل عند مستوى المصلحة". مؤلفات في علم الاجتماع الاقتصادي يتألف الكتاب (636 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من 12 فصلًا. في الفصل الأول، "المؤلفات الكلاسيكية في علم الاجتماع الاقتصادي"، يعرض سويدبرغ ما يسميه التراث المكتوب الغني والنابض في علم الاجتماع الاقتصادي، "الذي بدأت تباشيره تلوح على مقربة من منعطف القرن العشرين وتستمر حتى اليوم. وقد أثمر هذ التراث المكتوب عددًا من المفاهيم والأفكار المفيدة إضافةً إلى نتائج مثيرة للاهتمام". ويرى المؤلف أنه لإنتاج علم اجتماع اقتصادي قوي، "يجب علينا دمج تحليل المصالح الاقتصادية مع تحليل آخر للعلاقات الاجتماعية. وانطلاقًا من هذا المنظور، يمكن، والحال هذه، فهم المؤسسات باعتبارها تشكيلات متميزة من المصالح والعلاقات الاجتماعية، والتي لها من الأهمية الاعتيادية بحيث يفرضها القانون. وهناك أعمال كلاسيكية عدة في علم الاجتماع الاقتصادي - كما سأحاول أن أثبت - تتشارك في هذه النظرة إلى الحاجة لاستخدام مفهوم المصلحة في تحليل الاقتصاد". ويقول المؤلف في الفصل الثاني، "علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر"، إن ثمة تقليدًا مميزًا لعلم الاجتماع الاقتصادي، أسفر عن سلسلة من المؤلفات التي تعالج المسائل الاقتصادية من منظور سوسيولوجي، كانت قد أنجزت خلال فترة من الزمن طويلة نسبيًا. ومع ذلك، فإن علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب ليس اصطلاحًا حسن التكامل والائتلاف؛ بمعنى أن المؤلفات اللاحقة تنطلق من حيث توقفت مثيلاتها الأقدم، "ويمكن العثور في اصطلاح علم الاجتماع الاقتصادي المكتوب على وفرة من الأفكار التي تقترح كيفية استخدام مفهوم المصلحة؛ إذ يقترح فيبر أن هناك مصالح مادية وأخرى معنوية/ مثالية؛ ويرى غرانوفيتر أن الأفعال الاقتصادية مدفوعة بمزيج من المصالح الاقتصادية والاجتماعية؛ بينما يعتبر بورديو أن لكل حقل مصالحه الخاصة به". في التنظيم الاقتصادي في الفصل الثالث، "التنظيم الاقتصادي"، يجد سويدبرغ أن ثمة منافع معينة في استخدام مفهوم التنظيم الاقتصادي بالمعنى التقليدي، وكذلك بالمعنى الواسع، أي بوصفه مرادفًا للتنظيم العام للاقتصاد. ويذهب إلى إمكانية فهم الرأسمالية بوصفها شكلًا من أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتسم بحقيقة أن الربح أحد أهدافه، وليس الاستهلاك وحده؛ وأن الربح ينبغي أن يعاد استثماره دائمًا في إنتاج جديد. كما يرى أن المناطق الصناعية وعملية العولمة مثالان من أمثلة التنظيم الاقتصادي بالمعنى الواسع. كما أن للأدبيات المتعلقة بالمناطق الصناعية أهمية فائقة لعلم الاجتماع الاقتصادي. أما في الفصل الرابع، "الشركات"، فيقول المؤلف إنه لإحداث تطوير واقعي ودقيق في علم اجتماع الشركات، يغدو تعزيز علم الاجتماع الاقتصادي بطرائق عدة أمرًا على قدر من الأهمية؛ لذا ينبغي لعلم الاجتماع الاقتصادي أن يفارق النزعة الحالية في نظرية التنظيمات المتمثلة في مساواة الشركة بسائر التنظيمات الأخرى، "وفي هذا، ثمة حاجة إلى معرفة تاريخية أفضل حول ظهور مختلف أنواع الشركات، ليس أقلها الشركات العائلية التي أهملت بغير حق في علم الاجتماع الاقتصادي. كما يجدر إيلاء المزيد من الاهتمام لدور العمل اليومي داخل الشركات، وحول هذه المسألة، يمكن استخدام علم الاجتماع الصناعي الذي كان سائدًا في خمسينيات القرن العشرين، كأنموذج للمحاكاة". مقاربات مختلفة للأسواق في الفصل الخامس، "المقاربات الاقتصادية والسوسيولوجية للأسواق"، يناقش سويدبرغ نظريات مختلفة حول الأسواق. يقول: "كانت عناية علماء الاجتماع بالأسواق أقل من عناية علماء الاقتصاد بها على نحو ملحوظ. وعلى الرغم من ذلك، ظهرت نظريات عدة حول الأسواق، من قبيل فكرة فيبر عن الأسواق بوصفها منافسة في المبادلة، وأنموذج W(y) لهاريسون وايت، والأسواق بوصفها شبكات، وفكرة أن الأسواق يمكن صياغتها مفاهيميًا كجزء من حقل. كما نوقشت أفكار مختلفة حول الطريقة التي يمكن أن تحدد الأسعار من خلالها وتحلل من وجهة نظر سوسيولوجية، بدءًا من فيبر حول دور السلطة في تحديد الأسعار، وصولًا إلى فكرة فليغشتاين أن المؤسسات التجارية تحاول تجنب المنافسة وتسعى إلى استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى ثمة عمل وافر ينتظر الإنجاز قبل أن نتمكن من القول إنه أصبح لدينا طائفة كافية من الأدبيات السوسيولوجية حول الأسواق، بما فيها تكوين الأسعار". ويدعو المؤلف، في الفصل السادس، "الأسواق في التاريخ"، إلى إدخال مفهوم المصلحة ضمن التحليل، حيث يعمد إلى إيضاح الرصانة المحتملة لهذا المفهوم بمساعدة من مواد تاريخية. وهو يقول إن المصلحة، باختصار، "هي في صلب ما يجعل أسواق العمل مختلفة، إلى حد بعيد، عن أسواق أخرى، لأن هذه هي الأسواق الوحيدة التي تكون فيها السلعة المبيعة هي نشاط الكائن البشري. إن ما يجري الاتجار به في أسواق العمل يختلف عن الأشياء الجامدة العادية التي تجرى مبادلتها في السوق، لأن هذا النوع من الاتجار يتميز بمصالح هي من نسج ذاتها، ذاتية مغايرة، وروابط مع أناس آخرين. إن نظرة الشخص إلى ما يعتبر ثمنًا عادلًا قد يؤثر أيضًا على إنتاجيته، وكذلك الأمر بالنسبة إلى روابطه بالآخرين". كما يعرض لأنماط الأسواق على مدار التاريخ. اقتصاد وسياسة وقانون كان الفصل السابع، "السياسة والاقتصاد"، مجالًا يجادل فيه سويدبرغ لإثبات الحاجة إلى علم اجتماع اقتصادي للسياسة. ومن الأشكال التي ينبغي لهذا النوع من التحليل اتخاذها علم الاجتماع المالي ودراسات حول مختلف محاولات القوى السياسية توجيه الاقتصاد، سواء من جانب الدولة أو من جانب جماعات المصالح. ويرى أنه يمكن تعلم الكثير عن دور الدولة في الاقتصاد، من علم الاقتصاد ومن الأدبيات السوسيولوجية. بالنسبة إلى الأول، فقد جرى التطرق إلى "الواجبات الثلاثة للعاهل ذي السيادة" وفقًا لآدم سميث، وعلم الاقتصاد المؤسسي لجيمس بوكانان، والنظرية النيوكلاسيكية للدولة لدوغلاس نورث. وفي علم الاجتماع، ثمة نظرية الهيمنة لفيبر، إضافة إلى مواد أخرى حديثة، مثل أفكار فليغشتاين حول مركزية الدولة في الحياة الاقتصادية. ويناقش سويدبرغ في الفصل الثامن، "القانون والاقتصاد"، تجاهل علماء الاجتماع الاقتصادي دور القانون في الحياة الاقتصادية، ويقول إن اتجاهًا كهذا يحتاج إلى تصحيح، "وفي المعتاد، ثمة بعد قانوني للظواهر الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يدخل طبقة جديدة ضمن التحليل. وقد وضعت مخططًا تمهيديًا لأجندة تتعلق بعلم الاجتماع الاقتصادي للقانون، تتركز حول مؤسسات من قبيل: الملكية، والميراث، والشركة بوصفها فاعلًا قانونيًا. وأشدد على مسألة أن القانون قد يعرقل النمو الاقتصادي أو يبطئه أو يسرعه". كما يجد أن دراسة القانون وعلم الاقتصاد متقدمة في كثير من الجوانب على علم الاجتماع الاقتصادي المتعلق بالقانون، ويمكنها، تاليًا، أن تكون مصدر إلهام على غرار دراسات محددة في القانون والمجتمع وفي علم اجتماع القانون. ثقافة وتنمية وثقة واستهلاك في الفصل التاسع، "الثقافة والتنمية الاقتصادية"، يناقش سويدبرغ مفهوم الثقافة؛ فيشير إلى أنه في وقت يعنى علماء الاقتصاد بالمصلحة الذاتية ويهملون الثقافة، يفعل بعض علماء الاجتماع الاقتصادي النقيض تمامًا. لكنّ الثقافة والمصالح ليستا نقيضين، "وإنما ينتميان معًا في نوع التحليل الذي أرى أنه ينبغي على علم الاجتماع الاقتصادي أن يعززه". ويعرض المؤلف طرائق مختلفة لكيفية صوغ نظرية تثبت أن الثقافة والمصالح تتبادلان الانتماء، بما في ذلك الطريقة التي يمكن العثور عليها في الفقرة الشهيرة لفيبر حول عمال تحويل السكك الحديد. ففي نظره، وفقًا لهذا الأنموذج، تعمل المصالح على دفع أفعال الناس، بينما تقوم الثقافة (ولنقل في شكلها الديني) بتزويدهم بالوجهة العامة. ويواصل المؤلف، في الفصل العاشر، "الثقافة والثقة والاستهلاك"، تحليل الثقافة والاقتصاد امتدادًا للفصل التاسع. وقد حاجّ ليثبت أن نقلة حدثت في علم الاجتماع الاقتصادي خلال العقود الخمسة الماضية، بدءًا من معالجة دور الثقافة، في الأساس، في التنمية الاقتصادية، وصولًا إلى تفحّص دور الثقافة في الحياة الاقتصادية، على نحو عام. وهو يرى أن الاستهلاك، مثل الثقة، ينتمي إلى الثقافة إلى حد أنه يجسد شيئًا يقدّره الناس. وفي حين تطورت دراسة الاستهلاك، منذ فترة طويلة، على نحو مستقل عن علم الاجتماع الاقتصادي، فقد حان الوقت لتبذل محاولة لدمجه في علم الاجتماع الاقتصادي. جندر واقتصاد وأسئلة أخرى في الفصل الحادي عشر، "الجندر والاقتصاد"، يشير سويدبرغ إلى أنه جرى تجاهل الجندر على نطاق واسع في علم الاجتماع الاقتصادي الراهن، على الرغم من أن باحثين من مختلف العلوم الاجتماعية أنتجوا مادة ضخمة يمكن الاستناد إليها. ويرى المؤلف أن علم الاجتماع الاقتصادي ينبغي له معالجة المسألة المتعلقة بكيفية دمج الأجزاء ذات الصلة من هذه المادة الضخمة. ويقترح أن يصار إلى الاعتناء بالأفكار الثلاث التالية نظرًا إلى أهميتها البارزة: الاقتصاد المنزلي (المتركز حول فكرة توحيد المصلحة العائلية)؛ والنساء والعمل في سوق العمل (وهي متركزة حول فكرة المصالح النسائية المستقلة)؛ ودور العواطف في الاقتصاد. ويذهب إلى أنه ينبغي ألا ينظر إلى العواطف باعتبارها أمرًا يعيق طرائق عمل الاقتصاد الاعتيادية، والتي هي وجهة نظر شائعة اليوم، ولكن باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الفعل الاقتصادي. أما الفصل الثاني عشر والأخير، "معضلة الهرة وأسئلة أخرى موجهة إلى علماء الاجتماع الاقتصادي"، فكان مجالًا يطرح سويدبرغ فيه مسائل أربعًا أساسية، تحتاج إلى مناقشة بحسب ما يراه موضوعات مهملة، حاليًا، في علم الاقتصاد الاجتماعي، "غير أنها ينبغي أن تكون جزءًا منه، وكيفية معالجة المسألة المتعلقة بالانعكاسية في علم الاجتماع الاقتصادي، مزايا استخدام مفهوم المصلحة في علم الاجتماع الاقتصادي وعيوبه، وأي دور بمقدور علم الاجتماع الاقتصادي تأديته بوصفه علمًا لوضع السياسات".
الدولة: نظريات وقضايا
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدولة: نظريات وقضايا، وهو ترجمة أمين الأيوبي العربية لكتاب The State: Theories and Issues الذي حرره بالإنكليزية كولِن هاي ومايكل ليستِر وديفيد مارش. يعرض الكتاب نطاقًا واسعًا من آراء مجموعة من المرجعيات الأكاديمية في مضمار العلوم السياسية، ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة، إضافةً إلى القضايا البارزة المتنازع عليها في ما يتعلق بالعولمة، والأشكال الجديدة للحكم، والتغيير الحاصل في الحدود ما بين العمومي والخصوصي، علاوة على التغيرات التي طرأت على سلطة الدولة وقدراتها، فضلًا عن تعريفها ومفهومها والتطورات الأخيرة التي طرأت على نظرية الدولة. يتألف هذا الكتاب (544 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمة واثني عشر فصلًا وخاتمة. في المقدمة، "نظريات الدولة"، يعرض هاي وليستِر تعريفًا للدولة ومفهومها، والتطورات الحديثة في نظرية الدولة، وما بعد الدولة، كما يقدمان عرضًا موجزًا للكتاب. تعددية ونخبوية يشدد مارتن سميث، في الفصل الأول، "التعددية"، على أن نظرية التعددية كانت، ولما تزل، منظورًا عظيم التأثير في التحليل السياسي عمومًا، وفي نظرية الدولة خصوصًا، مشيرًا إلى أن التطورات الحديثة في الفكر التعددي وجوهر الاستقرار من صميم المقاربات التعددية. ويتميز هذا الجوهر بتشديد مستمر على مركزية المجموعات، إيمانًا بتقييد سلطة الدولة وفهم السلطة بأنها معممة. ويسلط سميث الضوء على ضعف إخفاق النظرية في إثبات أن الدولة مثار إشكاليات، وميلها المتأصل إلى النظر إليها من منظور حيادي. المفارقة هي أنه إذا كان يُنظر إلى الدولة دائمًا على أنها تمثل النقطة المرجعية المركزية في نظرية الدولة ونقطة انطلاق لجميع النظريات الأخرى، فإن مفهوم التعددية للدولة في حد ذاته لا يتمتع بالتفسير الكافي. أما في الفصل الثاني، "النخبوية"، فيسعى مارك إيفانز إلى استطلاع كيفية تطوُّر جوهر نظرية النخبة، محددًا سلسلة اقتراحات أساسية، منها: يمثل الحكام مجموعة متماسكة ويُنتقون على أساس إمكان حصولهم على موارد اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية، ويعملون ضمن منطقة، وهم معزولون عن المحكومين. وردًّا على الانتقاد النظري والإمبريقي من بعض الوجوه، وبسبب التغيرات التي طرأت مؤخرًا على البنى السياسية والاقتصادية العالمية من وجوه أخرى، يشير إيفانز إلى أن هذه الاقتراحات تغيرت؛ فالنخب السياسية المعاصرة منخرطة في منافسةٍ في ما بينها على أساس نطاق واسع من الموارد. وفي تشديد على التطورات المعاصرة، يختتم إيفانز الفصل بمعاينة النظريات التي تسعى إلى تحليل صور النخب ووظائفها على مستويات الحكم المختلفة. ماركسية واختيار عام يتحدث كولن هاي في الفصل الثالث، "(ما المقصود بالماركسية) نظرية ماركسية للدولة؟"، عن النظريات الماركسية الخاصة بالدولة، منطلقًا من أن كارل ماركس لم يطوّر بنفسه نظرية دولة متماسكة ومنهجية. ويتابع هاي تطورَ هذه النظرية الماركسية بدءًا بشذرات تأملات ماركس في الدولة، عبر الابتعاد عن النزعة الاقتصادية التي استهلها غرامشي، من خلال النقاش الدائر بين البنيوية والقصدية، وانتهاءً بالتعبيرات لبلوك وجيسوب. ويختم هاي هذا الفصل الذي يطور موضوع التغير ضمن المقاربات الأنموذجية وبينها في التعامل مع مفهوم الدولة، بالمجادلة أنه يمكن المقاربة الماركسية تقديم الكثير، على الرغم من المزاعم التي تحكي عن أفول الدولة والماركسية. ويقول أندرو هندمور في الفصل الرابع، "نظرية الاختيار العام"، إن نظرية الاختيار العام ترى الدولةَ من منظور الفشل، باستخدام طرائق اقتصادية وبالاعتماد أساسًا على افتراض أن الأفراد استغلاليون ونفعيون. ويجادل منظّرو الاختيار العام بأن مفهوم الدولة باعتبارها حارسة المصلحة العامة ما هو إلا خرافة، لأن الجهات الفاعلة من الدول تسعى - مثل سائر الأفراد - وراء مصالحها الذاتية بطريقة عقلانية. ويعرض هندمور في هذا الفصل عددًا من الأمثلة عن الطرائق التي أشار منظّرو الاختيار العام من خلالها إلى أن هذه الأعمال النفعية التي تقوم بها الجهات الفاعلة من الدولة تؤدي إلى إخفاق الدولة. مؤسساتية ونسوية ترى يفيان شميت في الفصل الخامس، "النظرية المؤسساتية"، أنه ربما يمكن اعتبار النزعة المؤسساتية الجديدة ردة فعل على افتراضات نظرية الاختيار العام وثورة السلوكيين في ستينيات القرن الماضي. وقد سعت تلك النزعة إلى إعادة تأهيل الدولة، ومثّلت من بعض النواحي استمرارًا لمحاولة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي لإعادة الدولة إلى التحليل السياسي. وكما تجادل شميت، عوضًا عن اختزال العمل السياسي في مكوناته الفردية، سعى أصحاب هذه النزعة إلى تحليل العنصر الجَمْعي للعمل السياسي. ويوجد بالطبع نطاق منوع من النزعات المؤسساتية الجديدة التي تهتم بها شميت: النزعة المؤسساتية للاختيار العقلاني، والنزعة المؤسساتية التاريخية، والنزعة المؤسساتية السوسيولوجية، والنزعة المؤسساتية الاستطرادية. وتتفاوت هذه الاتجاهات في طريقة مقاربتها هذه الرؤية، لكنها تقتسم اهتمامًا بكيفية تكييف المؤسسات للأفعال الفردية، من خلال ترتيبات تحفيزية أو تركات تاريخية أو أعراف تاريخية و/ أو استطرادية. أما في الفصل السادس، "النظرية النسوية"، فتتحدث يوهانا كانتولا عن النسوية، مشيرةً إلى أنه كثيرًا ما عاب الحركةَ النسوية موقفُها الغامض من الدولة. وامتدادًا لفصول أخرى، يجري التشديد على تنوع وجهات النظر النسوية حيال الدولة. كما يشير الفصل إلى ثنائية "الداخل والخارج"، إذ تخضع القدرة التحريرية عند الدولة للنقاش، ولا سيما بين من يرون الدولة حيادية بالضرورة ومن يرونها سلطوية بالضرورة. وسعت مجموعة من المؤلفين في القضايا النسوية إلى تجاوز هذا التباين الصارخ، منهم المؤلفون في دول الشمال الذين يرون فروقًا بين عمليات الدولة ونتائجها بالنسبة إلى المرأة، خصوصًا على صعيد الفروق في الحقوق الاجتماعية. وقد رفض أنصار الحركة النسوية في مرحلة ما بعد البنيوية إجمال توصيفات الدولة، وسعوا في المقابل إلى الإشارة إلى طبيعتها المميزة. خضراء وما بعد بنيوية كان لمنظّري حركة الخضر، في الفصل السابع، "النظرية الخضراء"، مثل نظرائهم في الحركة النسوية، موقفٌ غامض بعض الشيء تجاه الدولة. لكن يجادل ماثيو باترسون وبيتر دوران وجون باري بأن ذلك الوضع تغيّر مع سعي منظّري حركة الخضر إلى المشاركة في إرساء افتراضات وممارسات أساسية متلازمة مع التنمية غير المستدامة. ويمضون في عرض طائفة من انتقادات الخضر للدولة؛ انتقادات تركز على أسباب إنتاج الدولة الحديثة ديناميات غير مستدامة بيئيًّا وكيفية إنتاجها وتوطيدها. لكن يرفض باترسون ودوران وباري وجهة النظر الفوضوية بيئيًّا التي فحواها أن الدولة عصية على الإصلاح في كل زمان ومكان، ويعاينون كيفية سعي المنظّرين إلى "خوضرة" الدولة، مشدّدين على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع، وعلى إجمال توصيفات الدولة، مرددين صدى التطورات التي شهدتها النظريات الأخرى. ويجادل ألن فينلايسون وجيمس مارتن، في الفصل الثامن، "ما بعد البنيوية"، بأن هدف ما بعد البنيوية هو التحقيق في اللغة السياسية وفي الخطاب السياسي لجمع بعض مكوناته وقواعده وكيفية إضفاء الطابع المؤسسي عليه، لفتح ما كان مغلَقًا، وبذلك تتمّ إتاحة مجموعة من البدائل. ويشدد فينلايسون ومارتن في موضوع الدولة على كيفية تشكيك ما بعد البنيوية في الدولة ذاتها، مجادلَين بأن تثبيت الدولة أو تعريفها نشاطٌ سياسي، أي إن الدولة هي حصيلة سياسات وليست أمرًا يُستعان به في تفسير السياسات. في حين يشدد عملُ فوكو في ميدان فن الحكم وتحليله على كيفية توزيع السلطة على شرائح المجتمع باعتبار الدولة والحكومة غير محتوَيتين في حيز واحد، بل يمتد كلٌّ منهما عبر السلطة/ شبكات الاتصال المعرفية. عولمة وتحول يعاين نيكولا هوثي وديفيد مارش ونيكولا سميث في الفصل التاسع، "العولمة والدولة"، كيفية تأثير العولمة في الدولة، إذ يُزعَم على نطاق واسع أن العولمة قادت إلى إضعاف الدولة القومية؛ ففي عالم يزداد تشابكًا، يُزعَم أن الأعمال التي تؤديها الدولة باتت محصورة على نحو مطّرد. لكن، بعد عرض أهم المؤلفات التي تتحدث عن العولمة، يلاحَظ أنه في وقت تحدث فيه تغيرات في الاقتصاد العالمي، يُخفَّف من وَقْعها بالتركيبة الاقتصادية والسياسية المؤسسية العاملة في سياقات معينة. وبناءً عليه، فإن النتائج المترتبة على عملية العولمة غير متسقة أبدًا، وهذا بدوره يستلزم رفضًا لنوع التوصيفات المُجمِلة للعواقب المحتومة للعولمة التي هيمنت على المناقشة. وفي الفصل العاشر، "تحوُّل الدولة"، يعرض غيورغ سورنسن النقاشات الدائرة بين أولئك الذين يرون أن الدولة في طريقها إلى الانحسار والذين يرون أنها ستبقى قوية، وبين موقف مركَب ثالث يشير إلى تغيُّر الدولة وفقدانها بعضًا من نفوذها واستقلاليتها وترسُّخ نفوذها في نواحٍ أخرى في الوقت عينه. ويعاين سورنسن التحول الذي تشهده الدولة في ناحيتَي الاقتصاد والسياسة الأساسيتين وتحولها على صعيد مفهومَي الجماعة والسياسة الأساسيين، وهذا ما يشير إلى أننا نشهد تغيرًا من الدولة الحديثة كما يسميها إلى دولة ما بعد الحداثة. ويذكّرنا بأسلوب نافع مفاده أن المواقف من تحول الدولة تتأثر بقوة بنظريات الدولة المختلفة التي تصوغ تلك المواقف. حوكمة وحكومة يرى براينارد غاي بيترز وجون بيير في الفصل الحادي عشر، "الحوكمة والحكومة والدولة"، أن ما يحصل هو تحوُّل في مركزية الحكومة في الحوكمة، وفي كيفية عمل الحكومة، ضمن هذا الترتيب الجديد. ويدعوان إلى تقديم الأولوية التحليلية للدولة وأهميتها المستمرة على تحليل دور مؤسسات الدولة في الحوكمة. ويجادلان بأن الدولة تكيّفت بما يتلاءم مع نمط حوكمة مختلف، وهو نمط ذو سيادة مختلطة أو مزدوجة يستخدم الأدوات المختلفة لتنفيذ السياسة واللامركزية. وعوضًا عن تقليص دور الدولة في الحوكمة، ربما تجسِّد هذه التغيرات إعادةَ تأكيد تأثير الدولة، أي إن الدولة تمارس صلاحياتها بطرائق مختلفة. أما في الفصل الثاني عشر، "العام/ الخاص: تخوم الدولة"، فيشير ماثيو فلندرز إلى أن الدولة موسومة بالانقسام والتفكك، ويتطرق إلى الأخطار المحتملة إذا نظرنا إلى الدولة باعتبارها كيانًا متجانسًا. ثم يعاين المجالَ الأرحب للحوكمة العامة الموكَلة أو الموزعة، أي المنطقة الرمادية التي تمثل فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص ناحية مهمة. وفي الخاتمة، يسعى محررو الكتاب إلى تحديد بعض الموضوعات الشائعة والقضايا التي استجدت في الفصول السابقة، ويعودون إلى موضوع التقارب بين نظريات الدولة التي نوقشت في الطبعة الأولى لكتاب النظرية والطرائق لمارش وستوكر. وفي الاستنتاجات، يعيدون دراسة القضية ليحددوا إن كان يمكن ملاحظة مثل هذا الميل عند دراسة نطاق أوسع لوجهات النظر المتصلة بالدولة.
ولاية الموصل العثمانية في القرن السادس عشر دراسة في أوضاعها السياسية و الإدارية والاقتصادية
تعود صلتي بتاريخ العراق في العهد العثماني الى اواسط السبعينيات, عندما أعددت رسالة علمية عن أوضاع العراق السياسية 1638- 1750 م( ) وقد لفت نظري قلة الدراسات التاريخية الجادة عن تاريخ ولاية الموصل خلال القرن السادس عشر بسبب ندرة المصادر والوثائق فضلا الى ان القرن السادس عشر قرن غير مستقر في إحداثه التي أخذت طابعا دراماتيكيا فعالا سواءا في أسبابها او في النتائج التي تمخضت عنها.ومن جانب اخر فأن دراسة احداث الموصل خلال هذا القرن دراسة علمية, تقودنا الى فهم افضل لاوضاع العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القرون التالية على نحو ادق وافضل.
جزر دياويو (سلسلة المحيط في الصين) (باللغة العربية)
"جزر دياويو" يشمل المحتوى الرئيسي للكتاب تسعة موضوعات: التعرف على جزر دياويو وقيمتها، لماذا تنتمى جزر دياويو إلى الصين، كيف انتزعت اليابان جزر دياويو من الصين، وجوب إعادة جزر دياويو للصين بعد الحرب الثانية، "وصاية" أمريكا تدفن جذور الحادثة، التفاهم المتبادل حول اتفاق "وقف النزاعات"، من يقوم بـ "تغيير الوضع الراهن"، الجهود المبذولة لحماية حق سيادة الصين على جزر دياويو. من خلال عرض هذه القضايا يحاول الكتاب عرض مشكلة جزر دياويو بشكل كامل ومن جميع النواحي ، لتوضيح الحقائق التاريخية والأساس القانوني لانتماء جزر دياويو للصين. ونقد رأى وموقف اليابان الذى لا أساس له من الصحة واستفزازها الغير قانوني، وكشف الحقيقة للجميع، ووضع الأمور في نصابها.
الوسط المتعالي
افضت بنا مجموعة من الابحاث الاكاديمية التي اجريناها في جامعة بواتييه في فرنسا خلال الاعوام الخمس المنصرمة , و التي تمحورت حول مفهوم الانبثاق ومصدره , الى الاقرار بأسبقية الوسط على الكائن و بهيمنة الكلية على التمظهر العابر و بعلو الشمولية على التفرد , ولأجل ذلك اتخذت ابحاثنا وجهة اخرى انطلاقاً من حادثة ظهور الكائنات لكي تحاول تفسير انماطٍ متباينةٍ من العلاقات التي تحفل بها الاوساط والتي تؤدي الى ابداع كل ما هو جديد في هذا العالم. تُعَدُ العلاقات التي تربط ما بين اي كيانٍ نُدرِكهُ والاجزاء الداخلة في تركيبه والخارجة عنه من اكثر القضايا الفكرية اثارة للجدل , انها علاقات الكُلِ بمكوناته وعلاقاتِ الوسطِ بمحتواه وعلاقة الكيانِ المُفردِ بكل ذلك. ولذا فهي محكومةٌ بهيمنةِ المُتعددِ اولاً و من ثَمَ بخضوعِ هذا الاخير الى التوحيد. وفي اطار مِثل هذا سنكون مُلزمين بالبحث فيما هو في باطن كينونة الاشياء وعن كنهها وفي ما يحدّها كمحيط جامع ممتد والى ما وراء هذا المحيط ان استطعنا. انها علاقاتٌ تنُبوءُ عن تعقيدٍ شديدٍ وهي ذوات قابلية كبرى على جذب الاهتمام الفلسفي اولاً و من ثمَ الرغبة في تطبيق المنهج العلمي التجريبي على جميع ما يحتويه الكون من مُكونات. الا ان هذه النمط من العلاقات , الذي لا يمكن فَهمَهُ وادراك فحواه الا على نحو جمعي , سيستعصي على التفسير المُولع بتطبيق النظريات العلمية scientistes لشدة ما يعتري الرؤية التجريبية من غموضٍ وتداخلٍ لمجالاتٍ متباينةٍ , فيما تكون الفيزياءُ الحديثةُ والكُمومية على وجه التحديد شاهدة على غرابة وعمق غور الواقع المادي.
من وراء المنظار
عجيبة هي البسمات! كم تتخذ من واقع الحياة الاجتماعية المأساوي مادةً لبسمة ترسمها صور انتقادية فكهة اصطفاها الكاتب من حياتنا الاجتماعية؛ ليعرض لنا من خلالها العديد من القضايا الاجتماعية والقومية التي تتصدر المشهد الاجتماعي المصري بصورة تزخرفها بسمة ولَّدتها مأساة حياة أشخاصٍ كانوا أبطالًا لمشاهدات الكاتب. ومَنْ يتأمل موضوعات هذا الكتاب يجد أن الكاتب قد ترسَّم في أبطاله مبدأ الواقعية الذي يبرهن أنَّ للبسمات فلسفةً عميقة منها تتولَّد المشاهد الواقعية للمجتمع في صورة شخصياتٍ تنبض بحركة الحياة فيه. وقد برهن الكاتب من خلال هذا الكتاب على أنَّ الفكاهة العاقلة هي التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يشاهد قضايا مجتمعه بمنظارٍ من الواقعية مُغلَّف بمشاهد تسلط الضوء على قضايا المجتمع بواسطة مشاهداتٍ من واقع الحياة الإنسانية.
النظرات
مجموعة من المقالات الاجتماعية والسياسية والدينية، حرص «المنفلوطي» من خلالها على معالجة شئون المجتمع. فعلى الصعيد الاجتماعي — الذي استأثر بالقسم الأكبر من كتاباته — دعى للإصلاح، والتهذيب الخلقي، والتحلِّي بالفضائل، والذود عن الدين والوطن، ونادى بضرورة التحرر من الخرافات والجهل والخمول والكسل. كما خصَّ المرأة بمقالتين؛ أكد فيهما على مكانتها وأهمية دورها في الحياة. وفي المجال الديني؛ رثى لبُعد المسلمين عن دينهم، وعزا ضعفهم إلى البعد عنه. كما ثار على الخرافات التي ابتدعها المسلمون؛ مثل: تقديم النذور للأولياء، وبناء الأضرحة على القبور، وغيرها من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وسياسيًّا تحدث عن القضية المصرية ووصف حال الأمة المصرية المنقسمة آنذاك، كما أشاد بالزعيم الوطني «سعد زغلول» واصفًا إياه بأنه «منقذ الأمة».
تأملات
هو كتاب يضم عددًا من المقالات والتأملات الفلسفية والأدبية والسياسة والاجتماعية، وهذه المقالات تحمل في جنباتها كثيرًا من سِيْمَاءِ تحضُّرنا عَبْرَ أروقة الزمن. ويَعْمَد الكاتب في هذا المؤَلَّف إلى الحديث عن القيم المعنوية المجردة: كالصداقة، والحرية، والتضامن، ويتحدَّث عن القضايا السياسية والاقتصادية في نطاق المنظور الجمعي لها؛ أي في إطار شمولها لقضايا الأمة ومشكلاتها، ويتحدث عن عظمة الآثار المصرية في عيون عشاقها الذين يتوسمون مجد حضارتها فى كتب التاريخ، ويَفِدون إليها من كل حدبٍ وصوبٍ؛ كي يروا مقاليد تلك العظمة مُجَسَّدَةً في آثارها. ومن يقرأ هذا الكتاب يجد أن الكاتب قد ضمَّن مؤلَّفَه العديد من القضايا على كافة الأصعدة، وفي مختلف الجوانب الحياتية.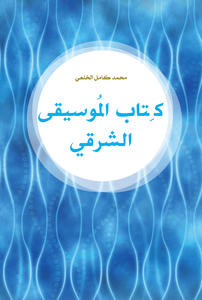
كِتاب المُوسيقى الشرقي
تعلم محمد كامل الخلعي الكثير حول علم النغم والتصوير والأوزان، وعزم على تدوين هذه الخبرة الفنية في هذا الكتاب الذي ضمنه الكثير من ألحانه وألحان أساتذته. وقد أضاف في كتابه هذا صورًا لمشاهير عصره، واختار البديع من ألحانهم وموسيقاهم.
لعب العرب
تزخر الثقافة العربية بالعديد من المنتجات الفنية والإبداعية الضاربة بجذورها في التراث العربي كالفنون الشعبية بأنواعها، وكذلك أشكال الترفيه ووسائل التسلية السائدة قديمًا، والتي تعكس ملامح البيئة العربية وبعضًا من خصائصها الاجتماعية، ومن خلال دراستنا للتراث تتكون لدينا فكرة عن طبيعة الحياة التي عاشها أجدادنا وتفاصيلها اليومية؛ حيث يُمْكِنُ تَلَمُّس حقائق ومعلومات نفيسة لا نجدها في التاريخ المُدَوَّن، فيرى المؤرخون أن لكل مأثورة أو حكاية شعبية أو تقليد من التقاليد أصلًا يعود إلى بعض الحقائق المحددة في تاريخ الإنسان، وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب وصفًا للألعاب التي كان يتسلى بها أطفال العرب قديمًا؛ حيث يمكن أن نستشف القيم التربوية والتقاليد التي كانت تُغْرَسُ في نفوس الأطفال من خلال اللعب؛ كالصبر والتعاون والمنافسة الشريفة وغير ذلك.
ما هي النهضة
«ما هي النهضة؟»، سؤال صارت الإجابة عنه محيرةً بعد أن كانت يقينيةً! ومجهولةً بعد أن كانت معلومةً! وظنّيةً بعد أن كانت قطعية! واحتمالية بعد أن كانت حتمية! ومستحدثة بعد أن كانت مألوفة! وهذا لا يعني سوى تبدل الأحوال وتغير الأقوال حول ظاهرة النهضة الأوروبية كظاهرة تاريخية. فالبداية كانت مع الحداثة التي فسرت ما أُطلق عليه «عصر النهضة» باعتباره ثورة على التقاليد الكنسية الفاسدة في أوروبا آنذاك، وإحلال لمرجعية العقل محل مرجعية الدين، وبدا وكأن التاريخ يأخذ شكلًا خطيًا يتقدم فيه الإنسان من الأسوء إلى الأحسن، حتى يصل إلى الفردوس الأرضي! هكذا كانت قصة النهضة في السرد الحداثي، تشوب نصوصها نزعة اليقينية والحتمية والمألوفية، ويمكن أن تندرج إجابة سلامة موسى عن سؤال «ما هي النهضة؟» تحت هذا النوع من السرد. إلا أن الدراسات النقدية للحداثة التي قدمها فلاسفة وعلماء أمثال (نيتشه، ماكس فيبر، مارتن هيدجر، كارل ماركس) فككت هذه الرؤى الفردوسية لمفهوم النهضة، وتبعتها في ذلك المدارس التاريخية المنتمية إلى تيار ما بعد الحداثة، التي وصل الأمر ببعضها إلى تسمية عصر النهضة والاستنارة بعصر «الاستنارة المظلمة» من قبيل السخرية.
الفونيم وتجلياته في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، سورة البقرة نموذجاً
كتاب "الفونيم وتجلياته في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم" ، تأليف : بسام مصباح أغبر، والذي صدر عن دار الجندي للنشر والتوزيع نشأ علم التجويد مع نزول القرآن الكريم، وقد استدل د. أحمد مختار عمر، من نص ابن مسعود السابق ذكره، على "أن نشأة علم التجويد جاءت استجابة لدعوة ابن مسعود، ومحاولة لتقنين قواعد القراءة اقتفاء لأثره. ويقف د. غانم قدوري الحمد، أمام نص ابن مسعود السابق ذكره، ويرفض تعليل د. أحمد مختار عمر، فيقول:" وحين تتبعت هذه الرواية في المصادر القديمة، وجدت أنها تنقل الرواية على نحو آخر لا تصلح للاستشهاد فيما نحن بصدده، فقد جاء فيها (جَرِّدُوا) بالراء بعد الجيم مكان (جودوا) بالواو بعد الجيم، ويترجح لديّ أن الرواية تصحفت في المصادر المتأخرة، لأنها تنقل النص بإسناد ينتهي إلى أسانيد المصادر القديمة، ثم يختلف النص بعد ذلك في حرف واحد. وهذه الرواية تتعلق في الأصل بموضوع تجريد القرآن من الزيادات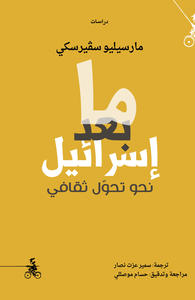
ما بعد إسرائيل - نحو تحول ثقافي
"يؤكّد مارسيلو سڤيرسكي في هذه الكتاب، الجديد والفريد من نوعه، على أنّه ليس هناك حل سياسي مطروح في الوقت الراهن يمكنه أن يوفّر الماهيّة الثقافية اللازمة لإحداث تحوُّلٍ على أساليب بقاء دولة إسرائيل وسبُل الحياة فيها. يُناقش سڤيرسكي، على نحوٍ مثير للجدل، فكرة أن المشروع السياسي الصهيوني غير قابل للإصلاح؛ أي أنّه الوحيد الذي يؤثّر سلباً على حياة المستفيدين منه كما على ضحاياه أيضاً. بالمقابل يهدف الكتاب إلى إحداث موقف معاكس، يسمح لليهود الإسرائيليين باكتشاف الآلية التي تمكنهم من تجريد أنفسهم من الهويات الصهيونية وذلك من خلال الانخراط بالأفكار والممارسات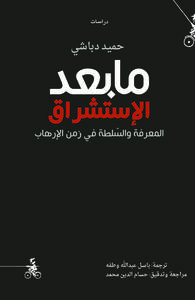
ما بعد الإستشراق: المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب
يُعتبر هذا الكتاب سجلاً متيناً لتأملات حميد دباشي على مدى سنوات عديدة في مسألة السلطة والقوة المؤهِّلة للتمثيل. مَن في مقدوره أن يُمثِّل من، وبأيّ سلطة؟ عندما أخذَت الآلة العسكرية الأقوى في تاريخ البشرية، الولايات المتحدة الأميركية، زمام المبادرة على نحوٍ فعلي وانخرطت عميقاً في أفغانستان والعراق، أصبح الحديث موسعاً بشأن أفعال التمثيل العسكرية هذه والتي باتت أكثر تجذُّراً من حيث ادعائها بأنها مفوّضة على الصعيدين القياسي والأخلاقي. لا يُمثّل كتاب دباشي هذا نقداً للتمثيل الكولونيالي، بقدر ما يتحدّث عن آداب المقاومة وأنماطها والتصدّي لهذا التمثيل. وفي سعي حميد دباشي للوصول إلى نمط من إنتاج المعرفة دفعة واحدة لما وراء الأسئلة المشروعة التي أثيرت حول موضوع السيادة، ومازالت حتى الآن مؤثِّرة وقوية على الصعيد السياسي، فإن التفويض الكولونيالي مسألة مركزية. يقوم الجدل الذي يطرحه دباشي على أنّ صورة فكر المنفى هي في نهاية المطاف الركيزة الأكثر أهمية لإنتاج التفويض القياسي والأخلاقي بشعورٍ مرّدُه الوجود الدنيوي. وهي القاعدة الأساس أيضاً للوصول إلى نِتاج معرفي مُضاد في زمن الإرهاب.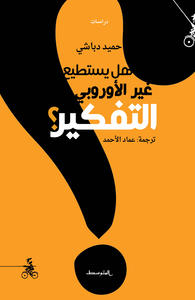
هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟
يصوغ هذا الكتاب منظوراً جديداً في نظرية ما بعد الاستعمار، حيث يتساءل حميد دباشي: ما الذي يحدث للمفكرين الذين يشتغلون خارج السلالة الفلسفية الأوروبية؟ ومن خلال الخوض في هذه الجدلية الإشكالية، يناقش حميد دباشي اعتبارهم مهمّشين وموظّفين ومزيّفين. نجد دباشي هنا مشاكساً كبيراً، ومتحدياً عنيداً، ولكنه، كما اعتدناه دائماً، أنيقاً. حيث يدرس، بحلّة جديدة، الطريقة التي يستمر من خلالها النقاشُ الفكري في ترسيخ نظام كولونيالي للمعرفة، مستنداً لسنوات من الدراسة والنشاط، ليقدم لنا في كتابه هذا مجموعة حصيفة من الاستكشافات الفلسفية التي تثير الحفيظة والفرح على حد سواء.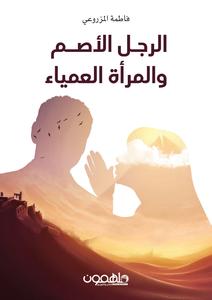
الرجل الأصم والمرأة العمياء
"كم نظلمك ايها الحب!! ليست المعضلة في عدم الزواج و العنوسة .. المشكلة في نسب الطلاق المرتفعة .. المشكلة الحقيقة تكمن في غياب الحب ! نحن نفتقده بشدة في حياتنا اليومية .. يقول وليام شكسبير " تكلم هامساً عندما تتكلم عن الحب" قد يكون السبب ان هناك كثيرين سوف يحسدونك لان الحب لا يقدر بثمن"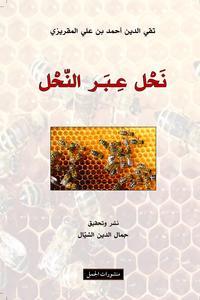
نحل عبر النحل
وصف الله الحق سبحانه وتعالى عسل النحل بأنه شراب مختلف ألوانه، ذلك لأن منه الأبيض ومنه الأحمر والأصفر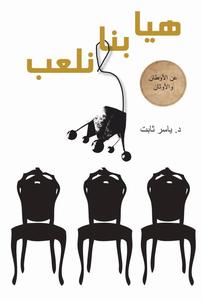
هيا بنا نلعب: عن الأوطان والأوثان
شر البلية ما يضحك. ونحن العرب لدينا الكثير من المضحكات المبكيات التي تسترعي الانتباه وتستدعي التأمل والتفكر. وحين نقرأ كتاب التاريخ العربي وأسفاره الضخمة، سنكتشف الكثير من المفارقات والخدع المذهلة لشعوبٍ عانت وعاشت طويلاً تحت حكم استبدادي يرى في الديمقراطية ترفـًا لا لزوم له، ويعتبر الوطن إرثـًا عائليـًا بامتياز. مشاهد غابت عنها فكرة الدولة واحترام القانون، واختفى فيها مصطلح الديمقراطية، كما لو أنه فص ملح.. وذاب! وهذا الكتاب ليس سوى ثمرة مئات بل آلاف التفاصيل التي تراكمت في الذاكرة طوال سنوات، ثم انفجرت على هيئة كلمات. والكلمة أشفّ من البلور وأقطع من السيف. إنها مقالات كتبتها على فتراتٍ متباعدة عن السياسة وأحوالها وأطوارها في الشرق الأوسط، الذي أرهقتنا أحداثه وأزهقتنا حوادثه.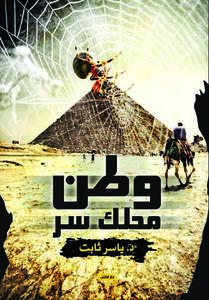
وطن محلك سر
في الظروف السياسية الراهنة، تحتاج مصر إلى خلق دولة قوية تقوم على سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان والمواطنة وتوفر وسائل المحاسبة ومساءلة السلطة الحاكمة بها، مصر بكل تأكيد لا تحتاج إلى دولة قامعة باطشة تتجاهل الحقوق والحريات الأساسية وتسعى لترقب المواطنين وموراقبتهم مع كل شهيق وزفير. الدولةُ هي سياجُ الحرية، وجدارُ الهوية، وحصنُ الانتماء، ولكن لا يجوز لها أن تكون قيدًا على الحرية، ولا أن تصبح راعيـًا رسميـًا للتخلف والبؤس والفقر وسوء الخدمة وتدهور المرافق.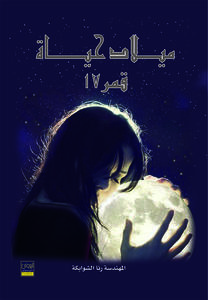
ميلاد حياة قمر 17
يناقش "قمر 17" بشكل مباشر المشاكل التي يواجهها الإنسان سواء في مواقفه اليومية، أو المشاكل الحياتية العامة، محاولا تقديم حلول متعددة لها ، منها ما هو روحاني يُشعر النفس بالهدوء والأمل، ومنها ما هو عقلاني. ويدعو النفس إلى التفكير والتأمل، رغم آلام الجسد، واصطخاب الوعي والوجدان؛ لارتقاء بالذات المبدعة إلى أعلى درجاتها. ويصور بجمالية فنية هما إنسانيا، وجرحا بشريا عميقا بدأ من الماضي ليصل إلى الحاضر، متضمنا مأساة نعاين فيها مكابدة الاندماج، وصخب التمرد والثورة، وظلم الآخر، والتوق إلى مجتمع يخلو من الظلم! ويزدان الكتاب بالآيات القرآنية، والأحديث النبوية، والأشعار، والمقولات المأثورة، التي تدعم الحقائق والمعلومات، والموضوعات المتعددة الواردة في الكتاب، مثل التعامل بايجابية مع المراهقين والمراهقات، ومع مشاكلهم واحتياجاتهم، واكتشاف الإبداع بداخلهم، والمواهب التي يتمتعون بها وإشراكهم في المناقشات، واتخاذ القرارات، والاهتمام بهواياتهم، وخاصة وسط تدهور القيم في المجتمع. "قمر 17" يركز على العيش بسعادة، والعمل على توفير أسبابها، وظروفها لنا، وللآخرين، فالحياة قصيرة، وبها من المرارة الكثير، لذا علينا أي لحظة سعادة مهما كانت قصير. ويبين أفضل الطرق لاختيار الزوجة، وتعزيز الحبّ معها، لبناء مجتمع صالح تسوده المحبة، واحترام الآخر. كما يبين علاج كثير من الأمراض الاجتماعية كالنفاق، والكذب، والحسد، والإصابة بالعين . ويقدم "قمر 17" موضوعاته بتدفق سردي الإبداعي..يمدنا بعوالم تشدنا إليها الصور واللغة والتفاصيل الموظفة؛ لإبراز مجموعة من المكونات: شخصيات، زمان، مكان، أحداث. في "قمر 17" تجربة إنسانية غنية يتداخل في نسيجهها المعرفي الحكاية والقصة، والسيرة الغيرية، مع التحليل الاجتماعي، والرؤية المجتمعية الناقدة والمنتقدة، والحاملة للنفس النفسي، والسبر في اللاشعور، ورفض المصادرة والوصاية، وكل مظاهر التسلط والقهر... والتمرد على كل القيم الرافضة للآخر، القامعة لحريته.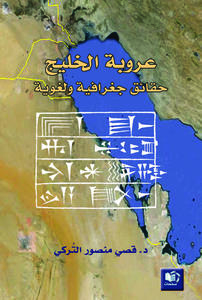
عروبة الخليج: حقائق جغرافية ولغوية
علينا أن نحدق بعمق لمعرفة هوية الانسان الخليجي الذي عرفت جغرافية أرضه واسمه وانتماءا حضاريا لا يدع مجالا للشك بأن اسم الخليج وهويته العربية من بين الحقائق الجعرافية اللغوية التي لامناص من ذكرها ليطلع عليها المختصون أو غيرهم من الراغبين في معرفة الحقيقة العلمية من وجهة نظر ثقافية وحضارية , والتي عرضنا لها في كتابنا هذا من خلال سرد لأهم الوثائق والكتابات النصية الاثارية والتاريخية .
حرارة قلم
بدأت علاقتي بالقلم في المرحلة المتوسطة من أيام المدرسة, فقد كنت بعد انتهائي من المذاكرة أكتب في صفحات عديدة " ماذا تعلمت من الحياة ", وتارة في الاختبار النهائي حينما أنتهي من حل الأسئلة باكرا أشرع في كتابة خواطر فكري على خلف ورقة الأسئلة إلى أن يحين وقت المغادرة من قاعة الاختبار . وفي تلك الفترة كانت كتاباتي متواضعة جدا و أقل من المستوى العادي, و بدأت بعدها أجتهد في إصلاح اعوجاج قلمي . ومما تعلمته من خلال مسيرة إصلاح القلم أن مما ينضج القلم ويجعله أكثر حكمة وحرارة وقوة في التأثير هو ممارسة التأمل والتفكير بعمق وترجمة هذه العمليات الفكرية على السطور . كنت مرارا وتكرارا أسأل نفسي سؤالا: ماذا قدمت للأمة الإسلامية ؟
داعش.. الطريق إلى جهنم
كشف كتاب "داعش .. الطريق إلى جهنم" عن شهادات وصور وأسرار تنشر لأول مرة عن تنظيم الدولة ألإسلامية في العراق والشام (داعش) ، مستعرضاً بداية التنظيم وتطوره حتى الآن. الكتاب جاء في سبعة فصول تناولت نشأة التنظيم وأهم مشاهيره من الرجال والنساء واستخدامه للأطفال والغلمان كما تطرق لمصادر التمويل فيما تم تخصيص الفصل الأخير لدواعش الكويت. وتحدث الكتاب عن وسائل العقاب التي يتبعها التنظيم أو ما يسميه بإقامة الحدود ، مستعرضاً سيرة الخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي ، الملقب بالمسردب ، وكذلك أبو هيب النجم الهوليودي ، واسلام يكن ( أبي سلمة ) الباشا المصري الداعشي ، والناطق الرسمي للتنظيم الراحل أبو محمد العدناني ، ومفتي التنظيم البحريني تركي البنعلي ، وذباح داعش محمد اموازي. وكشف الكتاب عن تفاصيل إنشاء التنظيم لكتيبة الخنساء النسائية التي تضم مجموعة من القياديات من بينهن السعودية أخت جليبيب التي كانت أول سعودية تعلن نفيرها لأرض الخلافة المزعومة ، وكذلك مجموعة أم عمارة بقيادة البريطانية أقصى محمد ، كما عرج على سيرة شاعرة "داعش" السعودية الملقبة بأحلام النصر . كما أفرد الكتاب عدداً من صفحاته للحديث عن جواري "داعش" الإيزيديات الهاربات اللواتي قالت عنهن أم سمية القيادية الداعشية (سقناهن بحد السيف كالغنم والعزة لله ) ، ومنهن نادية مراد التي التقاها الكاتب وروت له تفاصيل العذابات التي مرت بها على يد التنظيم . غلمان الخلافة وأشبالها ، كانوا محط اهتمام الكاتب أيضاً فعرض لآلية تدريباتهم الشاقة وأهم التفجيرات التي قام بها أطفال داعش ، وسيرة أشهرهم الراحل محمد العبسى المكنى بأبي عبيدة والمعروف بشبل البغدادي . وبين الكتاب مناطق توزيع ولايات "داعش" التي أعلنها في أكثر من دولة والدواوين ( الوزرات) التي تدير شؤؤون منتسبيه ومصادر التمويل المختلفة والغنائم وكيفية تقسيمها . واختتم الكاتب كتابه بفصل عن دواعش الكويت ، مستعرضاً تفاصيل عن أبي المنذر الكويتي المسؤول الشرعي في "داعش" والذي قتله جيش الإسلام بعد أن أسروه في اشتباكات بين الطرفين ، وكذلك أبو أنور الكويتي الذي تحول من دراسة العلوم التكنولوجية في أميركا للإلتحاق بالتنظيم ، وأبو تراب الكويتي ، الذي أبحر للرقة تاركاً دراسة العلوم البحرية لناقلات النفط في المملكة المتحدة .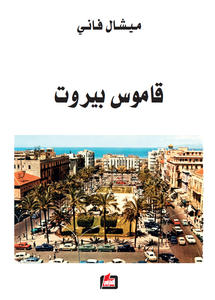
قاموس بيروت
تُقدم بيروت سلسلة من الأمكنة التي لا تُشبه الأمكنة، إذ هي خارجة عن أي هندسة، عن أي تحديد، إذ هي تُثير جنون الذاكرة، كما البوصلة التي أصاب عقربَها عطلٌ فأخفقت في الاتجاه. إنّها مساحات تبدو وكأنها لم تحتفظ بالذاكرة ولم تولّد ذاكرة جديدة. لقد كانت هذه الأمكنة بمنزلة رواسب المدينة وذاكرتها. بيروت مدينة لا جدوى من مُداعبة ألمها. فهذا الأمر لا يُسكّن أي شيء، إذ إنّ الألم موجود في مكان آخر. إنها مدينة يقتضي اقتطاع ألمها وبسطه عند ساحة البرج، وهي المدينة الوحيدة التي تستثمر الاستعارات والكوابيس كافة، كابوس تحققها الفوري من خلال الطريقة التي تُسمّركم فيها في مكانكم، خارج أي حقيقة قابلة للفهم، بل فقط في إطار حقيقة هذه القبضة، على غرار الكلس الحي. كل شيء فيها هو ذلك اليقين المحروق، آه! بلا حماسة تُذكر، بل محروق على أي حال. لقد كنتُ من المُشاة خلال بضع سنوات في بيروت. ها أنا أسمع وقع خُطاي وأنا أتجه نحو ساحة البرج، شارع ويغان، وشارع فرنسا، حيث تمر المدينة أمامنا، ويكفي أن نُشاهدها بلا أي مسافة من أجل أن نحتفظ بها. وجدتُ نفسي أقوم بنقوش على المعدن في السجن العثماني السابق الذي كان يُطل عبر فتحتين صغيرتين على جانب كنيسة مار لويس للكبوشيين. كُنا نصل إليها عبر درج ضيق جداً، ينبغي سلوكه بمُنتهى الحذر، وخصوصاً عند حمل سُطول المياه. لطالما هناك أسلوب للعيش في بيروت هو في آن أسلوب يحوي ضغطاً عارماً وأملاً بلا حدود، يُلقي بثقله على كل شيء، على غرار طلاء من الرصاص غير قابل للازالة، وذلك من باب الإنهاك. كل شيء مُسيّج بشدة بما قد يُسميه مُشاهد من الخارج طقساً من عهد آخر، وثقل الزمن العثماني والأزمنة الأخرى المُدمرة.
مبادئ الصحافة العامة
هذه السلسلة من المحاضرات التي ألقاها الدكتور محمود عزمي بين عامي ١٩٤١-١٩٤٢م في معهد الصحافة العالي بجامعة القاهرة، تُعَدُّ واحدةً من أهم المراجع فيما يتصل بمفاهيم الصحافة ومصطلحاتها، والعناصر المادية والقانونية والفنية المكوِّنة لها، فضلًا عن علاقتها بالرقابة الحكومية، وكذلك أساسيات العمل النقابي الصحفي. ينطلق المؤلِّف في عرضه لمادة الكتاب من واقع الصحافة المصرية وتطوُّرها في تلك الحقبة، ويعقد من حين لآخَر مقارناتٍ مع الوقائع المقابلة في دول أخرى حظيت بتجارب مغايرة، لا سيَّما في الغرب. كما يتناول عزمي في آخِر فصولِ الكتابِ «الإذاعةَ» كمظهرٍ من مظاهر الرصد الذي يتشابه مع الصحافة في وجوهٍ ويختلف في أخرى، في الوقت الذي كانت فيه الإذاعة لا تزال في طور النشأة.
بهدوء.. جمال العلاقات الزوجية
دليل متكامل لكيفية نجاح العلاقات الزوجية بدءاً من أسس إختيار الزوجين مروراً بعلاج الأفات والمشكلات الزوجية وإنتهاءاً بكيفية التربع على عرش زوجك وزوجتك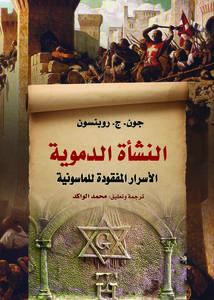
النشأة الدموية: الأسرار المفقودة للماسونية
لقد استخدمت الماسونية لقرون رموزها وطقوسها الغامضة في سرية تامة، وذلك قبل أن تكشف عن وجودها في لندن في عام 1717م. ما إن أصبحت الماسونية معروفة، انتشرت في أنحاء العالم كافة، واستقطبت الملوك، والأباطرة، ورجال الدولة؛ لكي يقسموا يمينها المقدّس. استقطبت - أيضاً - الثوريين العظماء؛ مثل جورج واشنطن، وسام هيوستن في أمريكا، خواريز في المكسيك، وغاريبالدي في إيطاليا، وبوليفار في أميركا الجنوبية. كما أنها مُنعت لقرون من قبل هتلر، وموسوليني، وآية الله الخميني. ولكنْ؛ من أين أتت هذه المنظمة القويّة؟ ما الذي كانت تفعله في تلك القرون السرية قبل أن تخرج من سريتها إلى النور قبل أكثر من 270 سنة؟ ولماذا هذه الكراهية العمياء والهجوم الشرس الذي شنته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ضد الماسونية؟هذه الرواية البوليسية المدهشة تجيب عن تلك الأسئلة، وتُثبت أن فرسان الهيكل في بريطانيا، الذين فرّوا من اعتقال وتعذيب البابا والملك، قد شكّلوا جمعية سرّية ذات حماية متبادلة، أُطلق عليها - فيما بعد - اسم: الماسونية. بناء على سنوات من البحث الدقيق، هذا الكتاب يحلّ آخر ما تبقّى من ألغاز الماسونيين - كلماتهم، ورموزهم، وألغازهم السرية التي فُقدت معانيها الحقيقية في العصور القديمة. مع خَلفية غنية تلقي الضوء على المعارك الدامية، وعلى الملوك الانتهازيين والباباوات الماكرين، وعلى التعذيب والاضطهاد الديني الذي مُورس في القرون الوسطى، نجد أن هذا الكتاب القيّم والمهمّ يجعلنا نلقي نظرة جديدة على تاريخ الأحداث التي أدّت إلى الإصلاح البروتستانتي. جون ج. روبنسون هو كاتب ذو اهتمام خاص، في تاريخ بريطانيا، في العصور الوسطى، وفي الحروب الصليبية. يترأس أمانة أسرية مُكرَّسة للبحث التاريخي والنشر. السيد روبنسون هو مدير أعمال تنفيذي، ومزارع أغنام، وجندي بحرية سابق، كما أنه عضو في أكاديمية العصور الوسطى الأمريكية، وفي منظمة المؤرّخين الأمريكية، وعضو في اتحاد المراقبين الملكي في لندن. يعيش في مقاطعة كارول في كنتاكي.
ثراء شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
نبذة عن كتاب: (شينجيانغ الغنية الخصبة) وصف هذا الكتاب الموارد الخصبة والغنية ذات السمات الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها شينجيانغ بأسلوب حيوي دقيق، كما سلط الضوء على موارد المناظر الطبيعية الرائعة وموارد المياه والتربة والضوء والحرارة المتوفرة في شينجيانغ والحيوانات والنباتات النادرة والموارد المعدنية الغزيرة والمحاصيل الزراعية الوفيرة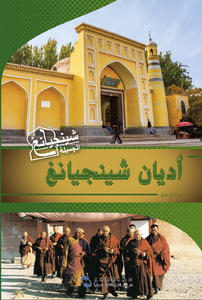
أديان شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة) (باللغة العربية)
ينقسم كتاب (شينجيانغ المتنوعة) إلى خمسة أجزاء رئيسة، تتمثل فيما يلي: المعتقدات الدينية القديمة بشينجيانغ وتعاقب الأديان الوافدة على شينجيانغ والسياسات الدينية المتسقة والمعالم الدينية العريقة والأعياد الدينية. ويتناول الكتاب بالأدلة والبراهين تطور الأديان البدائية والشامانية والزرادشتية والبوذية والطاوية والمانوية والنسطورية والإسلام والمسيحية وغيرها من الديانات الأخرى في شينجيانغ، بالإضافة إلى التأثير الكبير للأديان المختلفة على شينجيانغ في فترة من الفترات.
حيوية شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
يتناول كتاب (حيوية شينجيانغ) الإنجازات والنتائج المتميزة التي حققتها شينجيانغ منذ عهد الإصلاح والانفتاح تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي ظل الجهود المشتركة بين كافة القوميات بشينجيانغ معتمدا على التغيير والتنمية التي حظيت بها شينجيانغ في العصر الحديث، وذلك من خلال مجموعة من الجوانب مثل تطور النقل والمواصلات بشينجيانغ والتحضر والزراعة والصناعة والقضايا الاجتماعية والجوانب المعيشية وغيرها، كما استعرض الكتاب الحياة السعيدة التي تمتعت بها كافة قوميات شينجيانغ في ظل العصر الحديث. وهكذا يكون الكتاب قد قدم للقارئ شينجيانغ الحيوية التي تتمتع بالنشاط والعزيمة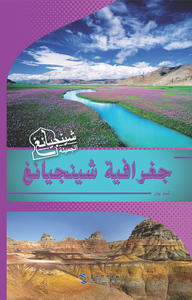
جغرافية شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة) (باللغة العربية)
يتناول كتاب "شينجيانغ الرائعة" بشكل رئيسي المناظر الطبيعية المتنوعة في شينجيانغ. حيث يستعرض في البداية الخصائص الجغرافية والمناخية لشينجيانغ، ثم يعرض للقارئ روعة ومهابة الأودية الجبلية داخل شينجيانغ وروعة بحيراتها وجمال أنهارها التي تجري في كل أراضيها وروعة مراعيها الشاسعة وجمال صحراءها المقفرة وقوة أشجار الحور الموجودة بها وجمال خيال مدينة الشبح الواقعة بشينجيانغ. ومن خلال الوصف التفصيلي لتلك المناظر الطبيعية، يستطيع القارئ أن يري المناظر السحرية المتنوعة والمتعددة بشينجيانغ، كما يمكنه أن يتعرف على المشهد الرائع الأخر في ظل التنمية المتناغمة بين الإنسان والطبيعة في شينجيانغ

فنون شينجيانغ(سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة) (باللغة العربية)
نبذة عن كتاب: (شينجيانغ الأسطورة) يأخذ هذا الكتاب القارئ للتعرف على الملاحم القومية التقليدية والرقصات الشعبية والحرف اليدوية القومية بشينجيانغ من منظور الشخص المتكلم، معتمدا على أسلوب النثر الثقافي. حيث يتناول تلك الجوانب بشكل متكامل يجمع بين الرؤية والسماع، وكأنما يأخذ بأيدي القراء حقيقة ليلامسوا المناظر والمشاهد الشعبية بشينجيانغ
تاريخ شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
يتناول كتاب (ذكريات شينجيانغ) الحديث عن شينجيانغ بداية من العصور القديمة وحتى عهد أسرة هان، كما يتناول الحديث عن أسرة وي وجين وحتى عهد أسرة سوي وتانغ، بالإضافة إلى أسرة سونغ ويوان وحتى عهد أسرة مينغ وتشينغ، مرورا بالجمهورية الصينية وحتى تحرير الصين، كما يستعرض تطور العلاقة بين شينجيانغ والسهول الوسطي من خلال بعض الجوانب مثل الجانب الجغرافي والقوميات وغيرها. كما يعرض أمام القارئ سلسلة التنمية التاريخية لشينجيانغ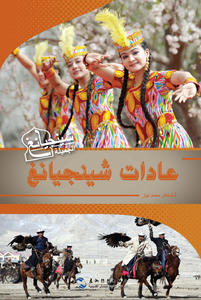
عادات شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
نبذة عن كتاب: (المشاعر في شينجيانغ) يستخدم هذا الكتاب لغة بسيطة سلسة من أجل وصف الثقافة الشعبية المتنوعة والمشاعر الشعبية الغنية في حياة كافة مواطني القوميات بشينجيانغ وصفا دقيقا حيا. ويجمع الكتاب بين النصوص والصور، كما يشتمل على العديد من الموضوعات مثل الطعام والملبس والمسكن والمواصلات المختلفة عند كافة قوميات شينجيانغ، فضلا عن موضوعات الحب والزواج والأسرة والآداب والطقوس الحياتية التقليدية والفريدة، والعادات الشعبية الصادقة والكريمة والأعياد التقليدية ذات المضمون الغزيز، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية الرائعة والمتعددة والمزارات ذات الطابع المميز وغيرها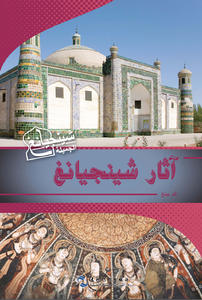
آثار شينجيانغ (سلسلة كتب شينجيانغ الساحرة)
يتناول كتاب (الآثار التاريخية في شينجيانغ) بشكل رئيسي التراث الثقافي غير المادي بشينجيانغ. واستعرض الكتاب المعالم والآثار الشهيرة في الأزمنة المختلفة التي مرت بها شينجيانغ والفنون المعمارية الفريدة التي تتميز بها شينجيانغ في ظل تأثيرات الأديان المتعددة والمختلفة والمواقع التاريخية المتعددة بشينجيانغ وذلك من خلال ستة جوانب تتمثل في آثار شينجيانغ القديمة والآثار المعمارية القديمة والكهوف البوذية الشهيرة والمباني الدينية المتنوعة والمزارات القومية الفريدة والمنشآت الحديثة التي تتمتع بتأثير كبير. كما استعرض الكتاب امتداد الآثار التاريخية العريقة على امتداد منطقة شينجيانغ، وبالتالي اظهار شينجيانغ المتنوعة أمام القارئ.
حقائق وأرقام عن شينجيانغ الصينية2013 (باللغة العربية)
يتناول كتاب "حقائق وأرقام عن شينجيانغ الصينية 2013" الإنجازات التي حققتها شينجيانغ في عام منصرم مستخدما لغة الأرقام، وها هي الحقائق تتحدث والأرقام تبرهن على ذلك، ونري اعتماد الكتاب على مجموعة كبيرة من البيانات الإحصائية لعرض الملامح الجديدة لتنمية وتطوير شينجيانغ الجديدة عرضا مباشرا وموضوعيا، وهكذا يتسنى للقارئ معرفة الإنجازات التي حققتها شينجيانغ في عام منصرم معرفة شاملة، حيث يمكن التعرف على الإنجازات التي حققتها في المجالات المتعددة كالاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة وسبل المعيشة وغيرها.
التكنولوجيا والتعليم الصيني (سلسلة الأوضاع الصينية الأساسية) (باللغة العربية)
يعتمد كتاب (التكنولوجيا والتعليم الصيني) على استراتيجية نهوض الدولة بالتكنولوجيا والتعليم كنقطة انطلاق، حيث استعرض الكتاب أحوال تنمية التكنولوجيا والتعليم في الصين، بما في ذلك نظام التعليم والبحث العلمي والموارد التكنولوجية واحتياطي الكفاءات وغيره.