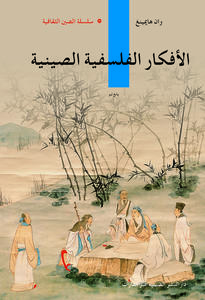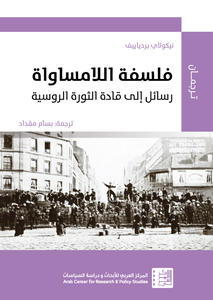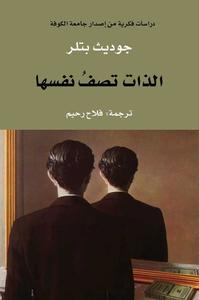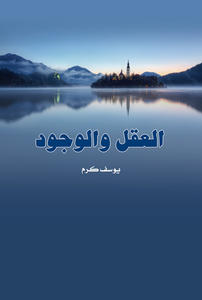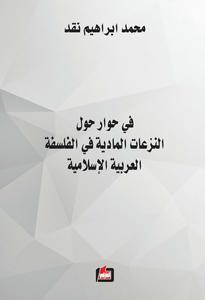-
الفلسفة ببساطة
في هذا الدليل الحيوي المعبر تعود الفلسفة إلى الحياة. وباستخدام فكرة السببية المركزية كمبدأ إرشادي، يبيّن برندان ولسون كيف يصبح تاريخ الفلسفة تسلسلاً واضحاً وطبيعياً للأحداث. وتكشف وجهة النظر، الناتجة عن ذلك، الروابط العميقة بين مشاكل العلم والعقل والحقيقة والحرية والمسؤولية والمعرفة واللغة والحقيقة والدين. +++ سيتمكن المقاربون الجدد للفلسفة من التعاطي مع الأسئلة والأفكار العظيمة في العرف الغربي. الكتابة واضحة وخالية من الإبهام، بينما تعطي بنية، الفصل-القصير، القارئ، الوقت للتوقف والتفكير في كل خطوة على مسار الطريق. تمهد رشاقة الأسلوب وجزالة التنسيق، أولاً، إلى سهولة الوصول: كما أن التوضيحات تشمل الرسوم والمخططات البيانية فضلاً عن صور الفلاسفة من أرسطو إلى فيتكينشتاين.
الفلسفة ببساطة
براندون ولسون
-
ايدلوجيا الفلسفة الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
ايدلوجيا الفلسفة الصينية: يتناول الكتاب الأفكار الفلسفية الصينية منذ أسرة تشين وحتي الآن، لتكون الخيط الذي يعرض تطور الأفكار الفلسفية الصينية، واستعرض الكتاب الأفكار الفلسفية الصينية التقليدية، ومن ثم عمد إلى التركيز على السمات الفلسفية لكافة المدارس الفلسفية في مختلف المراحل التاريخية، واقتباس أصنافا من الفلسفة الغربية، ومن ثم لخص الفلسفة السياسية لأسرة تشين وما وراء الطبيعة لأسرتي هان وتانغ والنظريات المعرفية لأسرتي سونغ ومينغ. وقد بذل الكاتب جهودا مضنية من أجل شرح الأفكار الفلسفية العميقة لكافة الفلاسفة وكافة العصور المختلفة شرحا بسيطا وسلسا، وقد وصف الكاتب العديد من الأسئلة الفلسفية الصعبة بطريقة أكثر تصويرية.
ايدلوجيا الفلسفة الصينية (سلسلة الثقافة الصينية) (باللغة العربية)
وين هاي مينغ
-
فلسفة اللامساواة: رسائل الى قادة الثورة الروسية
في مطلع عام 2014 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعميمًا لسائر العاملين في إدارات الدولة الروسية يطلب منهم قراءة هذا الكتاب. لكن هذا التعميم كان بمنزلة عملية سطو على فكر هذا الفيلسوف الذي طرده البلاشفة من روسيا. كتب بردياييف كتابه هذا منذ مئة عام تقريبًا، في غمار الحوادث العاصفة للثورة الروسية. لم يتصدَّ الكاتب لتأريخ تلك الحوادث التي هزّت العالم، بل لمناقشة المقولات كلها التي استند إليها قادة تلك الثورة، وزجّوا روسيا باسمها في آتون حرب أهلية طاحنة. وكرّس بردياييف جهده الفكري طوال حياته في منفاه الفرنسي للنفاذ إلى أعماق النفس الروسية، بغية الكشف عن الميزات التي تفرّدت بها وجعلتها مهيّأة في عام 1917 لخوض تجربة "إعادة خلق آدم التوراتي من جديد"، وتكوين بديل منه في مختبرات الشيوعية البلشفية. يقول بردياييف إن لكل أمة تناقضاتها، لكن في روسيا وحدها تنقلب المقولة إلى مقولة مضادة.
فلسفة اللامساواة: رسائل الى قادة الثورة الروسية
نيكولاي بردياييف
-
تحولات الفينومنولوجيا المعاصرة: مرلو-بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر
تبنت الفينومنولوجيا، بوصفها أكبر تيار فلسفي معاصر، محاولة تجاوز الصراع التقليدي بين المذهبين المثالي والواقعي، ثم وضع أسس سليمة لفلسفة علمية صارمة. هذا هو الهدف الرئيس الذي سعى إلى تحقيقه مؤسس المذهب الفينومنولوجي إدموند هوسرل، فكان أهم مبدأ قامت عليه فلسفته هو «العودة إلى الأشياء ذاتها»، وهو المبدأ أو بالأحرى الشعار الذي أثر كثيرًا في جميع أنواع الفينومنولوجيا التي ظهرت في ما بعد، أكان في ألمانيا أم في فرنسا، على الرغم من اختلافها الظاهر في مفهوم الأشياء كما في كيفية العودة إليها.
تحولات الفينومنولوجيا المعاصرة: مرلو-بونتي في مناظرة هوسرل وهايدغر
محمد بن سباع
-
خطرات نفس
«خطرات نفس» هي مجموعة من المقالات التي أودعها الكاتب زهرة العمر، وباكورة أيام الصبا؛ فهو يستعير من الذكريات فلسفة مشاهدة الحياة؛ فلا يقتصرُ في سردها على مشاهد مجرَّدة أوجدتها الذكريات؛ ولكنه يتخذ من كل خاطرةٍ له قصة يبثُ فيها قيمة من قيم الوجود الإنساني: كالإيثار، والتسامح، والرضا، والتواضع. ومَنْ يقرأ هذا الكتاب يجد أنه أمام دستورٍ صغير من دساتير تهذيب النفس الإنسانية؛ لأن كاتبها قد صبغها بصِبغَةٍ من مقدرات الحياة النفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية؛ فقد وفِق الكاتب في كتابة ذكريات جمعتها نفس واحدة، وعوالم متفرقة؛ فهو يخترق حاجب النفس الإنسانية لِيُطْلِقها عبْرَ مشاهداتٍ أرحب نحو آفاق الحياة، ولا عجب في ذلك؛ لأن أكرم قسمٍ في ذكريات التاريخ الإنساني، هي الذكريات التي تُخَطُّ بأنامل النَّفس.
خطرات نفس
الدكتور منصور فهمي
-
تاريخ الفلسفة الحديثة
يُعتبر كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة — إلى جانب كونه يؤرخ للفلسفة الحديثة التي ظهرت بعد فلسفات العصر الوسيط — معجمًا فلسفيًا يدلنا في وضوح ويسر على رجال الفلسفة، منذ القرن الخامس عشر حتى أوائل القرن العشرين. يدور الباب الأول في الكتاب عن بقايا الفلسفات القديمة، فيتحدثُ عن الأفلاطونيين الذين يستمدون منه أسباب دينٍ طبيعي، والرشديون الذين يُذيعون الإلحاد تحت ستار دراسة أرسطو وابن رشد. ويتحدث الباب الثاني عن أمهات المذاهب الحديثة مثل مذاهب ديكارت، وبسكال وسبينوزا. ثم يتحدث عن فسلفات الواقعية ورجالها مثل هيوم وبيكون في الباب الثالث. وفي الباب الرابع يعرضُ لفلسفات مين دي بيران، وأوجست كونت التي تحاول استيعاب جميع النواحي في مذهبٍ واحد. ثم يرصد في الباب الخامس الصراعَ بين داروين وسبنسر وأنصار المادية الذين وجدوا في نظرية التطور أسلحة جديدة، وبين الروحية التي يؤيدها الفرنسيون. ثم يتضح في الفصل الأخير الانقسام الكامل بين الفلسفات الحديثة إلى مذهبين: مادي وروحي، يتصارعان بشكل دائم بحثًا عن حلول للمشكلات الكبرى.
تاريخ الفلسفة الحديثة
يوسف كرم
-
الذاتُ تصفُ نفسَها
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول مطوّلة تمثل ثلاث خطوات محسوبة بعناية نحو استنتاجاته المبتكرة. تستقصي بتلر في الفصل الأول "وصف الذات" الطرق المتاحة أمام الذات لتقديم وصف لنفسها، لكنها تدرك منذ البداية أن هذا الوصف مشتبك بعرى وثيقة مع سؤال الفلسفة الخُلقية وإطاره الاجتماعي المعاصر. تنطلق ابتداء من تحليل أدورنو للعنف الأخلاقي الذي ينجم عن خلل يصيب العلاقة بين الذات وحاضنتها القيمية الاجتماعية يدفع الأخيرة إلى الضغط والإكراه لفرض تعاليمها.
الذاتُ تصفُ نفسَها
جوديث بتلر
-
العقل والوجود
يُبرِز لنا الكاتبُ في هذا الكتاب أهميةَ الدور المحوري الذي يلعبه العقل في إدراكِ الموجوداتِ التي يُعنَى بها مبحث الأنطولوجيا «مبحث الوجود» باعتباره أحد المباحث الفلسفية الأساسية، ويتفق الكاتب مع وجهة النظر الفلسفية القائلة: إن المعرفة العقلية أرقى من المعرفة الحسيةِ، وذلك باعتبار أن العقل جارحةٌ إنسانية تمتلكُ قوةً تُمكِّنها من إدراكِ أنماط شتى من المعارف اللامادية، ويربط الكاتب بين الموجودات والدور الذي يلعبه العقل في إدراكِ هذه الموجودات؛ وذلك باعتبار أنَّ العقل هو الرئيس المدبر لشئون الحكم في الموجودات من نباتاتٍ وحيوانات وغيرها؛ أي: إنه هو القاضي الذي يمتلكُ القول الفصل في الحكم على الموجودات وما تتفرع إليه من مبادئ وأقسام.
العقل والوجود
يوسف كرم
-
في حوار حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية
كتاب “محمد ابراهيم نقد” يصدر في جوهره عن تقدير عميق للجهد الإبداعي الكبير لكتاب حسين مروة، ولما حققه من إضاءة موضوعية لتاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، منذ نشأتها الأولى وعبر تجلياتها المختلفة، مستنداً في هذا إلى المنهج الجدلي، ولما أتاحته هذه الإضاءة التاريخية من إضاءة فلسفية إلى هذا التاريخ نفسه. على أن المفكر “محمد ابراهيم نقد” ينعش معرفتنا بهذا الصنيع الفكري الكبير الذي خلّفه لنا حسين مروة، بتناوله النقدي لبعض جوانبه، بما لا يقلل من تقديره لهذا الصنيع.
في حوار حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية
محمد ابراهيم نقد
-
نقد نقد العقل العربي (4)
هل يصلح حصان طروادة لتفسير ظاهرة استقالة العقل في الإسلام؟ بعبارة أخرى، هل يمكن رد أفول العقلانية العربية الإسلامية إلى غزو خارجي من قبل جحافل اللامعقول من هرمسية وغنوصية وعرفان مشرقي وتصوف وتأويل باطني وفلسفة إشراقية وسائر تيارات الموروث القديم التي كانت تشكّل بمجموعها الآخر بالنسبة إلى الإسلام، والتي اكتسحت تدريجياً، وبصورة مستترة، ساحة العقل العربي الإسلامي حتى أخرجته عن مداره وأدخلته في ليل عصر الانحطاط الطويل؟ إن الجابري، إذ يتبنّى هنا أطروحات مدرسة بعينها من المستشرقين، ويسِقط بالتالي على الإسلام تاريخَ صراع الكنيسة مع الهرمسية الوثنية والغنوصية الهرطوقية والديانات العرفانية، وأخيراً مع الأفلاطونية المحدثة التي مثّلت خط الدفاع الأخير عن العقلانية اليونانية، إنما يمارس في ساحة الثقافة العربية الإسلامية ضرباً من استشراق داخلي أسير لمركزية مزدوجة، غربية ومسيحية في آن معاً. هذا الجزء الرابع من نقد نقد العقل العربي لا يحاول فقط أن يرد الاعتبار إلى عقلانية الموروث القديم، وأن يتصدّى لتفكيك أساطير اللامعقول التي نسجها الجابري- بالاستناد إلى ركام من الأخطاء والمغالطات المعرفية- حول الإسكندرية موطن الهرمسية وأفامية معقل الغنوصية وحران منبع العرفان المشرقي، بل يحاول أيضاً أن يجيب عن السؤال التالي: هل استقالة العقل في الإسلام جاءت بعامل خارجي، وقابلة بالتالي للتعليق على مشجب الغير، أم هي مأساة داخلية ومحكومة بآليات ذاتية، يتحمّل فيها العقل العربي الإسلامي مسؤولية إقالة نفسه بنفسه؟
نقد نقد العقل العربي (4)
جورج طرابيشي